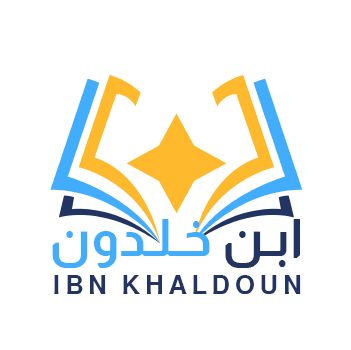Islamic discourse and its consequences for human
Cognitive - behavioral - emotional
عبد القادر بن إدريس فرطوطي بن بنعيسى بن حمان: ماجيستر في الفكر الإسلامي المعاصر، ومدرس اللغة العربية، المغرب
Abstract:
The study aimed to refute the harassing ideas that are based on the diverse Islamic discourse by proving that there is no single nation that has taken off comprehensively without relying on an authentic discourse that is inseparable from the mother tongue and its origins. Also identifying the obstacles faced to question history, reality and the self about the deficiencies and weakness, to contribute, to finding solutions to redress the self and share the virtue, then, to get rid of those inherited structures and negative ideas and work on moralizing them. To attain the objectives of the study, the researcher combined between the descriptive approach and the analytical one using related resources and references for the sake of documentation and quoting by expressing the point of view in areas that require that. The study has reached a set of results, the most important of which are: the usefulness of betting on the strengths of the Arabic language and its balanced discourse in order to assimilate the sciences and unite the nation on justice and equity, and then on the strengths of religiosity and moralizing life.
Keywords: discourse , human being , fate , trilogy (knowledge, behaviors, conscience)
المقدمة:
بموازات التغيير الأنفسي الذي يقود الى التغيير الآفاقي ويؤثر فيه، فإن الخطاب الإسلامي يتجدد بتجدد نوع وكم المخاطبين زمانا ومكانا، باعتباره "رسالة ذات مضمون ودلالة وغاية، وهو تعبير عن تصورات ووجهة نظر في قضايا يعيشها"0 الإنسان، ومظهـر معرفته وتفكيره، وصورة وحدته وقوته، وسلوك سياسته وعباداته...والمؤثر في وجدانه واختياراته، عندما يمتزج بعقيدة ربانية المنبع، ممتدة الجذور، واقعية وشمولية وقصدية يؤمن بها الجميع.
لكنها، خصائص سرعان ما تندثر وتتهاوى أمام الضربات الداخلية والخارجية، خاصة الانفصال النكد، الذي حدث مبكرا في تاريخ المسلمين، بين القرآن والسلطان،0 واستمرت آثاره المعرفية والوجدانية والسلوكية إلى يومنا هذا.
مشكلة الدراسة:
تدور مشكلة الدراسة حول بيان مآلات الخطاب الإسلامي على الإنسان: معرفيا وسلوكيا ووجدانيا، في ظل تعدد روافده، ووارداته على الأسماع والقلوب، وتنوع أهدافه، ووثيرة المستجدات المحيطة به، وتبعثر أولوياته، واختلال قضاياه الجوهرية وثوابته وخصائصه، وإمكانية تجديد بواعثه.
منهج الدراسة:
اعتمدت الدراسة على العديد من المناهج بحسب المطلوب، وفيما يلي بيان أهمها:
-
المنهج النصي ذلك أن الانطلاق من بعض الاستشهادات للبرهنة على النتائج والمقترحات، يستدعي التوسل بالنصوص بعد توثيقها، ثم اعتمادها لتقوية رأي أو اختيار معين.
-
المنهج التحليلي وبما أن هذه النصوص تحتاج إلى شرح وتحليل وفهم ومناقشة وتفسير وتحديد العلاقات الموجودة بين المتغيرات الحاضرة، فإن المنهج التحليلي هو الأنسب.
-
المنهج الاستقرائي خاصة في المسائل المتعلقة بفقه الواقع وعلاقته بالخطاب المتجدد.
-
المنهج النقدي وسيكون هذا المنهج مصاحبا لجل أطوار الدراسة تقويما وتصحيحا وترشيدا، وما يتطلبه الواقع من حكمة وتدرج.
-
المنهج التاريخي التوثيقي، أملته الحاجة إلى ربط الماضي بالحاضر وتوثيق الأحداث والنصوص، وما طرأ على هذا الخطاب من نكبات أو مراحل تجديد وازدهار.
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى حل لغز الإشكاليات أعلاه، وذلك من خلال تحقيق الأهداف التالية:
-
معرفة التلازم بين اللغة والخطاب وآثار ذلك على الولاء لله ورسوله ودينه.
-
استشعار أهمية الخطاب في قوة التدين وقدرتها على لملمة الشتات والتقريب بين الناس وتوحيدهم.
-
بيان العلاقة الوطيدة للخطاب بكل أنواعه بقضايا الأمة، ثم القضايا الجوهرية والمصيرية للإنسان.
-
تفسير آثار آفة التجزيء على الخطاب وتبعثر أولوياته ومقاصده، معرفة مظاهر قصوره ومتطلبات التجديد لتجاوز الخلل.
-
إدراك آثار الأزمة الأخلاقية الكونية على اللغة العربية والخطاب.
-
الإحاطة بأهمية الخطاب الإسلامي في التأسيس للعيش المشترك على الأرض.
أهمية الدراسة:
يتنوع الخطاب الإسلامي ويتعدد بتنوع وتعدد واختلاف التنظيمات الإسلامية، وغير الإسلامية، فتتباين تبعا لذلك أفهامهم وتأويلاتهم، أضف إلى ذلك التأثير الكبير للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، خاصة على مستوى الحريات وحقوق الإنسان.
من هذه المنطلقات تكتسب الدراسة أهميتها، إذ تركز على الإنسان باعتباره محورا وبؤرةَ تركيزها من زواياها المتعددة: فكرا وشعورا، وماديا وروحيا، وسلوكا وأخلاقا، بل حتى على المستوى العلمي والعدلي والتنموي، وكذلك نظام الحكم0.
الدراسات السابقة:
اعتمد هذا البحث على عدة دراسات سابقة، ولعل أهمها:
أشرف السيد سالم، قضايا ومناهج وآفاق28 /29 يوليو/تموز، 2021، تجديد الخطاب الديني، محاولة لتحرير المصطلح والدلالة.
تحدثت الدراسة عن أهمية تجديد الخطاب الديني وما تثيره من جدل بين المهتمين، وقد خلصت إلى ضرورته في عصرنا، المتميز بكثرة المستجدات الحياتية والعلمية والتكنولوجية، بشرط الالتزام بالضوابط الشرعية، وأكدت كذلك أن التجديد صحب الخطاب الديني منذ نشأته، وبما أنه وسيلة فيمكن أن يتجدد بتجدد الزمان وتغير المكان وأحوال المخاطبين.
منار الهدى، مجلة فكرية شهرية جامعة، الخطاب الإسلامي وإشكالات التواصل، العدد: 12، خريف 2008.
تناول العدد 12 من مجلة منار الهدى الخطاب الإسلامي من عدة زوايا، ولعل أهمها: الخطاب الإسلامي بين مأزق التاريخ، نحلة الغالب، ومنطق الساحة، ثم مظاهر القصور التي صاحبت الخطاب الإسلامي وكيفية تخطيها، وأوضح الأساتذة المشاركون في ملف العدد أن الخطاب الإسلامي عبر سيرورته التاريخية كان يتأثر ويغير جلده كلما تغير شكل الحكم، مما ساهم في التوظيف السياسوي للدين.
أما ما يمكن التعقيب به على ما تقدم، فأختصره في الآتي:
إن حصر الخطاب في تسمية الخطاب "الديني" عوض "الإسلامي"، يعطي انطباعا مجانبا لشموليته واستغراقه لكل مجالات الحياة: السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعلاقة كل ذلك بمصير الإنسان، بل يقزم الخطاب الإسلامي بخصائصه المتعددة، إلى خطاب لا يتعدى مجال العبادات والعقيدة، وما يليهما من طقوس، حدوده أسوار المسجد ومناسبات إضفاء الشرعية الدينية والقدسية للحكام.
وهذا الحصر أو التجزيء ليس وليد اليوم، بل هو نتاج التفتت السياسي الذي عاشته الأمة، فانعكس على المستوى الفكري والعلمي، لذلك استعملت الدراسة مصطلح الخطاب الإسلامي الشمولي، عوض الديني التجزيئي أو التبعيضي.
أما الدراسة الثانية فهي بمثابة نصوص انطلاق، وأسسا لخطاب إسلامي يروم الانبعاث واسترجاع ثوابته وخصائصه، ولعل أبرز ما جاء فيها، تأكيدها على السمات المطلوبة في الخطاب الإسلامي، كالتأصيل والتذكير والتنوير، ثم الإبداع والتطوير وغيرها.
المطلب الأول: الخطاب الإسلامي بين أزماته التاريخية ومتطلبات الربيع العربي:الخطاب الإسلامي وأزماته التاريخية:
إن الاختلالات التي يعرفها الخطاب الإسلامي الحالي، ليست وليدة اليوم، وإنما هي نتاج القرون السابقة التي تلت الفتنة وذهاب الشورى، وما لحق ذلك من تشتت أمر الأمة بعد النبوة وولاية الخلفاء الراشدين، وقد أدى ذلك إلى انحسار الخطاب بعدة قيود، أجمل أسبابها في التالي:
-
الفتنة وانحراف الحكم، وكان ذلك إيذانا بغياب الشورى، وسيادة الاستبداد والتسلط بالسيف.
-
بروز ثنائية الدعوة والدولة، وسيطرة هذه الأخيرة وتحكمها في الدعوة.
-
انتشار الأفكار المنحبسة والتقليد والتي بسببهما جُمد الاجتهاد.
-
بلوى الصراعات العقدية والمذهبية والكلامية بين العقل والنقل.
-
تشتت الأمة إلى سنة: يزعم بعضها بأنهم الفرقة الناجية، وشيعة: انبرى علماؤها لإرضاء العامة فكانت الطامة الكبرى.
-
انتشار الأفكار والنظريات التربوية الأرضية الحداثية المنقطعة بنظرها عن الآخرة كليا.
-
الميل إلى الدعة والخمول والسمر والشعر والغناء والطرب لدى العامة والخاصة.
-
ظهور بوادر الخطاب الانعزالي والانزوائي الذي أبعد نفسه عن هموم الدنيا والناس.
وهكذا أنتجت الدعوة والدولة خطابا فقد بعض ثوابته وخصائصه، ووصل أحيانا إلى حد التناقض والتنافر، يتحاشى التذكير بالموت والمصير، فأصبح إما بلاغيا صرفا، أو سياسيا محضا، أو فلسفيا تحررا، أو أخلاقيا تميزا، أو خطابا قانونيا أمرا، أو أدبيا جمالا، أو خطابا دينيا عسفا...
عسفا لأنه مع مرور الوقت، ستعم بلوى خطاب التكفير، وخطاب التبديع والتخويف، هذا إن لم يمارس "أدوارا تخديرية في إقعاد الوعي عن ممارسة التحليل والنقد"0، أو يصبح مخيفا، وسيفا مسلطا، وسلطة لا يُتحكم في مخرجاتها.
وقد "أفلحت" الدول المستبدة في إنتاج أو احتضان خطاب يخدم مصالحها، مفصل بدقة على مقاسها، ضمنته نوعا من التدين الذي لا يتعدى بوابة المسجد، وشددت الرقابة على المساجد، وعزلت الكثير من الأئمة، وسجنت الذين لا يتدينون بدينها، حتى لا تكون لهم كتلة ناقدة قادرة على الاحتجاج خطابا وممارسة.
وبذلك، ليس عبثا أن يتعرض منتجو الخطاب المعارض للأنظمة الاستبدادية، من العلماء والمصلحين والسياسيين والأدباء والمثقفين...أن يتعرضوا لكل أنواع القتل والسحل والنفي والسجن والشيطنة والحصار والإقامة المحروسة...وهلم جرا من المضايقات.
لقد تردى الخطاب الإسلامي في جزء كبير منه، بعد أن فرض الاستبداد اصطباغ الخطب والإعلام بصبغته مهما كان توجهها: قومي، ليبرالي، ماركسي، بعثي، إسلامي...
الخطاب الإسلامي ومتطلبات الربيع العربي:
ابتلي الخطاب الإسلامي؛ في هذا الزمن؛ بحكام فرعونيين وقرونيين وملوكيين، وسار في نقعهم المنتفعون الساكتون والمسكَتون ذوو المصالح والامتيازات، من سياسيين وإعلاميين ومنتفعين "ريعيين"، أمام تسلط الأسياد على كل المنابر، ووسائل مخاطبة الشعوب، في ظل مؤامرة الصمت التي يمارسها العالم الغربي المنافق.
لكن مع الربيع العربي، وتوق الشعوب إلى الحرية، تحتم على النخب والفاعلين الميدانيين، ورواد الساحات النضالية، والمنظرين في الفكر الإسلامي، مراجعة الخطاب وتنقيته من كل الشوائب التي التصقت به طيلة سنوات التقهقر والتقليد، وفي زمن الاستبداد.
كان من أهم هذه المراجعات، تبادل الرسائل الواضحة، غير المشفرة بين المثقفين والسياسيين، تطمئن بالمجال المعرفي الرحب والواسع في الخطاب الإسلامي عموما، والسياسي خصوصا، فانعكس ذلك سلوكا إيجابيا، تجلت بعض نتائجه في مقارعة الخطاب الرسمي ونظيره المنحبس والمتماهي معه تمجيدا ومدحا وتزيينا.
ومنها كذلك إخراج الخطاب الجاد من الغرف المظلمة إلى ساحات الاحتجاج والمطالبة بالحقوق، وإصباغه بصبغة الكينونة مع المستضعفين والمحرومين والمقهورين.
أضف إلى ذلك اتسامه بمزيد من التدقيق المعرفي، ثم التدقيق في التحليل والثبات على المواقف، والجرأة في تحميل المسؤوليات، واقتراح الحلول وبدائل التغيير، والشمولية والتأصيل وعدم الرضى بأنصاف الحلول.
بالإضافة إلى المعرفة الدقيقة بالواقع ومكوناته السياسية والاجتماعية والثقافية، ووعيه بمحاولات الإفشال والاحتواء، وقد فرض ذلك العمل الميداني المشترك دون اقصاء، أو تنقيص، أو استعداء.
لكن، فإن منطق الواقعية0، وتعدد الطروحات السياسية والمرجعيات والمصالح المرتبطة بالداخل والخارج، بل وتعدد اجتهادات الفصائل الإسلامية نفسها في أولويات المرحلة، وأفق التغيير وكيفية التغيير، طرح عدة تساؤلات عن مآلات الخطاب ونتائجه على الذات، خاصة وتجربة الإسلاميين في بداياتها، إذ لم تشتبك بعد بقوة مع هذا المنطق بكل الحيثيات والتفاصيل، ليُعلم مدى قدرتها على إنتاج خطاب قادر معرفيا على مواجهة التحديات0سلوكيا، وعدم الذوبان، وجدانيا، حين التحالف مع المرجعيات الأخرى…
وخلاصة القول، إن الخطاب الإسلامي، زمن الربيع العربي، أمامه تحديات عدة، ينبغي وضعها ضمن الأولويات والتحديات، من بينها القضايا المطروحة في الساحة، كإشكاليات الهوية والدين والثقافة واللغة، ومفهوم الدولة التي ما زالت تتفاعل في بعض الأوساط الثقافية والسياسية والإعلامية العربية والإسلامية0.
المطلب الثاني: الخطاب الإسلامي والأزمة الأخلاقية الكونية.الخطاب لغة واصطلاحاً
يُطلَق (الخطابُ) في اللغة العربية على: "مراجعة الكلام، وقد خاطبه بالكلام مخاطبة، وخطاباً، وهما يتخاطبان"0، والخِطاب كذلك: الكلام، وفَصْل الخِطَاب هو خطاب لا يكون فيه اختصار مُخِلّ ولا إسهاب مُمِلّ، والخُطْبة: الكلام المنثور يخاطِب به مُتكلِّمٌ فصيحٌ جَمْعًا من الناس لإقناعهم، ومن الكتاب: صدْرُه جمع خُطَب، والخَطَّاب: وصف للمبالغة للكثير الخطبة [بضم الخاء وكسرها]. والخطيب الحسن الخُطبة، أو من يقوم بالخَطابة في المسجد وغيره، والمتحدث عن القوم. جمع خُطباء، والخَطْب والمخاطبة والتخاطب: المراجعة في الكلام، ومنه الخُطْبة، ويقال من الخُطْبة: خاطِب وخطيب، ومن الخِطبة: خاطب لا غير. والخَطْب: أيضًا الأمر العظيم الذي يكثر فيه التخاطب.0
أما اصطلاحا، فكلما وقفنا على لفظ الخطاب، إلا وسبقت إلى أفهامنا دلالته على معنى التعامل0 والتواصل وإشراك الآخر وإفهامه أمرا مخصوصا ومشتركا، بغرض الإقناع في دوام هذه العلاقة، أو دفع انتقاد ورد شبهات، أو زيادة في يقين باعتقادات معينة، ويعتمد في ذلك على الحجة والحجة المضادة المؤثرة، ليس بغرض التسلط والإجبار، ولكن بهدف الإشراك في القناعات، وفي الفضل وتجنب الشرور المادية والمعنوية، وقد تعددت في الاصطلاح استعمالات هذا الخطاب: لسانيا ولغويا وفكريا وفلسفيا وأصوليا.
وفي القرآن الكريم وردت مفردة "خطاب" بمعاني الكلام والبيان والمراجعة وقوة البلاغ، أو البيان الفاصل بين الحق والباطل، بجعل المعنى الكثير في اللفظ القليل، من ذلك قوله سبحانه: {وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَاب} [ص: 20]، وقوله جل شأنه: { وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَمًا} [الفرقان: 63]، وقوله كذلك: {وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلاَ تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُواْ إِنَّهُم مُّغْرَقُون} [هود: 37]، ولقد أوتي الرسول صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم وفصل الخطاب، وصحبه من بعده.
مفهوم الإسلامي:
"أي نسبته للإسلام، ونعته بهذه الصفة لا يعني عصمته وقداسته، بل يجري عليه النقص والضعف وسائر العلل"0، ويعني ذلك تأثر الخطاب بمكنونات الإنسان وتطلعاته، باعتباره إنتاجا بشريا، يصيبه ما يصيب الإنسان من قوة وضعف ووهن، ويعني ذلك أنه قد يطبع القلب والأحاسيس والوجدان والفكر بمواقف وجودية، تترجم إلى إنتاجات إبداعية متنوعة، أو تترجم إلى أفعال وأقوال سلبية وعنيفة أحيانا، أو مشحونة بإقصاء الآخر أو كراهيته.
أما نسبة الخطاب إلى الإسلام، شرعا: فهو لا يتغير ولا يتبدل، باعتباره وعاء لتعاليم الدين الثابتة التي أكملها الله ورسوله، حين قال سبحانه: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيم} [المائدة: 3]، وهي كل ما شرعه الله ورسوله من أحكام العقيدة والأخلاق والمعاملات والعبادات والعقوبات والجزاءات في الدنيا والآخرة.
في حين تُركت مساحة واسعة للعقل كي يعمل عبر الاجتهاد والابتكار والتجديد في آليات الخطاب، لتبليغ هذا المضمون الشرعي الذي لا يتغير، مستحضرا أحوال المخاطبين، وظروفهم ومستجداتهم الحياتية المتنوعة.
بمعنى آخر أن الخطاب الإسلامي هو ما نتوجه به إلى الغير قصد إفهامه مقصودا مخصوصا، بشرط امتلاك القدرات اللغوية والتواصلية وأساليبهما المتنوعة.
الأزمة الأخلاقية الكونية:
إذا كانت الإنسانية في فترات انقطاع الوحي وتأخر بعثة الأنبياء، لحكمة يعلمها الله وحده، قد عانت على المستوى القيمي، أزمة وصفها القرآن بظن الجاهلية وحكم الجاهلية وتبرج الجاهلية، فإن الإنسانية اليوم على المستوى العالمي تجاوزت بجهلها كل الخطوط.
جهل ضد العلم، وجهل ضد الحلم، وكانت هاتان الصفتان عنوانا بارزا للجاهلية الأولى، بظنها وحكمها وتبرجها، والثانية بعنفها وجهلها معنى وحقيقة هذا الإنسان.
لذلك ومع مرور الوقت ازداد هذا الجهل، فانزوى كل إلى زاويته يستمتع مسرورا بتخصصه، لا يأبه بباقي الزوايا، حيث انتشرت الشرور والحروب والصدامات منها، لأنها قاصرة النظر، فكان الجهل الجديد، لكن يحمله الخبراء وليس البسطاء، الذين لا يتراءى لهم من غيرهم إلا الشر المدمر، فينقلون ذلك إلى لعالم عبر خطاب مبيت مدمر، مستغلين وسائل الإعلام وقنوات الثقافة وجهل المخاطبين، فيكون التحريض على:
-
السيطرة الاقتصادية والتي تحصر الاستفادة في نطاق المنفعة المادية ولا تتعداها إلى المصلحة المعنوية.
-
السيطرة التقنية التي لا تتجاوز الفعل الإجرائي، ولا تخرج بهذا الفعل إلى العمل المقاصدي.
-
السيطرة الاتصالية التي تنحصر في نطاق المعلومات البعيدة والافتراضية، والسؤال إذن: كيف الخروج من هذه الأزمة المثلثة0 التي تعيق كل تغيير أخلاقي جاد في العالم؟
ففي ظل هذه الفوضى أصبح الخطاب عموما، والإسلامي خصوصا، في حاجة إلى تجديد بواعث التخليق ما دامت الأزمة أخلاقية، ولعل آثارها واضحة المعالم على الإنسان، مما يضاعف المسؤولية الملقاة على عاتق العقلاء من ذوي المروءات في العالم ومن العقل المسلم بالخصوص لرفع التحدي والاجتهاد في وضع أسس خطاب يجدد البواعث ويراعي الخصوصيات والهوية والمتغيرات.
المطلب الثالث: بلاغ الخطاب الإسلاميمفهوم البلاغ:
يقول الراغب في مفردات القرآن: البلوغ والبلاغ الانتهاء إلى أقصى المقصد والمنتهى مكانًا كان أو زمانًا أو أمرًا من الأمور المقدرة،0 وربما يعبر به عن المشارفة عليه، وإن لم ينته إليه، فمن الانتهاء قوله تعالى: {حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً} [الأحقاف: 15]، وقوله عز وجل: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ} [البقرة: 232].
والبلاغ التبليغ نحو قوله عز وجل {هَـذَا بَلاَغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ وَلِيَعْلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَـهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُوْلُواْ الأَلْبَاب} [إبراهيم: 52]، والبلاغ الكفاية نحو قوله عز وجل: {إِنَّ فِي هَذَا لَبَلاَغًا لِّقَوْمٍ عَابِدِين} [الأنبياء: 106]، ويقال بلغته الخبر وأبلغته مثله وبلغته أكثر، قال تعالى: {أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُون} [الأعراف: 62]، وقال تعالى: {ياأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِين}" [المائدة: 67].
وبهذا المعنى الأخير يكون الخطاب بلاغا، إذا ذكر الإنسان بمصيره الذي ينتظره دنيا وآخره؛ قد يغفل عنه، وإذا رام تزكيته وتربيته وتهيئة إرادته، كي يعمل بجد وتفان وإخلاص، عملا إراديا مقصودا، ينبع من نفسه، ثم يبدع أثناء الإنجاز، ويقتحم العقبات الأنفسية والآفاقية؛ وما أكثرها في زمننا، وإن لم يكن كذلك فهو خطاب يحيد عن صفة "البلاغ"0.
وردت لفظة البلاغ في القرآن الكريم في عدد من الآيات، منها قوله تعالى: "{إِلاَّ بَلاَغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالاَتِهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا} [الجن: 23]، أي لا أجد منجى إلا أن أبلغ عن الله ما أرسلت به. والإبلاغ: الإيصال، وكذلك التبليغ، والاسم منه البلاغ، وبلغت الرسالة أي أوصلتها، والبلاغ: ما يتوصل به إلى الغاية، والبلاغ: بيان يذاع في رسالة ونحوها.
الخطاب بلاغ إلى الفطرة البشرية:
البلاغ تبليغ، ويتعداه إلى التأثير واكتساب المواقف وتبنيها، ولعل أهمها المتجلية في قوله تعالى: {ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِين} [النحل: 125]، فهو تأثير معرفي وسلوكي، ثم وجداني.
وكأن الخطاب الذي ليست هذه صفته، أي: خطاب حكيم ورحيم، يعظ بالحسنى، يبشر ولا ينفر، يجادل المعارض والمناوئ بالتي هي أحسن، يوشك أن يجانب صفة الخطاب "التبليغي"، أي هدفه البلاغ والإفهام الذي وردت معانيه في كتاب الله.
إن الخطاب الذي صفته البلاغ، يتوجه مباشرة إلى الفطرة البشرية بشمولية، مازجا "بين الإنذار والبشارة، بين الترغيب والترهيب، بين الاستنهاض والزجر، بين التحريض العاطفي والتنوير العقلي"0.
لذلك فهو "وحده القادر على تبليغ دعوة الإسلام والإيمان والجهاد إلى أعماق القلوب"0، وبذلك يكون هذا الخطاب ذا هيبة ونور وفاعلية "تحول الكلام عملا، والفكر إنجازا والشريعة الإلهية قانونا يحكم في الأرض، يعلو ولا يعلى عليه"0.
المطلب الرابع: الخطاب الإسلامي ومتطلبات التجديد:-
مفهوم التجديد:
لغة: قال الجَوهَريُّ: "جَدَّ الشيءُ يَجِدُّ بالكسر جِدَّةً، صَارَ جَدِيداً، وهو نَقِيضُ الخَلَقِ"0. ورد هذا المعنى في قوله صلى الله عليه وسلم: " إنَّ الإيمانَ ليَخلَقُ في جوفِ أحدِكم كما يَخْلَقُ الثوبُ، فاسأَلوا اللهَ أن يُجدِّدَ الإيمانَ في قلوبِكم"0.
وقال أيضاً: "وتَجدَّدَ الشيءُ صَارَ جَدِيداً، وأجَدَّهُ واسْتَجدَّهُ، وجَدَّدَهُ: أي صَيَّرَه جَدِيداً"(0).
وقال ابن فارس: " وَقَوْلُهُمْ ثَوْبٌ جَدِيدٌ، وَهُوَ مِنْ هَذَا، كَأَنَّ نَاسِجَهُ قَطَعَهُ الْآنَ. هَذَا هُوَ الْأَصْلُ، ثُمَّ سُمِّيَ كُلُّ شَيْءٍ لَمْ تَأْتِ عَلَيْهِ الْأَيَّامُ جَدِيدًا ; وَلِذَلِكَ يُسَمَّى اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ الْجَدِيدَيْنِ وَالْأَجَدَّيْنِ ; لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِذَا جَاءَ فَهُوَ جَدِيدٌ"0.
اصطلاحا: ورد معنى التجديد في أحاديث كثيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، منها قوله: «إن اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا"0. يقول "شيخ الاسلام ابن تيمية": " والتجديد إنَّما يكون بعد الدروس، وذاك هو غربة الإسلام"0. وقال "المودودي": المجدِّد هو" كل مَنْ أحيا معالم الدين بعد طموسها وجدَّد حبله بعد انتقاضه"0. ويقول "يوسف القرضاوي": "وتجديد الشيء ليس معناه أن تزيله، وتنشئ شيئاً جديداً مكانه، فهذا ليس من التجديد في شيء، تجديد شيء ما أن تبقي على جوهره ومعالمه وخصائصه ولكن ترمم منه ما بلي، وتقوي من جوانبه ما ضعف"0.
في حين يرى "ياسين عبد السلام" رحمه الله: أن "هذا الــ «من»، وهو اسم موصول، يدل على الفرد وعلى الجماعة. فعمل التجديد منوط باجتهاد الفرد المجدد والجماعة المجددة. الفرد كيفما كانت قدرته لا يستطيع أن يؤثر في المجتمع إلا إذا التف من حوله رجال ونساء يساعدونه على الحق"0
ولا يمكن الحديث عن المجدد وتجديد الدين، ما لم يتجدد القالب والوعاء الحامل لمضامين هذا التجديد، ألا وهو الخطاب، ولا فائدة ترجى من تجديد لا تُلمس آثاره معرفيا وسلوكيا ووجدانيا في حياة الناس.
لذلك، فإن من أهم قضايا التجديد التي ينبري لها الأفراد والجماعات؛ زمن الفتنة؛ هي تجديد الخطاب الإسلامي، لأجل «إحياء الربانية في الأمة"0، والدلالة على حب الله ورسوله وأصحابه وأمنائه من بعده، باعتبارهم القدوات المغيبة، ثم إعادة الاعتبار للقضايا الكبرى لهذه الأمة: "فقه الحكم والشورى والدولة والسياسة،"0 فيكون الخطاب حاملا لهموم الناس عامة، معبرا عن استضعافهم ومكنوناتهم المكلومة، وليس غريبا عنهم.
وتجدر الإشارة هنا إلى ضرورة الحذر "من الوقوع تحت ضغط الواقع القائم في المجتمعات اليوم، وهو واقع لم يصنعه الإسلام بعقيدته وأخلاقه وشـريعته، ولم يصنعه المسلمون بآرائهم، وعقولهم وأيديهم، وإنما هـو واقـع صـنع لهـم، وفرض عليهم في زمن غفلة وضعف، وتفرق، وورثه الأبناء عن الآباء، والأحفـاد عن الأجداد، وبقي كما كان"0.
إذن ليس معنى تجديد الخطاب السعي إلى "تبرير هذا الواقع الذي فرضه المستعمرون، وأعداء الإسلام والمسلمين عليهم، ونفتعل الفتـاوى لإضـفاء الشرعية على هذا الواقع، والاعتراف به مع أنه ...خارج عن عاداتنا وتقاليدنا وعن الأحكام الشرعية في مجتمعاتنا.0
ملامح التجديد:
إن الفهم الدقيق لحاضر الخطاب الإسلامي، وآثاره على ما تعيشه الإنسانية عموما، والمسلمون خصوصا، من انزلاقات تربوية مقيتة، ومن ظلم واستبداد... سيبقى مبهما ومشوشا ما لم تُدرك أبعاد الأحداث التاريخية، والتي سبق ذكر بعضها، وآثارها على مسار الثوابت وترتيب الأولويات.
إن المصائب العظيمة التي توالت على الإنسان المسلم ومزقت الأمة معنويا على مستوى الفكر والعواطف، وجوهر نظرته إلى الحياة والموت والمصير، والعلوم والأقطار، قد تجلت مظاهرها بجلاء على مستوى هذا الخطاب المكلوم، حيث تلون، عبر التاريخ، ولبس لبوس وحنوط الحكم والحكام، ولم يتجاوز في غالبه الحدود السلطانية التي ترسم له، أظف إلى ذلك تأثير النظريات الأرضية وتطورها.
يبدو، اليوم، جليا تململ العالم نحو التغيير، بعد أن أنهكته المادية المتوحشة بمنهجها المسموم، لكنه تململ مشوب بالخطر على المستوى القيمي والأخلاقي، ينذر بكوارث، لا قدر الله، داهمة على الإنسانية، خطر يشكله الحمقى الجدد اقتصاديا وتقنيا واتصاليا.
وفي ظل هذه المتغيرات والإرهاصات، يحاول الخطاب مسح الغبار عن نفسه، واستجماع قواه، والنهوض لأداء مهمته الخالدة، ليكون أملا وبشرى وخلاصا لكافة أهل الأرض، ومن الملامح التجديدية التي ينبغي دعمها وتثمينها:
-
-
ملمح الانتصار لقضايا الأمة: انحياز الخطاب إلى هذه القضايا، ليمسح الحزن عن أهل فلسطين وسوريا ولبنان والعراق واليمن المكلوم والممزق...ويمسح الفقر والفاقة والظلم وهتك الأعراض عن الإنسانية جمعاء، عن كل المعذبين والمكلومين والمهجرين ظلما وعدوانا...
-
ملمح التبشير وعدم التيئيس: تجمل الخطاب بالرحمة والرفق والأمل للذين أشقتهم الدوابية وسجنتهم في معارك لا تنتهي على الأشياء والخبز والمنصب والحدود، خطاب يعرف الإنسان بنفسه، أنه جوهرة ثمينة إذا انخرط في سلك الهداية والتذكير.0
-
ملمح بواعث الحق والرحمة القلبية والحكمة العقلية: وهي خصيصة الشمولية ونبذ التجزيء الذي سرى في أوصال الخطاب الإسلامي لقرون خلت.
-
ملمح التأسي بالقدوة: تخلي الخطاب عن خدمة المستبدين ومن يسير في ركبهم، من الماجنين والمنافقين والمخادعين، ليعيد الاعتبار للقدوة والمثال القائم بالقسط في جميع المحافل.
-
ملمح تذكير الإنسان بالنبأ العظيم: عدم الدعوة إلى التسيب فكرا وسلوكا ووجدانا، وذلك بانخراط الخطاب في التذكير باليوم الآخر والمصير محورا أساسيا في كل المناسبات.
-
تثبيت تصورات العمل الإسلامي المنتظم على منهاج، قصد ترتيب الوسائل لبلوغ الأهداف، لأن الانتظام ينتج خطابا مقصديا ومنتظما.
-
عدم الانشغال بالذهنية التسطيحية التجزيئية التبعيضية التي تهدد الأمة في وسطيتها ومكانتها بين الأمم، إن وجدت بيئة الجدال العقيم.
-
إعادة جمع الشتات تدريجيا إلى أصله فكريا وعقائديا وشعوريا، ثم الحرص على مأسسته.
-
إعادة الاعتبار للقرآن ولغة القرآن وروحه وأصوله،0 ودعوته الخالدة إلى الاعتصام به وبسنة من كان القرآن خلقه، مفتاحا للخير مغلاقا للشر.0
-
فك عقل المسلمين عامة والعلماء خاصة من قيد القرون الماضية، والسعي عبر الخطاب المتوازن، إلى تبرئة الإسلام من الإرهاب والانشطار والتشرذم والإقصاء، التهم التي ألصقت به، وكان لها آثار على الفقه الإسلامي عموما.
-
بعث الحياة وتجديد أنفاس الوحدة وإعادة ترتيب أولوياتها وربطها بأصولها السماوية الربانية الإحسانية وفق مبدأ التوحيد، إعمارا للأرض، ونشرا لقيم التراحم والتبادل والتضامن.... ومدا لجسور التعارف مع الآخر الذي له تاريخه الخاص وتصوراته عن الكون والإنسان والحياة.
-
التضييق على أطروحة الصراع وتعميم خطاب المحبة والعدل والإنصاف للإنسانية، لأن العالم يتسع للجميع.
-
الاستفادة من كنوز الخطاب الموروث الجامع، عند الحاجة، خاصة في حفاظه على خصائص الأصالة والواقعية والمرونة.
-
الائتمام "مباشرة بالتعليمات الشريفة المشرفة التي أوصتنا أن نتبع السنة الأولى ونقتدي بهديها، في تلك السنة لم تنخر نواخر الخلاف والفرقة، ولم يحرف الصراع على السلطة الرأي، وأخمدت النعرات القومية والعصبيات الجاهلية، وقبحت أثرة المترفين، وحمل لواء الجهاد أكابر الرجال من المستضعفين. جزى الله عنا أهل الحديث خيرا فلهم في أعناقنا دين أي دين إذ صححوا وانتقدوا وبلغوا"0.
المطلب الخامس: لغة القرآن وعاء الخطاب المتزن:-
مفهوم اللغة:
يقول "ابن جني" عن تصريفها وحروفها "فإنها فعلة من لغوت. أي تكلمت وأصلها لغوة ككرة وقلة وثبة كلها لاماتها واوات لقولهم. كروت بالكرة"0 تعددت تعاريف اللغة بتعدد المدارس والمنطلقات الفلسفية واللغوية واللسانية والاجتماعية...لكنها تكاد تتفق على بعض الخصائص الأصيلة في اللغة، من ذلك:
وأورد في هذا السياق ثلاثة تعاريف، فهي عند "ابن جني": "أصواتٌ يعبِّر بها كلُّ قوم عن أغراضهم،"0 أما عند "دي سوسير"، فهي "نتاجٌ اجتماعيٌّ لملَكة اللسان ومجموعة من التقاليد الضرورية التي تبنَّاها مجتمعٌ ما؛ ليساعد أفراده على ممارسة هذه الملَكة"0، بينما يرى "إبراهيم أنيس" أنها عبارة عن "نظام عرفي لرموز صوتية يستغلها الناس في الاتصال بعضهم ببعض".0
ولعل المشترك بين هذه التعاريف وغيرها التالي: اللغة أصوات، اللغة تعبير، اللغة نتاج مجتمع، تأثر اللغة بالأعراف الاجتماعية0، وهذا ينطبق على جميع اللغات، إلا أن اللغة العربية، تكتسب القدسية المعرفية والوجدانية والوظيفية لأنها لغة كتاب رب العالمين.
-
اللغة وعاء الخطاب المتزن:
لا يخفى أن الوعاء، اللغة أقصد، إذا صفا من أدران الحقد والكراهية والعنف والتيئيس، وتزين، كذلك، بجمال التسامح والتراحم والتكارم والتعاون، وغيرها من القيم النبيلة التي يدعو إليها القرآن الكريم، وتدعو إليها السنة القولية والفعلية والتقريرية وجميع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا محالة، أن ذلك، سيحاصر الخطاب المنحبس المقنط المتشرذم، وسيُنتَج بدل ذلك خطاب كوني، يؤمن بالمشترك ويشجع عليه، ويتخلى عن الولاءات الطائفية، وينفر منها، لأنها محملة بقيم العنف والإقصاء والتكفير والتفسيق والتبديع...وهلم جرا.
ولا يتأتى ذلك إلا إذا تمكن؛ هذا الخطاب؛ من لغة القرآن، وكان وفيا لها ولهويته، حينها يكون النبوغ في باقي المجالات: العلوم الشرعية، وكل العلوم التي لها ارتباط بالقرآن الكريم، ولا علم وفقه، ولا نبوغ ثقافي إلا بلغته، وإلا كيف نبغ من نبغ من كثير من العجم، في القرون الأولى للإسلام، وكذلك في زماننا؟
ما نبغ العجم المسلمون في الدين وعلومه، وباقي علوم الدنيا إلا بعد نبوغهم في لغة القرآن، وكانوا أشد الناس حرصا على هويتهم، وأكثرهم إنتاجا في ثقافته، بل أكثرهم خدمة للإسلام وخطابه، فهل سيبويه عربي؟ ومن هو ابن جني؟ وهل الفيروز آبادي عربي؟ وفي المغرب نبغ الكثير الكثير من الأمازيغ، وكانوا أوفى الأوفياء للإسلام، وللغة القرآن وثقافته، ولم تمنعهم عجمتهم ولا انتماءاتهم، ولا ولاءاتهم العرقية والسياسية والقبلية القديمة من ذلك، بل هدموا كل الحواجز بخدمة لغة الإسلام وثقافة الإسلام.0
المطلب السادس: الخطاب الإسلامي وعاء القضايا الجوهرية والمصيرية للإنسان؛مفهوم الإنسان:
ليس المقصود بذكر هذا المصطلح الوقوف عند الاختلافات المفهومية وتطورها وتناقضها، باختلاف وتناقض الفلسفات على طول وعرض الكرة الأرضية زمانا ومكانا، لكن القصد منه هو لفت النظر إلى احتلال هذا الإنسان؛ كل إنسان؛ في أي خطاب، مكانة محورية، باعتباره موضوعا له وبؤرة تركيزه، ثم باعتباره الفاعل الأساسي، فهو المرسل والمرسل إليه، وهو الذي يشحن الرسالة، إما عنفا وتيئيسا، أو تدليسا...أو يشحنها رحمة وتبشيرا واستبشارا...مصداقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: " "يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا"0.
وكأنه صلى الله عليه وسلم يخاطب هذا الزمان؛ من وراء ستار الغيب؛ بالالتزام بالحلم والأناة والتؤدة والتيسير، وكل أنواع الرفق، وتجنب التعسير في الخطاب، لأن في ذلك مشقة على الناس، كل الناس، وبذلك يكتسب الخطاب الإسلامي إنسانيته وعالميته.
القضايا الجوهرية والمصيرية للإنسان:
كان الإنسان وقضاياه الجوهرية المحور الأساس الذي يدور عليه الخطاب الإسلامي، منه يبدأ وإليه ينتهي، لأنه هو اللبنة الأساسية في بناء المجتمع، واعتبارا لمكوناته الروحية والعقلية والمادية، فهو في حاجة ماسة إلى خطاب يشحذ همته، ويوجهه الوجهة السليمة القاصدة، الشاملة المتزنة.
خطاب يرقى بالإنسان، ويجاوز به أنواع التخلف والهوان الذي ورثه عبر قرون التخلف والجهل والتجهيل، بما في ذلك آفة الاستلاب الحضاري الذي تتجرع الأمة سمه، منذ أن تحور الحكم في العالم الإسلامي، من خلافة راشدة، تقوم على الشورى بسياقها القرآني، إلى ملك وراثي، ثم حكم استبدادي ملوكي وجمهوري...جاثم على رقاب العباد بمنع الحريات والتجمعات والتعدديات، ويشمع الأفواه والبيوت.
خطاب يُنقد العلماء من ذل الانبطاح أمام إغراء المال والمنصب والخوف من السلطان... خطاب يعري بلوى الأمة، بعد تهميش الثقافة الإسلامية والخطاب الإسلامي، وسجنهما في المساجد، وما تلا ذلك من استلاب واستحمار لأبناء المسلمين، حين انبهروا ببريق الحرية والديمقراطية الهاملة، فصارت الأمة "غُثاء، وكلمةً دخيلة في قاموس التاريخ"0، بعد إنكارها أصولها، وكفرَانِها رِسالتها، وجهلِها بما هي ومن أين جاءت أمة وإلى أين تصير بعد الموت فرادى.0
خطاب، يفترض أن يلح في كل تفاصيله المستمدة من القرآن والسنة على هذا النوع من الإنسان المقهور، المسلوب الإرادة، باعتباره محور هذا الوجود الابتلائي، حتى لا يكاد يكون شيء من مضامينه التي يُجتهد في إنتاجها، إلا وهو معتن أشد ما تكون العناية، بتسهيل المأمورية الإنسانية في العمران البشري.
على هذا الأساس، أي خطاب يصادم في أفق تداوله "الإنسان" فينبغي تصحيحه، لأن الإنسان وجوهره أسبق، ويعني ذلك أن كل المعتبرات هي في خدمة الإنسان، لأنه إذا كان وضعه غير سليم فأنى تصح له عبادة أو معاملة، أو وجود أصلا وفصلا..
بمعنى آخر، لا ينبغي لهذا الخطاب أن يُفوِت على الإنسان فرصة معرفة ماهيته الحقيقية، حتى يتمكن من نفسه، من عبادة الله ربه، يتمتع بحريته، يعبر عن رأيه، فيكون الخطاب بذلك وعاء لمصدر البلاغ الإلهي، "وتبصرة وذكرى في أعماق الفطرة الإنسانية، استعدادا لسماع النداء الإلهي الذي يتضمنه"0، نداء لكل إنسان على الأرض.
الخاتمة:لثبات هذا الخطاب على قول الحق بكل مسؤولية وجرأة، ولتكوين رصيد فكري وتاريخي يشهد بنقاء لغته ومضمونه حتى لا يتنكب عن مساره، أو ينجر إلى سجالات هامشية استنزافية بمنطق الخصوم، وللتقليل من الخلاف ونشر لغة التياسر والتطاوع، بغرض التعايش والتعارف والتعاون والتكامل، نسجل التوصيات التالية:
-
على المهتمين والممارسين أن يُضَمِنوا خطابهم علنا أنهم ليسوا ولن يكونوا وحدهم في الساحة.
-
الوعي العميق " بأهمية اللغة العربية، وتأثيرها في فهم الدين وإدراك أسرار العبارة القرآنية، وتوحيد الأمة على كلمة سواء"0، على المستويين السابقين: الأنفسي والآفاقي.
-
الانتباه إلى أن اللغة هي الأس المؤثر باعتبارها وسيلة التعبير من جهة، وغاية لا يستطيع مخلوق العيش بدونها من جهة أخرى.
-
إدراك أهمية الخطاب في قوة التدين وقدرتها على لملمة الشتات والتقريب بين الناس وتوحيدهم.
-
إدراك العلاقة الوطيدة للخطاب بكل أنواعه بقضايا الأمة، ثم القضايا الجوهرية والمصيرية للإنسان.
-
الانتباه إلى خطورة التجزيء على كل المجالات، خاصة الخطاب.
-
العمل على تخليق الخطاب وتضمينه القيم النبيلة الرافضة للعنف وكل أشكال الميز ونشر الكراهية.
-
-
القرآن الكريم.
-
إبراهيم أنيس، اللغة بين القومية والعالمية، ط 1، دار المعارف المصرية، 1970.
-
ابن تيمية، مجموع الفتاوي، المحقق، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، د ط، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، 1416هـ/1995م.
-
أبو الأعلى المودودي، تجديد الدين وإحيائه، ط2، دار الفكر الحديث، لبنان، 1386ه/1967م.
-
أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي، الخصائص، ط4، الهيئة المصرية العامة للكتاب.
-
أبو الفضل جمال الدين محمد بن منظور: لسان العرب، ط3، دار صادر -بيروت، 1414 هـ.
-
أبو عبد الله الحاكم ابن البيع، المستدرك على الصحيحين، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، ط1، دار الكتب العلمية بيروت، 1411 / 1990.
-
أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، الصحاح، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، ط4، دار العلم للملايين بيروت، 1407 هـ -1987م.
-
أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين، معجم مقاييس اللغة، د ط، المحقق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، 1399هـ /1979م
-
إدريس مقبول، سؤال المعنى في فكر عبد السلام ياسين، إفريقيا الشرق، د ط، 2014م.
-
إدريس مقبول، ما وراء السياسة، الموقف الأخلاقي في فكر عبد السلام ياسين، ط1، مطبعة أفريقيا الشرقـ المغرب، 2016.
-
إعداد ياسر فرحات، هموم المسلم المعاصر، مكتبة التراث الإسلامي.
-
أقصد الواقعية التي هي من صميم ما يتطلبه النظر العلمي والتوقع للمستقبل الذي لا يبنى على الأوهام بل على حقائق ومعطيات دقيقة وموضوعية، وهي واقعية لها أهميتها وجدواها في إرساء أي نظرية على أرضية صلبة، في مقابل واقعية خاضعة منقادة الى الواقع المريض. انظر: إدريس مقبول، سؤال المعنى في فكر عبد السلام ياسين.
-
بالحبيب رشيد، لغة القرآن الكريم في كتابات الشيخ ياسين: المنزلة والوظائف، كتاب أعمال المؤتمر العلمي الدولي الأول في موضوع، مركزية القرآن الكريم في نظرية المنهاج النبوي عند الأستاذ عبد السلام ياسين، استانبول 17-18 محرم 1434ه / 1-2 دجنبر 2012م، تقديم: إدريس مقبول، تنسيق علمي وإشراف: محمد رفيع، عبد العظيم صغيري، عبد الصمد الرضى، د ط ولا تاريخ.
-
الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، تحقيق صفوان عدنان الداودي، ط1، دار القلم، الدار الشامية، دمشق بيروت، 1412هـ، ص 144/145.
-
السيوطي، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، مركز هجر، ط1، 2003م/1424هـ.
-
ط1، المركز الثقافي العربي، 1998م.
-
طه عبد الرحمن، اللسان والميزان، طه عبد الرحمن، روح الحداثة المدخل الى تأسيس الحداثة الإسلامية، ط1، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء المغرب، 2006.
-
عصام فاروق، مفهوم اللغة عند اللغويين القدماء والمحدثين، 30/1/2017 ميلادي، مقال إلكتروني، https: //www.alukah.net/literature_language
-
عويسيان التميمي البصري، البلاغ والتبليغ، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة مصر، المكتبة الشاملة
-
فردينان دي سوسير، علم اللغة العام، ترجمة، يوئيل يوسف عزيز، آفاق عربية 1985.
-
الفيروز آبادي، القاموس المحيط، تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، ط6، مؤسسة الرسالة بيروت، 1998م.
-
مجموعة من الباحثين، وحدة الأمة في فكر الإمام عبد السلام ياسين، ط 1، أفريقيا الشرق، 2015.
-
محمد بن محمد رفيع، الإسلام والأمازيغية، كتاب جماعي، مطبعة دار القلم بالرباط، الكتاب: 2/2012م.
-
محمد علي سميران، ضوابط التجديد الفقهي، منشورات مؤسسة منارات الفكر الدولية كتاب المـــؤتـمـر العالمي: العلوم الإنسانية والشرعية: قضايا ومناهج وآفاق.
-
مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، المسند الصحيح، تحقيق، محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي – بيروت.
-
منار الهدى، مجلة فكرية شهرية جامعة، الخطاب الإسلامي وإشكالات التواصل، العدد: 12، خريف 2008.
-
ياسين عبد السلام، الإسلام والقومية العلمانية، ط1، دار الخطابي للطباعة والنشر، الدار البيضاء، 1989.
-
ياسين عبد السلام، المنهاج النبوي تربية وتنظيما وزحفا، ط2، الشركة العربية للنشر والتوزيع القاهرة، 1989.
-
ياسين عبد السلام، تنوير المؤمنات، ط1، دار لبنان للطباعة والنشر، بيروت، 1996 ج 2،1.
-
ياسين عبد السلام، حوار مع صديق أمازيغي، ط1، الدار البيضاء، مطبوعات الأفق، 1997م.
-
ياسين عبد السلام، كيف نجدد إيماننا، ط1، مطبوعات الأفق، الدار البيضاء، 1998.
-
ياسين عبد السلام، نظرات في الفقه والتاريخ، ط1، دار لبنان للطباعة والنشر، بيروت، 1989
0 منار الهدى، مجلة فكرية شهرية جامعة، الخطاب الإسلامي وإشكالات التواصل، خريف 2008، افتتاحية العدد12.
0 انظر الحديث النبوي الشريف: "خُذوا العطاءَ ما كان عطاءً، فإذا كان رَشوة عن دينكم فلا تأخذوه. ولن تتركوه! يمنعكم من ذلك الفقرُ والمخافة! إن بني يأجوج قد جاؤوا. وإنَّ رحى الإسلام ستدور، فحيثما دار القرآن فدوروا به. يوشك السلطان والقرآن أن يقتتلا ويتفرقا. فإنه سيكون عليكم ملوكٌ يحكمون لكم بحكم، ولهم بغيره. فإن أطعتموهم أضلوكم، وإن عصيتموهم قتلوكم». قالوا: يا رسول الله! فكيف بنا إن أدركنا ذلك؟ قال: «تكونوا كأصحاب عيسى، نُشرُوا بالمناشير ورُفعوا على الخشب. موتٌ في طاعة خيرٌ من حياة في معصية" الحديث. نقله السيوطي في «الدر المنثور في التفسير بالمأثور» في تفسير قوله تعالى: ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾، [المائدة: 78] مركز هجر، ط1، 2003م/1424هـ، ج 5، ص396. وفي «الجامع الصغير»، تحت رقم: 3893، ص237.
0 ياسين عبد السلام، حوار مع صديق أمازيغي، ط1، الدار البيضاء، مطبوعات الأفق، 1997م، ص 133، بتصرف.
0 إدريس مقبول، ما وراء السياسة، الموقف الأخلاقي في فكر عبد السلام ياسين، ط1، مطبعة أفريقيا الشرقـ المغرب، 2016، ص 356.
0 أقصد الواقعية التي هي من صميم ما يتطلبه النظر العلمي والتوقع للمستقبل الذي لا يبنى على الأوهام بل على حقائق ومعطيات دقيقة وموضوعية، وهي واقعية لها أهميتها وجدواها في إرساء أي نظرية على أرضية صلبة، في مقابل واقعية خاضعة منقادة الى الواقع المريض. انظر: إدريس مقبول، إدريس مقبول، سؤال المعنى في فكر عبد السلام ياسين، د ط، إفريقيا الشرق، 2014م، ص132.
0 خالد العسري، الخطاب الإسلامي بين مأزق التاريخ، نحلة الغالب، ومنطق الساحة، مجلة منار الهدى، ع 12/2008، ص35. بتصرف
0 محمد بن محمد رفيع، الإسلام والأمازيغية، كتاب جماعي، مطبعة دار القلم بالرباط، الكتاب: 2/2012م، ص 22.
0 أبو الفضل جمال الدين محمد بن منظور: لسان العرب، ط3، دار صادر -بيروت، 1414 هـ، ج1، ص: 361.
0 الفيروز آبادي، القاموس المحيط، تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، ط6، مؤسسة الرسالة بيروت، 1998م، باب الباء، فصل الخاء، ص81.
0 طه عبد الرحمن، اللسان والميزان، ط1، المركز الثقافي العربي، 1998م، ص 213.
0 محمد حسني، الخطاب الإسلامي المعاصر، مظاهر القصور ومتطلبات التجديد، مجلة منار الهدى، ع 12/2008، ص 52.
0 طه عبد الرحمن، روح الحداثة المدخل الى تأسيس الحداثة الإسلامية، ط1، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء المغرب، 2006، ص 85.
0 الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، تحقيق صفوان عدنان الداودي، ط1، دار القلم، الدار الشامية، دمشق بيروت، 1412هـ.، ص 144/145.
0 عويسيان التميمي البصري، البلاغ والتبليغ، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة مصر، ص90، المكتبة الشاملة
0 ياسين عبد السلام، المنهاج النبوي تربية وتنظيما وزحفا، ط2، الشركة العربية للنشر والتوزيع القاهرة، 1989، ص404.
0 ياسين عبد السلام، مصدر سابق، ص404.
0 المصدر السابق، ص404.
0 أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، الصحاح، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، ط4، دار العلم للملايين بيروت، 1407 هـ -1987م، ج 2، ص454.
0 أبو عبد الله الحاكم ابن البيع، المستدرك على الصحيحين، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، ط1، دار الكتب العلمية بيروت، 1411 / 1990، ج 1، ص45.
0 أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، مصدر سابق، ج2، ص454، المادة نفسها.
0 أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين، معجم مقاييس اللغة، د ط، المحقق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، 1399هـ /1979م، ج1، ص409.
0 رواه أبو داود (رقم/4291) وصححه السخاوي في "المقاصد الحسنة" (149)، والألباني في "السلسلة الصحيحة" (رقم/599)
0 ابن تيمية، مجموع الفتاوي، المحقق، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، د ط، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، 1416هـ/1995م، ج18، ص297.
0 أبو الأعلى المودودي، تجديد الدين وإحيائه، ط2، دار الفكر الحديث، لبنان، 1386ه/1967م، ص13.
0 إعداد ياسر فرحات، هموم المسلم المعاصر، مكتبة التراث الإسلامي، ص: 31.
0 ياسين عبد السلام، كيف نجدد إيماننا، ط1، مطبوعات الأفق، الدار البيضاء، 1998، ص: 19/21.
0 ياسين عبد السلام، تنوير المؤمنات، ط1، دار لبنان للطباعة والنشر، بيروت، 1996، ج 1، ص320.
0 ياسين عبد السلام، مصدر سابق، ج 1، ص320.
0 محمد علي سميران، ضوابط التجديد الفقهي، منشورات مؤسسة منارات الفكر الدولية كتاب المـــؤتـمـر العالمي: العلوم الإنسانية والشرعية: قضايا ومناهج وآفاق، ص 472/481.
0 محمد علي سميران، مصدر سابق، ص: 472/481.
0 سؤال المعنى في فكر عبد السلام ياسين، مصدر سابق، ص 110.
0إدريس مقبول، ما وراء السياسة، مصدر سابق، ص130/131 بتصرف.
0 أحمد بوعود، التطرف وأزمة العقل المسلم، منار الهدى، ع 9/2007، ص123.
0 ياسين عبد السلام، نظرات في الفقه والتاريخ، ط1، دار لبنان للطباعة والنشر، بيروت، 1989، ص: 18/19.
0 أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي، الخصائص، ط4، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ج1، ص34.
0 ابن جني، مصدر سابق، ج1، ص34.
0 فردينان دي سوسير، علم اللغة العام، ترجمة، يوئيل يوسف عزيز، آفاق عربية 1985، ص27.
0 . إبراهيم أنيس، اللغة بين القومية والعالمية، ط 1، دار المعارف المصرية، 1970، ص11.
0 عصام فاروق، مفهوم اللغة عند اللغويين القدماء والمحدثين، 30/1/2017م.
0 مجموعة من الباحثين، وحدة الأمة في فكر الإمام عبد السلام ياسين، ط1، أفريقيا الشرق، 2015، ص292-293.
0 مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، المسند الصحيح، تحقيق، محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي – بيروت، ج3، ص1359، ر ح 1733.
0 ياسين عبد السلام، تنوير المؤمنات، ط1، دار لبنان للطباعة والنشر، بيروت، 1996، ج: 2، ص: 221.
0 ياسين عبد السلام، مصدر سابق، ج 2، ص221. بتصرف.
0 ياسين عبد السلام، الإسلام والقومية العلمانية، ط1، دار الخطابي للطباعة والنشر، الدار البيضاء، 1989، ص: 12.
0 بالحبيب رشيد، لغة القرآن الكريم في كتابات الشيخ ياسين: المنزلة والوظائف، كتاب أعمال المؤتمر العلمي الدولي الأول في موضوع، مركزية القرآن الكريم في نظرية المنهاج النبوي عند الأستاذ عبد السلام ياسين، استانبول 17-18 محرم 1434ه / 1-2 دجنبر 2012م، تقديم: إدريس مقبول، تنسيق علمي وإشراف: محمد رفيع، عبد العظيم صغيري، عبد الصمد الرضى، د ط ولا تاريخ، ج2، ص 837-838.
| Article Title | Authors | Vol Info | Year |
| Article Title | Authors | Vol Info | Year |