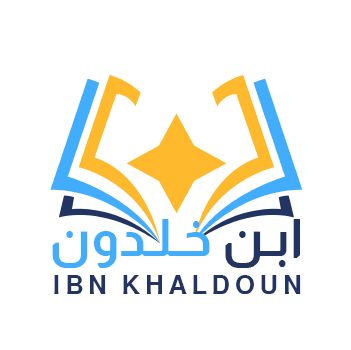2
7
2022
1682060055167_2299
https://drive.google.com/file/d/1hV1S_uYMPZWCGcPtbdlGcSilJHR-0p3n/view?usp=sharing
A strange description of the revelation of the Quranic event and the Quranic phenomenon
إعداد: د. جوهرة القدس عكية: أستاذة وباحثة، المملكة المغربية.
Abstract:
This research reveals that the experience of revelation is not an ordinary experience, rather it is an experience of a supernatural level, and if it is satisfied with the reality of revelation, it is transcendent, and it is not subject to any kind of human knowledge. In a way, this Quranic revelation provides the origins of an integrated approach to dealing with human history. Moreover, the Quran has dealt with the historical issue within many of the contexts of its surah and verse, ranging from narrating the events of Quranic stories, direct presentation of the experiences of the predecessors, whether they were individuals or groups, ending with extracting laws that govern historical social phenomena. To achieve the objectives of the research, the researcher used an analytical approach aimed at dismantling the phenomena and studying them in a detailed study. The research reached a set of results, the most important of which is that an event had a great impact on shaping and shaping the parameters of human thought and history represented in the Quran with its clear impact on the overall ranks and aspects of this thought. The most powerful and imprint of its influence throughout the successive ages, and will remain so, is the Holy Quran.
Keywords: Revelation, Quranic event, Quranic phenomenon.
المقدمة:
إن قصد الشارع من نزول القرآن هو هداية الخلق وصلاح البشر وعمارة الأرض، وطريقه في ذلك التربية بالحكمة، والتعليم بالإرشاد لمصادر المعرفة، والدعوة إلى توحيد الله سبحانه، وإقرار الألوهية والربوبية لعظمة جلاله. ولئن كان القرآن الكريم يهدي إلى معرفة الحقيقة، بإقامة الحجة المنطقية والبرهان العقلي، فإنه ينفي كل تحريف وقع في شرائع الأنبياء، ويدعو إلى إصلاح كل ما فسد من عقائد الدين. ولعل بعرضه للقصص القرآني، والإخبار عن الأنبياء والرسل، وما حدث للأقوام البائدة، ليرمي إلى تسجيل أحداث تاريخية، سرعان ما أصبحت أحداثا مقدسة.
ولما كان الأمر كذلك، فإن القرآن الكريم لم يتعرض لتفاصيل الحدث المقدس، في شقه الخاص بسيرة رسول الله، بصورة متكاملة عن حياته صلى الله عليه وسلم، بل إنما تعرض له بشكل مجمل. فمثلا حين يتحدث القرآن عن إحدى الغزوات، لا يذكر أسبابها، ولا عدد المسلمين والمشركين فيها، ولا عدد القتلى والأسرى من المشركين، بل يلمح النص القرآني إلى عبر وعظات يستعرض من خلالها قدرات السارد، وهذا شأن القرآن الكريم في كل ما أورده من قصص عن الأنبياء السابقين والأمم البائدة. سيما وأن "عروض القرآن التاريخية لم تنصب على الأنبياء كأفراد فحسب، بل اتجهت إلى الأقوام المختلفة كجماعات تلعب دورها الحاسم في حركة التاريخ"(خليل، 1981: 102). ومن ثم، فالغاية المنشودة من القصص ليست فقط الوعظ والإرشاد والتنوير، بقدر ما تتعداه إلى الوقوف على الحدث المقدس، وإخراجه من خبر "كان"، مما طمسته عوادي الدهر ومحته تداول السنين، إلى تجليته وتخليده في الذاكرة والتاريخ والجغرافيا.
وتبعا لهذا التحديد، فالقرآن يخلع لباس القداسة على الوقائع والأحداث ويجعلها متسامية ومتعالية عن طريق ربطها بالمطلق الأعلى، وبالإرادة الغيبية لله تعالى، ذلك أن النص الديني؛ قرآنا وسنة مرتبط بالوحي، وهو مكمن الحقيقة المقدسة والمنزلة، يستقي شرعيته وتعاليه من مصدره الإلهي. وأن الوحي مستويان؛ المستوى الروحي للوحي، وهو مستوى المطلق المتعالي المنزه عن كل شيء، والمستوى التاريخي الناتج عن نزول الوحي والمتجلي في لغة بشرية، من خلال نسق لغوي قائم الذات، وقابل للقراءة، ذو بعد تاريخي على الرغم من مصدره الإلهي المتعالي. ناهيك عن أن نص الوحي يفيض بالعجيب الذي أوقفه الحق سبحانه على رسله وأنبيائه، هذا العجيب الضارب في الاستغلاق، والمتجاوز لحدود العقل والمعقول، ما هو إلا استعراض لمظاهر القوة الربانية الخارقة لمألوف البشر. فضلا عن أنه وثيق الصلة بنصوص الوحي، ويحيا داخل النصوص الدينية، ويستدعي الوقوف أمام إعجاز القرآن الكريم، وعظمة الله عز وجل.
مشكلة البحث:
إن الوحي أكبر حدث تاريخي عرفته العرب وعرفه تاريخ الإسلام، ارتقى إلى حدث مقدس غير مجرى تاريخ البشرية جمعاء، نتج عنه الإعلان عن الإسلام دينا جديدا للعالمين. وأنه لم يخرج عن مألوف العرب، وعما يحدد خصوصيتهم الثقافية، ويشكل عصب حياتهم الاجتماعية والفكرية والروحية.
المنهج:
حاولت الباحثة في هذه الدراسة تبني مقاربة تحليلية ترتكز على تفكيك الظواهر المختلفة إلى مكوناتها الأولية، ودراستها دراسة تفصيلية، وفهم أنماط التفاعلات الموجودة فيما بينها، مع استنباط القوانين العامة التي تحكمها.
في إرهاصات الوحي والنبوة:
تفيد الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خلال الفترة التي سبقت بداية نزول الوحي يفضل العزلة عن قومه، والخلوة بنفسه، والانقطاع عن الدنيا ومشاغلها، فكان يخلو بغار حراء بجبل النور- وهو أحد جبال مكة المطلة عليها - يتحنت فيه، أي يتعبد فيه الله عز وجل مدة شهر من كل سنة، وهو شهر رمضان، وبعد انقضاء الشهر وتمامه يعود إلى مكة، فيطوف بالبيت، ثم ينصرف إلى أهله. "قال بن إسحاق: ذكر الزهري عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها أنها حدثته: أن أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة، حين أراد الله كرامته ورحمة العباد به، الرؤيا الصادقة، لا يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا في نومه إلا جاءت كفلق الصبح. قالت: وحبب الله تعالى إليه الخلوة، فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو وحده"(ابن هشام، د.ت: 234).
وضمن هذا المنظور، كان اختيار الرسول الكريم للعزلة والتفكر والتأمل في ملكوت الخالق سبحانه، وفي عظيم صنيعه، تدبيرا من الله تعالى له، وإعدادا للنبي صلى الله عليه وسلم لما ينتظره من أمر عظيم، فكان لا بد لروحه الزكية من خلوة وعزلة تنقطع فيها عن فتن الدنيا وملاهيها، حتى يتسنى لها بعد ذلك التأثير في واقع الحياة البشرية، وقلب موازينها وتغيير خط التاريخ.
وهكذا، أخذت تباشير النبوة تلوح في الأفق، إعلانا عن بعثة نبي عربي، هو خاتم الأنبياء والرسل، يؤدي الرسالة التي ستعهد إليه، ويحمل الأمانة الكبرى، أمانة الوحي. فكان الرسول الهادي الأمين كلما مر بحجر أو شجر إلا وقال السلام عليك يا رسول الله، وفي هذا الأمر إنباء بنبوته صلوات الله عليه وسلامه. وقد ذكر ابن إسحاق أن رسول الله حين أراده الله بالنبوة " كان إذا خرج لحاجته أبعد حتى تحسر عنه البيوت ويفضى إلى شعاب مكة وبطون أوديتها، فلا يمر رسول الله بحجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله. قال: فيلتفت رسول الله حوله وعن يمينه وشماله وخلفه، فلا يرى إلا الشجر والحجارة. فمكث رسول الله كذلك يرى ويسمع، ما شاء الله أن يمكث، ثم جاءه جبريل عليه السلام بما جاءه من كرامة الله، وهو بحراء في شهر رمضان" (ابن هشام، د.ت: 234- 235).
بداية النبوة ونزول الوحي:
بعد أن تم إعداد النبي الكريم لتلقي الوحي الإلهي، وبينما هو في خلوته بغار حراء، كعادته في شهر رمضان من كل عام، مستغرق في عبادته وتأملاته، إذ جاءه الملك جبريل عليه السلام في صورة
رجل لا يعرفه، وكان ذلك في يوم الاثنين لسبع عشرة خلت من رمضان، وعمره صلى الله عليه وسلم آنذاك أربعون سنة، بالتحديد، وهي سن الكمال والتمام التي تبعث فيها الأنبياء والرسل. ويذكر ابن إسحاق في رواية له، على لسان رسول الله وقائع وملابسات هذا اللقاء الجلل مع جبريل عليه السلام، أن رسول الله قال: "فجاءني جبريل وأنا نائم، بنمط من ديباج فيه كتاب، فقال: اقرأ، قال: قلت: ما أقرأ ؟ قال: فغتني به حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني فقال: اقرأ، قال: قلت: ما أقرأ ؟ قال: فغتني به حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني، فقال: اقرأ، قال: قلت: ماذا أقرأ ؟ قال: فغتني به حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني، فقال: اقرأ، قال: فقلت: ماذا أقرأ؟ ما أقول ذلك إلا افتداء منه أن يعود لي بمثل ما صنع بي، فقال: (اقرأ باسم ربك الذي خلق * خلق الإنسان من علق * اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم * علم الإنسان ما لم يعلم )). قال: فقرأتها ثم انتهى فانصرف عني وهببت من نومي، فكأنما كتبت في قلبي كتابا. قال: فخرجت حتى إذا كنت في وسط من الجبل سمعت صوتا من السماء يقول: يا محمد، أنت رسول الله وأنا جبريل، قال: فرفعت رأسي إلى السماء أنظر، فإذا جبريل في صورة رجل صافٌّ قدميه في أفق السماء يقول: يا محمد، أنت رسول الله وأنا جبريل. قال: فوقفت أنظر إليه فما أتقدم وما أتأخر، وجعلت أصرف وجهي عنه في آفاق السماء، قال: فلا أنظر في ناحية منها إلا ناحية رأيته كذلك، فما زلت واقفا ما أتقدم أمامي وما أرجع ورائي حتى بعثت خديجة رسلها في طلبي، فبلغوا أعلى مكة ورجعوا إليها وأنا واقف في مكاني ذلك، ثم انصرف عني"(ابن هشام، د.ت: 236- 237). وقد تضاربت الروايات حول تلقي رسول الله للوحي أَ كان مناما أم يقظة ؟ وتكاد تجمع الروايات على أن الوحي نزل على النبي وهو نائم "فجاءني جبريل وأنا نائم"، غير أنا نستثني رواية الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها، التي أوردها في صحيحه بسندها المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقر بأن تلقي الوحي كان يقظة " فجاءه الملك فقال له: اقرأ، قال: ما أنا بقارئ، قال: فأخذني فغطني – أي ضمني وعصرني – حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ، فقلت: ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ، فقلت: ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: ( اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم)، فرجع بها رسول الله يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي، فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا: إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق"(البخاري، 2002: 3). فرواية البخاري هاته تقطع باليقين في أن الوحي فاجأ النبي، وهو يقظ يعبد الله في خلوته، ثم إن في رجفة فؤاده صلى الله عليه وسلم إشارة إلى الرعب الذي اعتراه، لأن الوحي نزل عليه بغثة، ولم يكن يتوقع حدوثه، لذلك أصابه الفزع والرعب، فلو حدث له ذلك في المنام لذهب عنه الرعب بمجرد استيقاظه، كما قال الله عز وجل: " وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ "[الشورى: 52]. ولذلك، حرصت خديجة رضي الله عنها على تجلي الحقيقة، ومعرفة صحة الأمر من ابن عمها ورقة بن نوفل - وكان قد تنصر في الجاهلية، وقرأ الكتب وسمع من أهل التوراة والإنجيل - فأخبرته بما أخبرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ورقة: لقد جاءه الناموس الأكبر– صاحب الوحي وهو جبريل– الذي كان يأتي موسى عليه السلام، وإنه لنبي هذه الأمة، ولئن أدركت ذلك اليوم لأنصرنه نصرا مؤزرا يعلمه الله.
هكذا، بدأ نزول القرآن في ليلة مباركة من ليالي شهر رمضان الكريم، بوساطة أمين الوحي جبريل عليه السلام، على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أول ما نزل من القرآن قوله تعالى: " اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ " [العلق: 1 - 5].
ومن ثم، فإن أول ما نبئ به صلى الله عليه وسلم الخمس آيات الأولى من سورة العلق، فكانت بذلك نبوته سابقة على الرسالة التي أمر بتبليغها، إذ نبئ صلوات الله عليه بـ" اقرأ "، وأرسل بالمدثر" يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ، قُمْ فَأَنْذِرْ، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِر" [المدثر: 1-6]. وقد كان بين نزول الآيات الأولى من سورة العلق، وأوائل سورة المدثر فترة من الزمن، نظرا لفتور الوحي. وبانقطاع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تضاربت الروايات واختلفت في تقدير هذه الفترة، فكان أقصاها ثلاث سنوات، وأدناها ستة أشهر. وقد شق هذا الأمر على رسول الله وأحزنه كثيرا، حتى كاد يخرج إلى الجبال فيتردى من رؤوسها، ظنا منه أن الله قلاه بعد أن كرمه واختاره لشرف الرسالة، ثم عاد الوحي إليه بعد ذلك، وتتابع نزول القرآن الكريم في سائر الأيام والشهور، وظلت آياته تتنزل منذ بعثته صلى الله عليه وسلم إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى، وهي مدة قدرت بثلاث وعشرين سنة.
وعليه، يكون في فتور الوحي وانقطاعه عن رسول الله فترة من الزمن، ثم عودته مجددا– بعد زوال الروع عن قلبه، وتثبيت أمره، وتقوية إرادته وعزيمته، وتهييئه لتحمل تجربة الوحي– امتثال للأمر الإلهي، فشرع الحبيب المصطفى في الدعوة سرا إلى توحيد الله الأحد واعتناق الإسلام، مبلغا قومه ما أنزل الله عليه، ومنذرا إياهم عاقبة ما هم فيه من الشرك والكفر بعبادتهم الأوثان.
الوحي في المعهود اللغوي والثقافي العربيين:
إن مفهوم الوحي بمعناه الديني لم يكن في معهود العرب اللغوي والثقافي، خاصة أن المعاجم اللغوية العربية على اختلاف مشاربها، قديمها وحديثها، تجمع على تعريف الوحي بأنه الإشارة، والإلهام، والرسالة، والكتابة، والكلام الخفي، وكل ما ألقي إلى الغير، إما تصريحا أو تلميحا. ويقال وحيت إليه، وأوحيت، ووحى وحيا، وأوحى أيضا بمعنى كتب، وما يؤكد هذا المعنى، قولهم في المثل "أبقى من وحي في حجر". فأصل "الوحي في اللغة كلها الإعلام في خفاء، ولذلك صار الإلهام يسمى وحيا، وصارت الإشارة المتفق عليها تسمى وحيا"(ابن قتيبة، 1969: 282) والأمر عينه نجده عند الشاعر أبو ذؤيب الهذلي:
فقال لها وقد أوحت إليه إلا لله أمك ما تعيف.
هكذا، عرفت العرب الوحي بأنه الكتابة، أو الإشارة، أو الإلهام، أو الاتفاق الخفي، أو أي وسيلة يصل بها الكلام إلى الشخص المقصود. أما المعنى الديني لكلمة "الوحي" فلا تشير إليه المعاجم العربية إلا في تعالقه مع القرآن الكريم، والأمر عينه يسري على كلمة "النبوة"، التي تؤدي في اللغة معنى الارتفاع عن الأرض، والنبي من النباوة؛ المرتفع من الأرض، بمعنى أن العرب لم يكن لديها قبل الإسلام أي تصور للنبوة، إلا بمعنى الرفعة والشرف، وأن مسألة تلقي البشر الوحي من الله الأحد كانت مغيبة تماما في ثقافة العربي.
إن معنى الوحي في القرآن الكريم لم يخرج عن المعاني التي أشرنا إليها، وقد ورد في ثمانين آية من القرآن الكريم، حيث نسجل أن معظم هذه الآيات أفادت أن الوحي هو ما أبلغه الله أنبياءه، ورسله لينشروه. وقد ورد الوحي في القرآن الكريم في بعض الآيات بمعناه اللغوي، أي إيصال المعنى إلى الآخرين بوسيلة من الوسائل، من ذلك قوله تعالى على لسان نبيه زكريا عليه السلام: " فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا " [مريم: 11]، فنبي الله زكريا عليه السلام كان صائما عن الكلام، لا يحدث الناس إلا إشارة، قال تعالى: " قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا " [مريم: 10]. كما يكون الوحي بين أفراد الناس بعضهم مع بعض، وأيضا قوله سبحانه: " وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون" [الأنعام: 112]؛ فضلا عن تسمية الله عز وجل وسوسة الشيطان للإنسان وحيا، وهو ما يفهم من قوله تعالى: " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون " [الأنعام: 121].
والحالة هذه، فقد عرف الوحي واشتهر بين المسلمين على أنه وحي الله عز وجل لرسله، فإذا أطلقت هذه الكلمة انصرف الذهن إلى ذات المعنى، على الرغم من تشابه المعنيين اللغوي والإسلامي. غير أن تخصيص الوحي بوحي الله عز وجل إنما وقع من تخصيص القرآن الكريم له، بأن جعله معنى إسلاميا.
مفهوم الوحي في التحديد الإسلامي وصوره:
يمثل الوحي الشرع الذي أمر الله أنبياءه ورسله باتباعه، وتبليغ تعاليمه السامية، وبما أن الوحي مرتبط بالواقع وبالتاريخ، فهو "ليس معطى من الله في لا زمان ولا مكان، بل هو تنزيل إلى البشر، وحلول في التاريخ وتوجيه للوقائع وحلول للمشاكل"(حنفي، 1982: 336)، وهذا ما يشير إليه منطوق الآية الكريمة " وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم " [الشورى: 51]. أي بطريقة الإلهام في اليقظة أو المنام، أو يسمع صوتا ولا يرى صورة، أو عن طريق الملاك الواسطة. وبهذا يكون الإسلام قد جاء بتحديد جديد لمعنى الوحي، وحصره في ثلاث صور:
-
الصورة الأولى: الوحي بمعنى الإلهام كوحيه تعالى إلى عمار السموات من الملائكة: " وأوحى في كل سماء أمرها " [فصلت: 12]، وأيضا وحيه إلى النحل، لقوله عز وجل: " وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون " [النحل: 68]، وكذلك وحيه إلى أم موسى عناية منه سبحانه بوليدها: " وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه " [القص: 7].
-
الصورة الثانية: الكلام من وراء حجاب، كمناداة الله موسى عليه السلام من وراء الشجرة وسماعه نداءه، لقوله تعالى: " وكلم الله موسى تكليما " [النساء: 164].
-
الصورة الثالثة: إرسال ملاك رسول، وهو جبريل عليه السلام، سواء أرسل في صورة رجل أو في صورته الملائكية، إذ يقوم بنقل كلام الله عز وجل، ويلقيه على من اختاره الله واصطفاه رسولا يبلغ رسالته إلى عباده الصالحين الأخيار.
ومن ثم، نتبين أن الصورة الثالثة، تحديدا، لم تكن في معهود العرب قبل مجيء الإسلام، ولا فيما كان يمكن أن يعرفوه من أهل الكتاب. فالعرب خبرت جيدا الكهانة والعرافة، وتسخير الجن في أغراض السحر، وإرسال الهواتف، أما أن يتلقى أحدهم الوحي من الله، فذلك ما لم يكن حاضرا في المعهود الثقافي العربي. وهكذا، فإن العملية التي تم بها التبليغ إلى الرسول الكريم، والتجربة الفريدة التي عاشها، إنما تخضع لتصور يضعنا أمام حوار علوي لذاتين؛ الذات الإلهية المتكلمة الآمرة المعطية، والذات البشرية المخاطبة المأمورة المتلقية. ومن ثمة، فإن طريقة تلقي رسول الله الوحي، وكيفية تنزله عليه، لتجسد علاقة الإنساني بالإلهي، وفق حديث البخاري، إذ قال رسول الله - وقد سأله الحارث بن هشام عن كيفية إتيان الوحي له - فقال: "أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي فيفصم عني، وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول". إن هذا الحديث يكشف عن طريقتين من الوحي؛ الأولى أن يسمع صوتا متعاقبا متداركا مثل صوت صلصلة الجرس المجلجل، وهو أشده على رسول الله، لأن هذه الحالة هي انسلاخ من البشرية الجسمانية، واتصال بالملكية الروحية، وأما الثانية أن يتمثل له الملك جبريل بصورة إنسان يشاكله في المظهر، ويطمئنه بالقول ولا يرعبه، وهذه الحالة هي الأخف وقعا والألطف على قلب نبينا الكريم.
وعليه، نستشف من الحديث الشريف الحرص الشديد لرسول الله على وعي ما أوحي إليه من رب العزة والملكوت، حسب قوله "فيفصم عني وقد وعيت"، وأيضا "فيكلمني فأعي ما يقول". على نحو، يثبت وعيه صلى الله عليه وسلم الكامل لحالته قبل الوحي، وبعد الوحي، وأثناء الوحي، سواء اشتدت أم خفت عليه وطأة نزول القرآن الكريم، دون الخلط بين شخصيته الإنسانية المأمورة المتلقية، وشخصية الوحي الآمرة المتعالية.
الوحي: الحدث القرآني أو الظاهرة القرآنيةيمثل القرآن الكريم الوحي الإلهي، والسنة الصحيحة هي البيان العملي والتطبيقي للبلاغ القرآني. والقرآن باعتباره خطابا ورسالة دينية متصلين بالوحي، أي بالذات الإلهية، هو جزء من كلام الله تعالى الأزلي واللانهائي وغير المخلوق. وهو "كمعان وألفاظ من هذا العالم مندرجة في الفضائي- الزمني يدرك بالإدراك الحسي والذهني، ليس هو إلا نسخة من "الأركيتيب" الأصلي الإلهي"(جعيط، 1999: 17). وهذا "الأركيتيب: Archétype" هو ما يسميه "أركون" بـ"اللوح المحفوظ "، ذلك إن "الوحي ككل محفوظ في الكتاب السماوي، في أم الكتاب كما يقول القرآن، أو في اللوح المحفوظ. وينبغي أن نعلم أن مفهوم الكتاب السماوي المعروض بقوة في القرآن هو، في الواقع، أحد الرموز القديمة للمخيال الديني المشترك الذي كان شائعا في الشرق الأوسط القديم "(أركون، 2001: 19). ومن ثمة، فالقرآن كنص مقدس ومنزل من الله حرفا ومضمونا، لا يمكن التشكيك في صحته، فكل كتب الأديان الأخرى؛ ومنها العهد القديم، والعهد الجديد، قد طالها التحريف، ولا يمكن بعد ذلك أن ترقى إلى مستوى القرآن، سواء في المضمون أو في الشكل. إنه كلام الله السرمدي الذي لا يخضع للتغيير والتبديل. على نحو، أن "النص القرآني كل لا يتجزأ، لأنه يهدف إلى غاية واحدة، وإن تنوعت مظاهر تعبيره، وينطلق من فلسفة منسجمة، وإن تبين للناظر إلى سطح الأمور تنوع في القضايا"(مفتاح، 1987: 192)، فقداسة النص القرآني متأتية من مصدره المتعالي، كونه وحيا إلهيا منزلا من السماء، وبالتالي فأية محاولة لإلغاء القداسة عنه تشكيك صريح في الوحي، وتحويل للوحي من السماء إلى البشر.
ويؤكد هذا أن "الوحي الذي قدم في القرآن من خلال محمد هو آخر وحي، وهو يكمل الوحي السابق له، والذي كان قد نقل من خلال موسى وعيسى. كما أنه يصحح التحريف الذي لحق بالتوراة والإنجيل. إنه يحتوي على جميع الأجوبة، والتعليمات، والمعايير التي يحتاجها البشر من أجل تدبير حياتهم الأرضية وهدايتها وتنظيمها ضمن منظور الحياة الأبدية "(أركون، 2001: 19). غير أن الفرق بين هذه الكتب الموحاة يكمن في تقدير القداسة للنص التوراتي، والنص الإنجيلي، والنص القرآني، ذلك أن اليهود يقدسون، بالتحديد، الأسفار الخمسة الأولى التي ينسبون زمن نزولها إلى نبي الله موسى عليه السلام، بينما يقدس المسيحيون شخص المسيح عيسى عليه السلام، فيما يشكل القرآن للمسلمين روح حياتهم وعصب دينهم، وبالتالي فرادة النص القرآني وتميزه عن سائر النصوص، وتساميه بشكل لا مثيل له.
وفي السياق ذاته، يستخدم "محمد أركون" مصطلح "الحدث القرآني" أو "الظاهرة القرآنية"، وليس القرآن للدلالة على تاريخية هذا الحدث، إذ المقصود بالحدث القرآني ذلك الحدث اللغوي والثقافي والديني الذي شهدته الجزيرة العربية إبان القرن السابع الميلادي، وهي الفترة المعبر عنها بحدث نزول الوحي، أي الحدث القرآني، الذي حصل بالفعل، وليس مجرد تصور ذهني، حيث لا توجد أية طريقة لتفسيره خارج تاريخية انبثاقه، وتطوره، وتناميه عبر التاريخ؛ هذه التاريخية التي تحكمت في ديناميكية
المتغيرات التي طرأت على المجتمع العربي طيلة فترة نزول الوحي القرآني، خاصة وأنها تشكل "الوعي الأسطوري – التاريخي القادر على مفصلة التاريخ الأرضي المحسوس أو ربطه بالتاريخ المثالي والمقدس للنجاة في الدار الآخرة. وهذا التاريخ المثالي المقدس هو الذي ظل المحرك الأساسي للتاريخ الأرضي ... ولكن إذا كان الخطاب القرآني يستطيع على هذا النحو خلع صبغة التعالي والتقديس على التاريخ الأرضي الأكثر دنيوية والأكثر عادية، فإنه لا ينبغي أن ينسينا الظرفية الراديكالية للأحداث التي اتخذت كحجة أو كعلة لظهوره"(أركون، 2001: 50).
ومهما يكن من أمر، فإن الحدث القرآني كظاهرة - على حد تعبير "محمد أركون" - نتيجة الوحي ومضمونه، شامل وكامل وصالح لكل زمان، ذو وظيفة تأسيسية، خاصة وأن الوحي ارتبط بالمجتمع وبالتاريخ وبالمعيش اليومي، فكان يأتي حلا للمشاكل بعد وقوعها. "إنه مجموعة من المواقف التي طرأت على الواقع الإسلامي الأول، والتي استدعت حلولا، وكل موقف يمثل نمطا مثاليا يمكن أن يتكرر في كل زمان ومكان"(حنفي، 1982: 310). فالوحي موجود في الزمان وليس خارجه، ويتطور بتطوره، ولعل هذا ما يؤكد تارخية الوحي وارتباطه الوثيق بحركية المجتمع وديناميته، مما يجعله خارج متغيرات التاريخ البشري.
الخاتمة:
هكذا، يكون الحدث القرآني "الظاهرة" أو ما يسميه "أركون" بـ "الظاهرة القرآنية" الحدث البارز والاستثنائي في تاريخ البشرية عامة، وفي التاريخ العربي الإسلامي خاصة، وتكون اللحظة المعبر عنها بنزول الوحي القرآني، هي لحظة التحوير الديني للتاريخ الدنيوي وتحويله إلى تاريخ مثالي مقدس ومتعال. " إن القرآن يؤسس وعيا خاصا بالعالم والتاريخ والدلالة "(أركون، 1987: 70)، وبذلك فالقرآن خاتمة لسيرورة وحي إلهي استمر منذ بدء الخليقة، وكلام الله الأزلي، واللانهائي، وغير المخلوق، والمهيمن على الكتب المقدسة الأخرى، تلك الكتب التي طالها التحريف وفقدت مصداقيتها. فالقرآن حجة للعمل والتطبيق، وهو كلي الشريعة، وأصل أصولها، والمصدر الأول من مصادر التشريع الإسلامي بدليل القرآن والسنة وإجماع الأمة. ليظل القرآن الكريم الموحى به من الله عز وجل إلى رسوله الكريم، بواسطة الملاك جبريل عليه السلام، المعجزة الخالدة لدين الإسلام الخالد.
النتائج:
-
إن النص الديني قرآنا وسنة، مرتبط بالوحي، وهو مكمن الحقيقة المقدسة والمنزلة، أي حقيقة المقدس، إذ يستقي شرعيته من تعاليه ومن مصدره الإلهي، "فهناك المستوى الروحي للوحي، مستوى المطلق المتعالي المنزه عن كل شيء، وهناك المستوى التاريخي الناتج حتما عن نزول الوحي إلى مستوى التاريخ، أو احتكاكه به أو انخراطه فيه - ثم انخراطه في حركة المجتمع وصراعاته المتضاربة وأهوائه - وهذا الاحتكاك أو الاندماج هو الذي يؤدي إلى تشكيل الإيديولوجيات الدينية، التي تخلع المشروعية على السلطات السياسية، أو تسحبها عن خصومها بحسب الحالة والحاجة"(أركون، 1995: 232 ).
-
إن النص القرآني لم يخرج عن معهود العرب، وعما يشكل عصب حياتهم الروحية والاجتماعية والفكرية، دون المساس بخصوصيتهم الثقافية، مخاطبا إياهم بلغتهم العربية، لغة الشعر الجاهلي، وأيضا لغة القرآن المعجزة، والمؤيدة له، "ولئن كانت مقدسة بوصفها لغة نزل بها الوحي الإسلامي، فإن هذه القداسة محايثة للتاريخ - أو هي، بمعنى ما تاريخية - فهي إلى جانب كونها تنقل رؤية الغيب، تنقل ما هو إنساني – ثقافي. إنها التعالي المحايث، أو هي التعالي والمحايثة في آن "(أدونيس، 2006: 46).
-
إن الظاهرة القرآنية، وإن كانت " في جوهرها تجربة روحية، نبوة ورسالة، فهي في انتمائها اللغوي والاجتماعي والثقافي ظاهرة عربية، وبالتالي يجب أن لا ننتظر منها أن تخرج تماما عن فضاء اللغة العربية، لا على مستوى الإرسال ولا على مستوى التلقي"(الجابري، 2006: 20). ومن ثم، التمييز بين الظاهرة القرآنية اللاتاريخية والمتعالية، والظاهرة الإسلامية التاريخية، التي يعتبرها "محمد أركون" ما هي في حقيقة الأمر، إلا تجسيد تاريخي محسوس للظاهرة القرآنية.
-
إن الوحي مستويان؛ المستوى المتعالي، والمستوى المتجلي في لغة بشرية، فالمستوى المتعالي للوحي لا يمكن أن يصل إليه أي كان من البشر، بما في ذلك الأنبياء والرسل، لأنه يمثل "أم الكتاب"، أو "اللوح المحفوظ"، لأنه كلام الله الأزلي اللانهائي والمحفوظ في "أم الكتاب". وأما المستوى الثاني فهو الوحي المنزل على الأرض باعتباره متجليا في لغة بشرية معينة، من خلال نسق لغوي قائم الذات، وقابل للقراءة، وهذا النوع من الوحي ذو بعد تاريخي، على الرغم من كونه إلهي المصدر، أي جزء من كلام الله اللانهائي المثبت في المصحف. وبذلك فإن التمييز بين هذين النوعين من الوحي هو ما نجده عند المعتزلة في نظريتهم القائلة بخلق القرآن الكريم.
-
إن مسألة تسجيل نص الوحي، باعتباره كلام الله تعالى، على الورق أو أي دعامة أخرى يجعل منه كتابا عاديا قابلا للمس، نقرأه، أو نحمله معنا، وهو في ذات الآن يحمل نقيضه المتعالي كونه كتاب الله سبحانه وتعالى. "وهكذا تم تحويل كلام الله المتمثل بنطقه الشخصي ذاته، وبصفته أزليا، أبديا، متعاليا، لا نهائيا وغير قابل للاستنفاد من قبل أي جهد بشري، إلى كتاب عادي مادي نلمسه باليد، ونتحسسه، ونفتحه، ونقرأه ...ولكنه يتمتع في الوقت عينه بمكانة "لاهوتية" بصفته "كتابات مقدسة"، وشرعا مقدسا، أي قانونا مقدسا وشريعة، وأخلاقا مقدسة، ومعرفة متعالية أو تخلع التعالي على الأشياء "(أركون، 2001: 25). حتى إن هذا الكتاب عينه صار من خلال سيرورة تاريخية كتاب الله، بمعنى أنه تم تقديسه عن طريق وجود "عدد من الشعائر، والطقوس، والتلاعبات الفكرية الاستدلالية، ومناهج التفسير المتعلقة بالكثير من الظروف المحسوسة المعروفة، أو التي تمكن معرفتها، وأقصد بها الظروف السياسية، والاجتماعية، والثقافية"(المسعودي، 1991: 96).
قائمة المصادر والمراجع:
-
القرآن الكريم.
-
أبو محمد عبد الملك بن هشام: السيرة النبوية لابن هشام، تحقيق وشرح مصطفى السقا،
-
وابراهيم الأبياري، وعبد الحفيظ شلبي، الجزء الأول، المكتبة العلمية، بيروت، (د.ت).
-
أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة: الشعر والشعراء، الجزء الأول، دار الثقافة، بيروت، 1969.
-
محمد بن إسماعيل البخاري: صحيح البخاري، المجلد الأول، دار ابن كثير، الطبعة الأولى، بيروت، 2002.
-
محمد مفتاح: دينامية النص؛ تنظير وإنجاز، المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى، 1987.
-
محمد عابد الجابري: مدخل إلى القرآن الكريم؛ في التعريف بالقرآن، الجزء الأول، دار النشر المغربية، الطبعة الأولى، الدار البيضاء، 2006.
-
علي أحمد سعيد (أدونيس): الشعرية العربية، دار الآداب، الطبعة الرابعة، بيروت، 2006.
-
عماد الدين خليل: التفسير الإسلامي للتاريخ، دار العلم، الطبعة الثالثة، 1981.
-
حسن حنفي: دراسات إسلامية، دار التنوير، الطبعة الأولى، بيروت، 1982.
-
هشام جعيط: في السيرة النبوية ؛ الوحي والقرآن والنبوة، دار الطليعة، بيروت، 1999.
-
محمد أركون: الفكر الإسلامي قراءة علمية، ترجمة هاشم صالح، مركز الإنماء القومي، بيروت، 1987.
-
محمد أركون: الإسلام، أوروبا، الغرب، رهانات المعنى وإرادات الهيمنة، ترجمة هاشم صالح، دار الساقي، الطبعة الأولى، بيروت، 1995.
-
محمد أركون: القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، ترجمة هاشم صالح، دار الطليعة، الطبعة الأولى، بيروت، 2001.
-
حمادي المسعودي: العجيب في النصوص الدينية، مجلة العرب والفكر العالمي، العددان 13 و14، مركز الإنماء القومي، بيروت، ربيع 1991.
Jaouharat Al Qods Aggya || A strange description of the revelation of the Quranic event and the Quranic phenomenon || Ibn Khaldoun Journal for Studies and Researches || Volume 2 || Issue 7 || Pages 72 - 85.
0
-
| Article Title | Authors | Vol Info | Year |
| Article Title | Authors | Vol Info | Year |