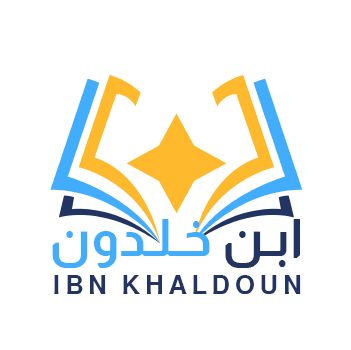2
7
2022
1682060055167_2309
https://drive.google.com/file/d/1hsnrCMOXnONBFCM1DxIWUQLeTOZnPvhj/view?usp=sharing
Forensic Linguistics and Phonetics
إعداد الباحثة: ابتسام بنت عبد الرحمن الرشودي: ماجستير لغويات تطبيقية من قسم اللغة والنحو والصرف، كلية اللغة العربية، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية.
Abstract:
The aim of this research is to identify the importance of criminal linguistics and phonetics, and the research included two sections, the first dealt with the definition of criminal linguistics and its fields, and the second reviewed the importance of criminal phonetics and its importance in criminal proof. The researcher used the descriptive approach and the research reached the results, the most important of which is that language is related to the humanities, and legal sciences, including (criminal) the closest human and social sciences to linguistics. And that forensic linguistics, it is intended to resort to language and use it as a means of proving or denying a charge. Forensic linguistics includes multiple fields, which help in the detection of some crimes, and help to deny or prove evidence. Forensic linguistics, like any other social discipline, has its own terminology and nature, and at the same time obligated it to the rest of the members of society, it must be understood by them, as its terms are outside the natural circle of the accepted concepts in the sciences of the mother tongue among the members of the same linguistic community. The forensic linguist must be familiar with the phenomena of linguistic studies, the features of language usage and its structures. Forensic phonetics is concerned with the phonemic aspects of speech that can be used as forensic evidence
Keywords: linguistics, forensic linguistics, forensic phonetics
المقدمة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، محمد النبي الأمين، صلاة وسلاماً دائمين إلى يوم الدين، وبعد:
إن الدراسات اللغوية تتقاطع مع الدراسات القضائية والقانونية في محاور عدة منها؛ دراسة المدونات القضائية، والدراسات المصطلحية، والدراسات الحجاجية، ودراسة أغراض الكلام التداولية، وغيرها. وقد حظيت اللسانيات القانونية باهتمام كبير في السنوات الأخيرة من قبل اللسانيين، واتسع مجال دراستها لتنفتح على تخصصات قانونية ومنها؛ اللسانيات الجنائية Forensic linguistics أو (علم اللغة الجنائي)، الذي هو فرع من فروع اللسانيات التطبيقية، ومجال خصب لتطبيق المعرفة اللسانية في وصف المشكلات القانونية التي تكون اللغة جزءا من أدلتها.
وتعرّف اللسانيات الجنائية بأنها: "العلم القائم على دراسة النصوص التحريرية والشفهية ذات الصلة بالجرائم والخلافات القانونية، أو المسائل المتعلقة بإجراءات التقاضي، أو ما يتعلق بلغة القانون، ومدى وضوحها، وكيفية إصلاحها، وإتاحتها لفهم الأشخاص العاديين والمتخصصين على السواء"(0).
وقد اكتسبت اللسانيات الجنائية أهمية كبرى في مجال الدوائر القانونية في بداية التسعينات من القرن الماضي، ونشأت بعض المراكز الأكاديمية المتخصصة في هذا المجال، حيث ظهرت الجمعية العالمية لعلم اللغة الجنائي، ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، International Association for Forensic and Legal Linguistics (IAFLL) وتضم في عضويتها اللسانيين والقانونيين، والجمعية العالمية لعلم الأصوات الجنائي، The International Association for Forensic Phonetics (IAFP) ومقرها المملكة المتحدة، وظهر إلى حيز الوجود بعض المجلات والدوريات المتخصصة(0).
مشكلة وأسئلة البحث:
تنطلق إشكالات هذا البحث من غياب الاعتماد الأمثل على اللغة باعتبارها دليلًا من أدلة الثبوت أو النفي في مجال القضاء وإجراءاته.
وفي هذا البحث أحاول الأجابة عن سؤال رئيسي واحد ويتفرع منه عدة أسئلة ثانوية، فسؤال البحث الرئيسي هو: ما اللسانيات والصوتيات الجنائية؟ وتتفرع منه عدة الأسئلة التالية:
-
ما هو مفهوم اللسانيات الجنائية؟
-
متى نشأ وما التطورات التي طرأت عليه؟
-
مافروعه ومجالاته؟
-
كيف يمكن الاستفادة منه في المجال القضائي والقانوني وفي مجال كشف الجريمة ومتابعة المجرمين؟
-
ما القيمة الإثباتية للبصمة الصوتية في الإثبات الجنائي؟
منهج البحث:
يعتمد البحث على المنهج الوصفي، وقد استخدمت هذه المادة العلمية لوصف وتعريف اللسانيات والصوتيات الجنائية.
أهمية البحث:
تتجلى أهمية هذا البحث بأنه إحدى الدراسات النادرة من نوعها في العالم العربي في مجال اللسانيات الجنائية، ويمثل نقطة التقاطع بين تطبيقات علم اللسانيات والقانون، وعلم الأدلة الجنائية في الإثبات الجنائية، وفض المنازعات القانونية التي تتضمن أدلة لغوية.
أهداف البحث:
يهدف هذا البحث إلى التعريف بعلم اللسانيات الجنائية بشكل عام ويناقش تطوره عبر الزمان، ومجالاته المختلفة في مجال الإثبات الجنائي وتحديد هوية المجرمين من خلال دراسة الشواهد والبينات اللغوية المسجلة أو المصاحبة لوقوع الجرائم، ويهدف لتعريف بالصوتيات الجنائية، والبصمة الصوتية بوصفها دليلًا من الأدلة لإثبات أو نفي التهمة عن المتهم.
المبحث الأول: اللسانيات الجنائية
تعريف مصطلح اللسانيات (Linguistics):
لغة: "اللِّسانُ: جارحة الكلام، واللسن بكسر اللام: اللغة. وحكى أبو عمرو: لكل قوم لسن أي لغة يتكلمون بها. وقوله- عزَّ وجل-: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ﴾ [إبراهيم: 4]؛ أَي بلغة قومه؛ واللِّسَانُ. الخبر أَو الرسالة. ومنه قول الشاعر: أَتَتْني لسانُ بني عامِرٍ وقد تقدَّم، ذهب بها إِلى الكلمة فأَنثها؛ وقال أَعشى باهلة: إِنِّي أَتاني لسانٌ لا أُسَرُّ به ذهب إِلى الخبر فذكره. وفي التنزيل العزيز: ﴿فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ﴾ [مريم: 97] ابن سيده: واللسان اللغة، مؤنثة لا غير." ويقال: هْوَ لِسانُ القَوْمِ: المُتَكَلِّمُ عنهم"(0).
اصطلاحًا: مصطلح اللسانيات علم حديث، وأول ما ظهر في ألمانيا (Linguistik، ثم استعمل في الدراسات اللغوية في فرنسا (Linguistique سنة 1826م، ثم في إنجلترا (Linguistics، سنة 1855م.
وفي الثقافة العربية المعاصرة ظهر مصطلح اللسانيات سنة 1966م، على يد عالم اللسانيات الجزائري عبد الرحمن الحاج صالح(0).
وتعرف اللسانيات بأنها: "الدراسة العلمية والموضوعية للسان البشري من خلال الألسنة الخاصة بكل مجتمع، فهي دراسة اللسان البشري، تتميز بالعلمية والموضوعية"(0).
أو هي الدراسة العلمية للغة الإنسانية، أو دراسة اللغة على نحو علمي، والمقصود بالعلمية: "دراسة اللغة وبحثها عن طريق الملاحظات المنظمة والتجريبية التي يمكن إثباتها بالاستناد إلى نظرية عامة ما لبنية اللغة"(0).
عرف دي سوسير اللسانيات أو علم اللغة بأن موضوع علم اللغة الوحيد والصحيح هو اللغة معتبرة في ذاتها، ومن أجل ذاتها. "ويقصد بهذا التعريف أن عالم اللغة يدرس اللغة كما هي، أو كما تظهر، فليس له أن يغير من طبيعتها، أو يدري جوانب دون جوانب أخرى، لأنه يستحسن هذا الجانب أو ذاك، وأنه يدرس اللغة بغرض الدراسة نفسها، ويدرسها دراسة موضوعية تسعى إلى الكشف عن حقيقتها" (0). فهو علم يبحث في اللغة من جميع جوانبها الصوتية، والصرفية، والمفرداتية، والدلالية، والنفسية والاجتماعية، والمعجمية، والتطبيقية (0).
تعريف مصطلح الجنايات (Felony):
لغةً: من الجذر جنى "جنَى الشَّخْصُ: أذنب، ارتكب جُرْمًا"(0)، ويقال: "جَنَى الذَّنْبَ عليه يَجْنِيهِ جِنَايَةً: جَرَّهُ إليه"(0).
والجناية: "الذنب والجرم وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه العقاب أو القصاص في الدنيا والآخرة"(0).
اصطلاحًا: الجناية في القانون: أنه لا جريمة ولا جزاء إلا بنص في القانون، فتحديد الأفعال التي تعد جرائم وبيان أركانها، وتحديد الجزاءات المقررة لها من حيث نوعها، كل ذلك يجب أن يرد صراحة في نص قانوني مكتوب يضعه المشرع سلفًا. فلا جريمة ولا عقوبة إذًا دون نص تشريعي صادر عن السلطة التشريعية، فدور العرف منعدم في القانون الجنائي سواء من حيث تجريم الأفعال، أو من حيث العقاب عليها.
وهذا المبدأ جاء ذكره في النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية، الصادر عام 1412هـ (المادة38) ونصها: "العقوبة شخصية، ولا جريمة، ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي"(0).
التعريف باللسانيات الجنائية قديمًا وحديثًا:
تعتبر اللسانيات الجنائية Forensic linguistics أو (علم اللغة الجنائي) من العلوم الحديثة، وتندرج تحت علم اللسانيات التطبيقي الذي عرفه عبده الراجحي بأنه: "ميدان تلتقي فيه علوم مختلفة حين تتصدى لمعالجة اللغة الإنسانية"(0). ومن هذا التعريف يتضح أن اللغة متعلقة بالعلوم الإنسانية، والعلوم القانونية ومنها (الجنائية) أقرب العلوم الإنسانية والاجتماعية باللسانيات، والدليل على ذلك أن القوانين تقوم على ضبط لغة الإنسان وسلوكه، فاللغة إما أن تكون دليلًا يستخدم أو تكون الجريمة بذاتها.
وقد اشتهر استخدام علم اللسانيات الجنائية، من قبل الغربيين في سنة 1968م عندما حلل جان سفارتفيك (Jan svartvik) أقوال تيموثي جون إيفانز (Timothy Jhon Evans) عن طريق عملية تنص مقابلة الشرطة مع المجرم حيث قتل زوجته وطفله(0).
وفي بداية الثمانيات من القرن الماضي، فإن دراسات روجر شُوي (Roger Shuy) وزملائه من علماء اللغة الأمريكيين، هي التي وضعت اللبنات الأساسية لعلم اللسانيات الجنائية، وقد عالجت الدراسات الكثير من المجالات الجنائية والنزاعات المدنية التي تكون اللغة فيها جزءاً من البينات المتاحة أو كلها.وفي منتصف التسعينات أنشأت بعض المراكز الأكاديمية المتخصصة في هذا المجال، حيث ظهرت الجمعية العالمية لعلم اللغة الجنائي، ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، International Association for Forensic and Legal Linguistics (IAFLL) وتضم في عضويتها اللسانيين والقانونيين، والجمعية العالمية لعلم الأصوات الجنائي، The International Association for Forensic Phonetics (IAFP) ومقرها المملكة المتحدة، وظهر إلى حيز الوجود بعض المجلات والدوريات المتخصصة (0).
وهذا العلم حاز على اعتراف الدوائر العدلية في كثير من البلدان المتقدمة مثل الولايات المتحدة وأستراليا، وألمانيا والنمسا والمجر والسويد، ففي تلك البلدان أنشئت المختبرات اللغوية الجنائية، ويقوم بالعمل فيها مجموعة من اللغويين المتدربين، لتقديم شهادتهم إلى المحاكم والدوائر القانونية، وذلك من خلال فحص البيانات الصوتية أو أي دلالة لغوية وتحليها لإثبات صحة نسبتها للمتهم أو نفيها عنه(0).
وللمجلة الدولية لعلم اللغة والخطاب The International Journal of Speech، وهي دورية علمية تصدر عن الجمعية الدولية، أن علم اللغة الجنائي يزداد يومًا بعد يوم ليواكب التطور المعرفي النظري في العلوم الإنسانية التي لها صلة بالأمن والعدالة الجنائية، وتعنى بمكافحة الجرائم بكل أشكالها (0).
وأما علماء المسلمين والعرب هم الأوائل ولهم السبق في هذا العلم، وخاصة علماء الحديث فهم أول من استخدم أساليب هذا العلم، وذلك في إثبات نسبة الأحاديث النبوية للرسول .
والإمام الطبري -رحمه الله- حيث استخدم نظريات علم الأسلوبية وبنفس الطريقة التي يستخدم بها اليوم في إثبات صحة تلك الأحاديث الشريفة(0).
اللسانيات الجنائية Forensic linguistics:
هو العلم الذي يعني بتطبيق نظريات علم اللغة على القضايا الجنائية من أجل المساعدة في نفي أو إثبات الأدلة.
وذكر الدكتور عبدالمجيد الطيب عمر عددًا من المصطلحات التعريفية لعلم اللسانيات الجنائية، وهي:
- تعريف أشر Asher (1994) بأن اللسانيات الجنائية (Forensic Linguistics) هي: "فرع من فروع علم اللغة التطبيقي، وهو علم يقوم على دراسة وتحليل وقياس البيّنات اللغوية المصاحبة لوقوع الجريمة بهدف تحديد هوية الجاني أو المتهم".
- تعريف كوبوسوف Koposov (2003) بأنه "العلم القائم على دراسة النصوص التحريرية والشفهية ذات الصلة بالجرائم والخلافات القانونية أو المسائل المتعلقة بإجراءات التقاضي أو ما يتعلق بلغة القانون ومدى وضوحها وكيفية إصلاحها وإتاحتها لفهم الأشخاص العاديين والمتخصصين على السواء".
- تعريف برينان Brennan (2001) أشار أن "هناك خلافًا في مفهوم هذا المصطلح في أوساط الباحثين في هذا المجال، فالبعض يحصره في استخدام تقنيات ونظريات علم اللغة للتحري في الجرائم التي تشكل البيّنات اللغوية فيها جزءًا من القرائن، أو كل القرائن والأدلة الجنائية أو المدنية الموجودة في مسرح الجريمة أو النزاع، أما البعض الآخر من الباحثين فيوسعون مفهوم هذا المصطلح ليشمل دراسة كل ما سبق إضافة إلى دراسة كل العلائق القائمة بين اللغة والقانون".
- وعرف كريستوفر هول وزميله al et Christopher, Hall بأن اللسان الجنائي هو من يدرس ويفّسر استخدام اللغة بدءا من مسح الجريمة أو الحدث أو الواقعة، ثم التحقيق في الشرطة، ثم المرافعات والمنازعات في المحكمة، ثم صدور الحكم مستخدما التحليل اللسان التطبيقي أو تحليل الخطاب الناقد(1).
ويتبين من خلال هذه التعريفات أن علم اللسانيات الجنائي، يقصد به الاحتكام إلى اللغة والاستعانة بها باعتبارها وسيلة من وسائل إثبات تهمة ما أو نفيها(2).
فأساس علم اللغة الجنائي ما هو إلا الإدراك الصحيح العلمي للنصوص والمواد اللغوية المتنوعة بما يخدم القانون، وتقديم الأدلة والبراهين في إثبات أو نفي الجريمة، وغالبًا ما يشمل دراسة أقوال الشهود وكلامهم، ومقارنة النصوص المكتوبة، وتحليل مضمون الخطابات المتنوعة، ودراسة لغة وكتاب المستندات المختلفة ومواجهة السرقة الفكرية التي غالبًا أساسها لغوي سواء كان مكتوبًا أو مقروءًا، ودراسة الأصوات والتسجيلات الصوتية(3).
مجالات اللسانيات الجنائية:
يشمل علم اللسانيات الجنائية مجالات متعددة، تساعد في الكشف عن بعض الجرائم، وتساعد في نفي أو إثبات الأدلة.
- إثبات هوية المتحدث (Speaker Identification):
التعرف على هوية الأشخاص عن طريق عينات من اللغة المسجلة المنطوقة (صوت) أكثر نجاحًا من اللغة المكتوبة؛ بسبب تمييز الصوت الإنساني، بينما المكتوب يعتمد على مفهوم لغة الشخص. وهو المجال الأكثر استخدامًا في هذا العلم، ويمكن التعرف على هوية المتحدث من خلال السمع العادي (Auditory Identification) وذلك عن طريق ما يعرف بطابور الشخصية الصوتي (Voice line-up)، ولا يحتاج الشخص سواء استخدام حاسة السمع فيمكن تمييز الشخص الآخر من خلال صوته دون أن يراه، وفي طابور الشخصية الصوتي يتم التعرف على الشخص المتهم، وذلك بعرض صوت المتهم مع أصوات تكون مشابهة له على شريط مسجل في شكل طابور، ومن ثم يطلب من الشاهد الاستماع لتلك الأصوات وتمييز صوت الجاني الذي ظن أنه يعرفه من خلال صوته. أو استخدام وسائل التحليل الصوتي التقني (Technical Speaker Identification)، ويتم التحقق من هوية شخص، وذلك بتحويل رنين صوته إلى ذبذبات مرئية بواسطة جهاز تحليل الصوت (Spectrograph) أو أجهزة ومعدات إلكترونية (0).
- تحقيق هوية المؤلف Author Identification:
التعرف على هوية الشخص من خلال نص معين كتبه، ويتم هذا بمقارنة نماذج وعينات من نصوص تكون معلومة صحة نسبتها للشخص المتهم مع النص الذي هو موضوع التساؤل. وعلى هذه الحال يحلل أسلوب النصين ومقارنتهما ومن ثم الوصول لقرار بشأن تطابق النصين.
وعند تحليل النص يعتمد على تقسيم النص ثلاثة أقسام رئيسة للصول على ثلاثة أنواع من الأدلة وهي:
- الأدلة الداخلية: وهذه تقوم على تحديد نقاط التشابه في سمات أسلوبية النصين.
- الأدلة الخارجة: وهذه تشمل معرفة تاريخ ومكان كتابة النص أو تحديد البريد التي أرسل منها وبصمة الحامض النووي للمؤلف (DNA).
- إعطاء وجهة نظر عالم اللغة الجنائي عن مدى احتمال نسبة النص موضوع التساؤل للمتهم.
وفي هذه القضية مثالًا على ذلك: جريمة اختطاف ليدبورغ (1932م)، تم إثبات هوية الخاطف برونو ريشتارد (Bruno Richard)، تم الاختطاف من سرير الأطفال في منزل ليندبيرغ، وبعد اثنين وسبعين يومًا وجد سائق الشاحنة جثة الطفل بجانب الطفل، وقد أرسل الخاطف رسالة طلب فدية من الأسرة، وبعد مرور من ازمان اكتشفت الشرطة المشتبه به في هذه القضية برونو ريتشارد، ولكنه أعلن برأته حتى النفس الأخير من حياته. وثبتت الشرطة إدانته بمقارنة خطه اليدوي مع نص الرسالة التي طلب فيها الفدية، فتم إثبات هوية الخاطف وذلك عن طريق تحليل النصوص المكتوبة.
فتحقيق هوية المؤلف يمثل مجالًا مهمًا يحاول من خلاله علم اللسانيات الجنائي تحديد هوية الشخص الذي كتب نصًا معينًا(0).
- تحليل الخطاب Discourse Analysis:
التعرف على هوية الشخص من خلال تحليل الخطاب أو الحوار، بالاعتماد على الإجابة عن مجموعة أسئلة افتراضية مثل: "من هو الشخص الذي ابتدر الحوار؟ وهل كان المتهم موافقًا على المشاركة في ارتكاب جريمة ما؟ أم هل كان مرغمًا على القيام بعمل إجرامي ما".
فتحليل الخطاب أمر مهم ويفيد في التعرف على الحقيقة، ودور عالم اللسانيات الجنائية النظر والإلمام في بعض ملامح استخدامات اللغة وتراكيبها وما يترتب عليها من مقاصد ومعان محددة. فليس من الضروري أن تكون لفظة (نعم) دالة على الموافقة، فقد تُلفظ ويراد بها الطلب من المتكلم الاستطراد في الحديث وليس الموافقة على المشاركة في جريمة ما.
- علم اللهجات Dialectology:
التعرف على هوية الشخص من خلال تحليل لهجته، فمعرفة اللهجات من المجالات المهمة في علم اللسانيات الجنائي، فيمكن "إثبات أو نفي صحة حديث مسجل لمتهم وذلك بناء على سمات لهجته". حيث إن لكل لهجة لونًا نطقيًّا وتكون متداخلة السمات من صوتي وصرفي وتركيبي ودلالي، وذكر إبراهيم أنيس تعريف اللهجة: "هي مجموعة من الصفات اللغوية تنتمي إلى بيئة خاصة، ويشترك في هذه الصفات جميع أفراد هذه البيئة، وبيئة اللهجة هي جزء من بيئة أوسع وأشمل تضم عدة لهجات، لكل منها خصائصها، ولكنها تشترك جميعاً في مجموعة من الظواهر اللغوية...". فتحليل اللهجة يقوم بتحليل أداء بعض العبارات والألفاظ أو المفردات المستخدمة في النص والأداء الصوتي لها. وفي هذه القضية مثالًا على ذلك: جريمة قتل جري نيكول، أدين ديفيد هودجسون بقتل جيني نيكول، وحلل اللغويون الأسلوب في الرسائل النصية التي يتم تلقيها من هاتفها بعد الإبلاغ عن فقدها، فوجدوا أن النمط الثاني كان مشابهًا لأسلوب ديفيد هودجسون فبرهنا علماء اللغة لإدانة هودجسون على أن استخدام جيني لكلمة "أنا (me)" و"أنا (myself)" أثناء كتابة "أنا" والكلمات المتعلقة بـ "أنا"، وما كان استخدام هودجسون لكلمة "أنا (me)"و" أنا (myself)"، تم تحديدها على أنها لهجة يوركشاير. فمن خلال تحليل اللهجة تم إثبات التهمة على الجاني(0).
- تحليل اللغة الأصلية للمتحدث
Linguistics Analysis for Determination of Origin (LADO):
نظرًا لتحديد هوية اللاجئين وأصولهم وجنسياتهم، يقوم عالم اللسانيات الجنائية بتحليل اللغة الأصلية ومعرفة لغة الأم للمتحدث، وينبني على هذا التحليل مبادئ اكتساب اللغة ونظرياته(0).
فطريقة كلام الشخص تكشف -إلى حد كبير- هويته ومكان ولدته ونشأته، مثالًا على ذلك: "فربما يستغل لجئ من أرض مجاورة للعراق -إيران مثلًا- الوضع الإنسان في العراق ويقوم بادعاء أنه عراقي للحصول على اللجوء الذي يحصل عليه العراقي وللتمتع بالميزات التي يتمتع بها العراقي، وقد يقوم ذلك لأغراض تجسسية لصالح إيران مثل في الدول التي تؤوي اللاجئين والمهاجرين أو لهدف شخصي" (0).
- لغة القانون Legal Language:
اللغة القانونية "تلك التي تكتب بها القواعد القانونية، ويتحدث بها أساتذة القانون."(0) وهي غير مفهومة عند أفراد المجتمع العامية، "وقد أكد جيمار Gémar,Jean-Claude على أن القانون يمتلك لغة متخصصة، تتوفر على مفردات ونحو ودلالة وأسلوب، يميزها عن غيرها من لغات التخصص الأخرى".(0) تستخدم صيغة المبني للمجهول للتركيز على الفعل، وتستعمل الجمل الطويلة المركبة، خاصة منها الشرطية والاستثنائية.
فتعلم لغة القانون أمر مهم لعالم اللسانيات الجنائية، فاللغة نصف العمل القانوني، والتطبيق السليم للقانون لا يتم إلا بنصوص واضحة ودقيقة، بعد الاهتمام بالصياغة السليمة للنصوص القانونية، التي تعد أساس القاعدة القانونية. فتبديل حركة في حرف قد يبدل الحكم من حقٍّ إلى باطل، وبالعكس، فهناك فرق بين قول القائل: أنا قاتل غلامَك، وبين القائل: أنا قاتل غلامِك؛ فالأول لم يفعل وبالتالي لا يؤاخذ بها لأنها لم تحدث، والثاني فعل الجرم، وبالتالي يؤاخذ عليه(0).
- تحليل المصداقية اللغوية Linguistic Veracity Analysis:
تعتبر دراسة المصداقية اللغوية من الدراسات المثيرة للجدل في علم اللسانيات الجنائية، إذ تشمل مجموعة من طرق التحليل اللغوي التي تهدف إلى تحديد صدق المتحدث أو كذبه، فمن خلال تحليل إفادات المتهم لغويًا، صدق المتحدث من كذبه، فينظر إلى متن الحديث يبحث عن أي تناقضات أو عبارات معينة تدل على أن المتهم يخفي شيئًا، فكثرة القسم والتعابير المبهمة وغيرها من الأساليب، إشارات تدل على كذب المتحدث أو عدم مصداقيته.
إلا أن هذه الطريقة في التعرف على المتهم لا تقوم على ثوابت علمية أو أساليب منهجية محددة، بل تقوم كذلك على الحدس والأحكام الذاتية والانطباعات الشخصية، فمن الصعب الاعتماد عليه بصور كلية في إصدار الأحكام القانونية التي تقرر صدق المتهم أو كذبه من خلال أقواله وإفاداته.(0)
مهام عالم اللغة الجنائي:
وعلى عالم اللغة الجنائي أن يلم في ظواهر الدراسات اللغوية، وملامح استخدامات اللغة وتراكيبها، فمن صفات المحقق الجنائي، سواء كان عالم في اللغة أو غيرها، لابد أن تتكون لغته سليمة، وسلامة أسلوبه فيما يكتبه ويدونه، ويكون خطه واضحًا، وتوقي اللحن والخطأ في الإملاء(0).
وقد طرح عبد المجيد الطيب عمر في دراسته المميزة سؤالا وجيها وأجاب عنه.
في أي مرحلة من الإجراءات القانونية يستدعى عالم اللغة الجنائي للإدلاء بشهادته؟
وللإجابة عن هذا السؤال فإنه ينظر إلى الإجراءات القانونية على أنها تتكون من ثلاث مراحل:
-
مرحلة جمع المعلومات والتحريات.
-
مرحلة المحاكمة.
-
مرحلة الاستئناف.
فقد يستدعى عالم اللغة الجنائي للإدلاء بشهادته في مرحلة التحري بعد فحص البيانات الموجودة في تلك المرحلة إن كانت تحتوي على بينات لغوية، وقد يكتفي بذلك، وقد يستدعى في مرحلة المحاكمة جون مرحلة التحري، وقد يستدعى في مرحلة استئناف الحكم دون غيرها إذا ظهرت معلومات وبينات لغوية لم تكن متاحة في المرحلتين السابقتين، وقد يستدعى اللغوي للنظر في بعض القضايا حتى قبل مرحلة التحري، وقبل أن تكون المسالة موضوعًا لنزاع قانوني لتقديم وجهة نظره في المتخاصمين(0).
خصائص السياق اللساني الجنائي:
إن اللسانيات الجنائية مثلها مثل إي تخصص اجتماعي آخر، لها مصطلحاتها ولها طبيعتها وفي نفس الوقت أدى إلزامها لبقية أفراد المجتمع فلابد أن تكون مفهومة لهم، فمصطلحاتها خارج الحلقة الطبيعية لدائرة المفاهيم المتعارف عليها في علوم اللغة الأم بين أفراد نفس المجتمع اللغوي. وذكر العصيمي أن "سولان وتيرسما Tiersma & Solan)) يشير إلى أن القوانين كتبت لأجل أن تطاع وينصاع لها ... ويعني ذلك أن تكون مفهومة ومحددة وممكنة"(0) وعلى ذلك فإن اللسانيات الجنائية لها خصائص، ومن هذه الخصائص ما يلي:
-
الدقة في صياغة الألفاظ ومسألة التعبير عن المفاهيم بكيفية واضحة، والابتعاد عن الغموض والحشو واستخدام المجاز والبديعيات، فهي تختلف عن اللغة الأدبية التي من طبيعتها الغموض والإسهاب وغيره، ويقصد بالدقة" استخدام الألفاظ حسب معناها الصحيح، وفي موضعها الصحيح"(0).
-
الوضوح والبساطة في الألفاظ واختيار الألفاظ التي تكون مألوفة، بحيث تعبر عن العبارات بسهولة ويسر، ويستطيع السامع والقارئ أن يفهم حقيقة المراد من الخطاب سواء كان شفهيًا أو تحريريًا، والابتعاد عن الألفاظ الغريبة والمعقدة.
-
الايجاز والاختزال ويكون التعبير تعبيرًا موجزًا ودقيقًا، وعدم الإطالة؛ لأن الغاية منه هو المعنى والسياق لا الغاية الجمالية في التعبير.
وتكتسب هذه الخصائص أهمية كبيرة في القانون الجنائي، وذلك لأن هذا القانون يسوده مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات الذي يوجب أن تتصف نصوص التجريم بالوضوح وأن تبعد عن الغموض والالتباس، فلا يكفي أن ينص الشارع على تجريم فعل معين؛ وإنما عليه أن يوضح عناصر هذا الفعل ويكون دقيق وواضح(0).
المبحث الثاني: الصوتيات الجنائية
يعرف الصوت بأنه: ظاهرة فيزيائية تصدر عن الإنسان في مناسبات شتى عن طريق جهاز النطق؛ إذ يكتسب الكلام لدى الإنسان خواص ذاتية تنطوي على مميزات فردية (0). ويتركز اهتمام الصوتيات الجنائية على الجوانب الصوتية للكلام التي يمكن أن تستخدم كدليل جنائي.
فإن علماء الصوتيات الجنائيين يمكن أن يساعدوا قوات الشرطة في عملية تفريغ التسجيلات الصوتية المتنازع عليها وتفسيرها. كما يمكنهم تقديم المشورة في تصميم ما يسمى بمجموعة الاستعراض الصوتي، أو طابور العرض الصوتي للتعرف على المشتبه بهم وهو المصطلح المرادف لطابور الشخصية، حيث يتم إسماع الشاهد أو الضحية تسجيلات صوتية لعدد من المشتبه بهم، وأصوات أخرى مماثلة لهم، ويطلب منهم التعرف على صاحب الصوت المطلوب(0).
ويستند الباحثون في مجال التعرف على المتحدث على أساسين متينين، فالأساس الأول أن يكون كل إنسان مر بطفولة فريدة وبذلك تكون لديه عقلية أو نفسية فريدة ومن ثم فإن لكل إنسان طريقة فريدة في الكلام نتيجة للإصدار الفريد لكل دماغ للإشارات الكهربائية من الدماغ إلى الجهاز الصوتي وبهذا يكون هذه الإشارات مختلف من إنسان إلى آخر. والأساس الآخر أن لكل إنسان جهازا صوتيا فريدا بحيث لا يتطابق جهازان تطابقًا تامًا.
ولتحديد سمات المتحدث في القضايا الجنائية يعمل علماء الصوتيات باجتهاد لاستخلاص أكبر قدر ممكن من المعلومات عن المتحدث من خلال عينة/عينات الكلام المتاحة لهم، وذلك باستخدام خبراتهم في علم الصوتيات والبرامج الإلكترونية المتخصصة. تتراوح سمات المتحدث التي يمكن لعلماء الصوتيات الجنائيين تحديدها ما بين السمات البيولوجية مثل: العمر، والجنس، وبين العوامل الاجتماعية والثقافية مثل: العرقية/ والمنطقة الجغرافية، واللغة الأولى. قد تكون بعض هذه السمات أكثر وضوحا وموثوقية في تحديدها من البعض الآخر(0).
مراحل عملية تحليل الصوت البشري للكشف عن هويته أو بصمته الصوتية، تمر عملية تحليل الصوت البشري للكشف عن هويته ومطابقة البصمة الصوتية في مرحلتين: مرحلة الاستخراج، ومرحلة المقارنة، وتتضمن المرحلة الأولى تحديد سمات الصوت التي سيعتمد عليها التحليل؛ وهي في الغالب سمات لها علاقة بمقدار ذبذبة الصوت المعني، ومستوى التردد الأساسي له، حيث تؤخذ المقاييس الخاصة بهذه السمات الصوتية لكل حرف صوتي يرد في كل كلمة في العينة الملتقطة، فمثًلا لو كانت كلمة باب bab، بين الكلمات التي ستخضع للتحليل تؤخذ الذبذبات الأساسية ومقاييس بقية السمات لكل صوت من أصوات هذه الكلمة الثلاثة: b)) (a(b أما مرحلة المقارنة فتجري فيها مقارنة المعلومات التي تم التوصل إليها من المرحلة الأولى مع المعلومات عن الأصوات المخزنة لمشبوهين في المجتمع، حيث تجري مطابقتها مع واجد منهم باستخدام الاختبار المغلق(0) أو رما لا تكون هناك أية أصوات مطابقة لعينة الفحص كما في حالة الاختبار المفتوح(0).
الطرق المتبعة في تحليل ومقارنة الأصوات، هناك طريقتان رئيستان يتبعهما علماء الصوتيات الجنائية في تحليل ومقارنة عينات الكلام وهما: "الطريقة السماعية" و" الطريقة التقنية" في الطريقة السماعية يقوم علماء الصوتيات بالاستماع إلى العينات الكلامية، ومن ثم إصدار تمثيل صوتي (كتابة الصوت وليس الحرف) باستخدام الابجدية الصوتية الدولية IPA. وبذلك يمكنهم أن يحددوا الخصائص الصوتية التي تبدو متسقة في صوت الجاني، مثل كيفية نطق الأصوات المتحركة والساكنة، وعمليات الكلام المتصل، ويأخذون كذلك الخصائص الصوتية الأخرى مثل التنغيم، ونبرة الصوت، والإيقاع، ونوعية الصوت. وأما الطريقة التقنية، الذي ينطوي التحليل الصوتي فيها على استخدام برامج حاسوبية متخصصة لتحديد وقياس عناصر الكلام. وأحد أهم المعالم الصوتية تالتي يتم تحليلها غالبا باستخدام الأساليب التقنية هو حدة الصوت(0).
البصمة الصوتية وأثرها في الاثبات الجنائي؛ تسند بصمة الصوت باعتبارها دليلًا جنائيًا على أساس نظرية التفريد الجنائي كما هو الحال في بصمة الأصابع فمن المعلوم أن لكل صوت خصائص فردية، كما أم وجود شخصين يتمتعان بنفس المقدرة والأسلوب في النطق عن طريق تحريك اللسان والشفاه واللهاة يعد أمرًا متعذر الحدوث، وبذلك يقول كيرسا: إن احتمال أن يكون لشخصين الاستعمال الديناميكي ذاته لأنماط اللفظ: الشفتان، والأسنان وغيرها لتمييز الأصوات المختلفة للكلام هي فرصة بعيدة واحتمال أن يكون لشخصين بعد التجويف الصوتي ذاته وأنماط استعمال عناصر اللفظ ذاتها بشكل يجعل هذا البعد وهذا الأنماط متطابقة بما فيه الكفاية لرفض أساليب مطابقة سمات الصوت(0).
الخاتمة
هدفت في هذا البحث إلى التعريف باللسانيات الجنائية، وايضاح دورها المهم واعتبارها إحدى أهم الوسائل لإثبات هوية الجاني أو نفي والتبرئة عن بعض المتهمين، وذلك من خلال التحليل العلمي للأدلة الجنائية التي يمكن أن توجد أو تسجل في مسرح جريمة ما، وتم استعراض مفهومها ونشأتها، وذكر مجالاتها، وذكر الخصائص السياقية للغة الجنائية وجعلها في متناول أفهام عامة الناس وخاصتهم.
وقد تعرضت إلى علم الأصوات الجنائي، والبصمة الصوتية وأثرها في إثبات الأدلة الجنائية، وأن علم الأصوات الجنائي رافد أساسي من روافد هذا العلم.
أهم النتائج:
-
أن اللغة متعلقة بالعلوم الإنسانية، والعلوم القانونية ومنها (الجنائية) أقرب العلوم الإنسانية والاجتماعية باللسانيات.
-
أن علم اللسانيات الجنائي، يقصد به الاحتكام إلى اللغة والاستعانة بها باعتبارها وسيلة من وسائل إثبات تهمة ما أو نفيه.
-
يشمل علم اللسانيات الجنائية مجالات متعددة، تساعد في الكشف عن بعض الجرائم، وتساعد في نفي أو إثبات الأدلة.
-
أن اللسانيات الجنائية مثلها مثل إي تخصص اجتماعي آخر، لها مصطلحاتها ولها طبيعتها وفي نفس الوقت أدى إلزامها لبقية أفراد المجتمع فلابد أن تكون مفهومة لهم، فمصطلحاتها خارج الحلقة الطبيعية لدائرة المفاهيم المتعارف عليها في علوم اللغة الأم بين أفراد نفس المجتمع اللغوي.
-
وعلى عالم اللغة الجنائي أن يلم في ظواهر الدراسات اللغوية، وملامح استخدامات اللغة وتراكيبها
-
ويتركز اهتمام الصوتيات الجنائية على الجوانب الصوتية للكلام التي يمكن أن تستخدم كدليل جنائي.
المصادر والمراجع
-
أشرف توفيق شمس الدين، أصول اللغة القضائية، المجلة القانونية والقضائية، 2013م.
-
عادل عيسى الطويسي، بصمة الصوت سماتها واستخداماتها، المجلة العربية للدراسات الأمنية، مج11، عدد22، 1996م.
-
عمر عبد المجيد مصبح، بصمة الصوت وأثرها في الإثبات الجنائي، مجلة البحوث الأمنية، مج21، ع52، 2012م.
-
عبدالله بن محمد آل خنين، التحقيق في الجريمة إجراءاته وتوصيف وقائعه وتسبيب قراره، دار الحضارة للنشر والتوزيع، ط1، 1442هـ-2021م.
-
حلمي خليل، دراسات في اللسانيات التطبيقية، دار المعرفة الجامعية، 2003م.
-
عبده الراجحي، علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية، دار المعرفة الجامعية،1995م.
-
عبد المجيد الطيب عمر، علم اللغة الجنائي: نشأته وتطوره وتطبيقاته، المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب، المجلد 23، العدد 45، 1429هـ -2008م.
-
حمدي سلطان حسن أحمد العدوي، علم اللغة القضائي قراءة في تراثنا العربي والبناء عليه، ط1، مكتبة زهراء الشرق،2021م.
-
معقد بن قعيد العتيبي، علم اللغة القضائي، مجلة البحوث الأمنية، العدد71، 2018م.
-
دزجون اولسون ترجمة: محمد بن ناصر الحقباني، علم اللغة القضائي، مقدمة في اللغة والجريمة والقانون، النشر العلمي والمطابع، 1429هـ.
-
الفيروز آبادي، القاموس المحيط.
-
ابن منظور، لسان العرب، ج13.
-
صالح فهد العصيمي، اللسانيات الجنائية، تعريفها، ومجالاتها، وتطبيقاتها، مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي، 1441هـ -2020م.
-
زغدودة ذياب مروش، اللغة العربية في الحقل القانوني، جامعة الحاج لخضر باتنه الجزائر.
-
أدريس حسوني، اللغة القانونية وخصائصها، مجلة البوغاز للدراسات القانونية والقضائية، ع8، 2020م.
-
مباحث في اللسانيات، أحمد حساني، ط2، منشورات كلية الدراسات الإسلامية والعربية، دبي الكرامة،1434هـ-2013م.
-
إيمان بنت محمد عزام، مبدأ الشرعية في القانون الجنائي وعلاقته بنظام العقوبات في الإسلام، بحث علمي محكم، مجلة القضاء، ع:5.
-
عبد الهادي عبدالرحيم وآخرون، مساهمة علم اللغة الجنائي في قبض المجرمين، بحث محكم، المجلة العربية للآداب والدراسات الإنسانية، مج:5، ع20، 2021م.
-
عبد الله بن سعد الرشيد، المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي، دار التحبير، ط1، 1441هـ- 2020م.
-
المعاني الجامع، http://www.almaany.com/.
-
محمد التونجي وراجي الأسمر، المعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنيّات)، دار الكتب العلمية، ط1، 1421هـ -2001م.
-
المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة.
-
عاطف فضل محمد، مقدمة في اللسانيات، دار المسيرة للنشر والتوزيع، ط2، 1437هـ -2016م.
-
مالكولم كولتهارد، أليسون جونسون، ديفيد ريغ، ترجمة عبدالرحمن بن عبد العزيز القرشي، مقدمة في علم اللغة الجنائي اللغة في علم الأدلة، مركز النشر العلمي جامعة الملك عبد العزيز، ط:1، 1441هـ -2019م.
-
'Suicidal ideations and attempts in juvenile delinquents', Journal of Child Psychology and Psychiatry · November 2003, pp 1058–1066.
0(( 'Suicidal ideations and attempts in juvenile delinquents', Journal of Child Psychology and Psychiatry · November 2003, pp 1058–1066.
0() علم اللغة الجنائي: نشأته وتطوره وتطبيقاته، عبد المجيد الطيب عمر، المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب، المجلد 23، العدد 45، ص274
0() لسان العرب، ابن منظور، ج13، ص386. والمعجم الوسيط، والقاموس المحيط،
0() انظر: مباحث في اللسانيات، أحمد حساني، ط2، 1434هـ- 2013م، منشورات كلية الدراسات الإسلامية والعربية، دبي الكرامة، ص23.
0() مباحث في اللسانيات، أحمد حساني، ص24.
0() مقدمة في اللسانيات، عاطف فضل محمد، دار المسيرة للنشر والتوزيع، ط2، 1437هـ -2016م، ص62-63.
0() دراسات في اللسانيات التطبيقية، حلمي خليل، دار المعرفة الجامعية، 2003م، ص19.
0() المعجم المفصل في علوم اللغة (الألسنيّات)، محمد التونجي وراجي الأسمر، دار الكتب العلمية، ط1، 1421هـ -2001م، ج:1، ص427.
0() معجم المعاني الجامع. معجم إلكتروني http://www.almaany.com/
0() القاموس المحيط، الفيروز آبادي.
0() المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي، عبد الله بن سعد الرشيد، دار التحبير، ط1، 1441هـ- 2020م، ص35.
0() مبدأ الشرعية في القانون الجنائي وعلاقته بنظام العقوبات في الإسلام، إيمان بنت محمد عزام، بحث علمي محكم، مجلة القضاء، ع:5، ص21.
0() علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية، عبده الراجحي، دار المعرفة الجامعية،1995م، ص12.
0() علم اللغة القضائي، مقدمة في اللغة والجريمة والقانون، تأليف:دزجون اولسون ترجمة: محمد بن ناصر الحقباني، النشر العلمي والمطابع، 1429هـ.
0() علم اللغة الجنائي: نشأته وتطوره وتطبيقاته، عبد المجيد الطيب عمر، المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب، المجلد 23، العدد 45، ص278-279.
0() المرجع السابق، ص279.
0() انظر: علم اللغة القضائي، معقد بن قعيد العتيبي، بحث في مجلة البحوث الأمنية العدد71، 2018، ص221.
0() علم اللغة الجنائي: نشأته وتطوره وتطبيقاته، عبد المجيد الطيب عمر، المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب، المجلد 23، العدد 45، ص276.
0() ينظر: علم اللغة القضائي، الحقباني، وعلم اللغة الجنائي: نشأته وتطوره وتطبيقاته، عبد المجيد الطيب عمر، ص276.
0() ينظر: علم اللغة الجنائي: نشأته وتطوره وتطبيقاته، عبد المجيد الطيب عمر، ص276، ومساهمة علم اللغة الجنائي في قبض المجرمين، عبد الهادي عبدالرحيم وآخرون، بحث محكم، المجلة العربية للآداب والدراسات الإنسانية، مج:5، ع20، 2021م.
0() ينظر: علم اللغة الجنائي: نشأته وتطوره وتطبيقاته، عبد المجيد الطيب عمر، ص276. ومساهمة علم اللغة الجنائي في قبض المجرمين، عبد الهادي عبدالرحيم وآخرون.
0() ينظر: علم اللغة الجنائي: نشأته وتطوره وتطبيقاته،عبد المجيد الطيب عمر، ص276. واللسانيات الجنائية، العصيمي، ص84.
0() اللسانيات الجنائية، العصيمي ص85.
0() اللغة القانونية وخصائصها، أدريس حسوني، مجلة البوغاز للدراسات القانونية والقضائية، ع8، 2020م، ص121.
0() اللغة العربية في الحقل القانوني، زغدودة ذياب مروش، جامعة الحاج لخضر باتنه لجزائر، ص3.
0() اللغة العربية في الحقل القانوني، زغدودة ذياب مروش، جامعة الحاج لخضر باتنه لجزائر، ص3.
0() علم اللغة الجنائي: نشأته وتطوره وتطبيقاته، عبد المجيد الطيب عمر، ص293.
0() التحقيق في الجريمة إجراءاته وتوصيف وقائعه وتسبيب قراره، عبدالله بن محمد آل خنين، دار الحضارة للنشر والتوزيع، ط1، 1442هـ-2-21م، ص209.
0() علم اللغة الجنائي، عبد المجيد الطيب عمر، ص280.
0() اللسانيات الجنائية، العصيمي، ص89
0() اللغة القانونية وخصائصها، أدريس حسوني، ص124.
0() أصول اللغة القضائية، أشرف توفيق شمس الدين، المجلة القانونية والقضائية، 2013م، ص58
0() بصمة الصوت وأثرها في الإثبات الجنائي، عمر عبد المجيد مصبح، مجلة البحوث الأمنية، مج21، ع52، 2012م، ص22.
0() مقدمة في علم اللغة الجنائي اللغة في علم الأدلة، مالكولم كولتهارد، أليسون جونسون، ديفيد ريغ،ترجمة عبدالرحمن بن عبد العزيز القرشي، مركز النشر العلمي جامعة الملك عبد العزيز، ط:1، 1441هـ -2019م ص181-182.
0() المرجع السابق، ص190-191.
0() الاختبار المغلق يكون للشخص الخاضع للتعرف بصمة صوتية ضمن البصمات المخزنة المراد إجراء المقارنة معها، بينما يمكن أن تكون أو لا تكون بصمة هذا الشخص بين البصمات المخزنة في حالة "الاختبار المفتوح" وعليه يمكن أن يقع الخطر من نوع واحد في حالة الاختبار المغلق، وهو خطأ التعرف الخاطئ، في حين يتعرض الاختبار المفتوح إلى خطأ آخر(إضافة إلى خطأ التعرف الخاطئ) يتجلى في عدم مطابقة البصمة مع أي من البصمات الصوتية المخزنة في الوقت الذي قد تكون فيه تلك البصمة واحدة من البصمات المخزنة.
0() بصمة الصوت سماتها واستخداماتها، عادل عيسى الطويسي، المجلة العربية للدراسات الأمنية، مج11، عدد22، 1996م، ص86.
0() مقدمة في علم اللغة الجنائي اللغة في علم الأدلة، مالكولم كولتهارد، أليسون جونسون، ديفيد ريغ، ترجمة عبدالرحمن بن عبد العزيز القرشي، ص194-198.
0() بصمة الصوت وأثرها في الإثبات الجنائي، عمر عبد المجيد مصبح، مجلة البحوث الأمنية، مج21، ع52، 2012م، ص23.
Ibtisam Abdulrahman Al-Rashudi || Forensic Linguistics and Phonetics || Ibn Khaldoun Journal for Studies and Researches || Volume 2 || Issue 7 || Pages 202 - 222.
0
-
| Article Title | Authors | Vol Info | Year |
| Article Title | Authors | Vol Info | Year |