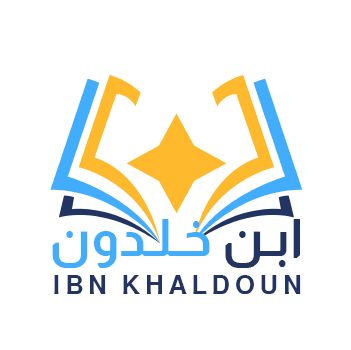2
7
2022
1682060055167_2310
https://drive.google.com/file/d/1piFJxm8MG3SEY7Uo6AyqeMYcoeL9aQ9_/view?usp=sharing
The rhetorical style in the rule of Nahj al-Balaghah: an objective study
م. م جودت كاظم خضر الحسناوي: مدرس مساعد في جامعة الإمام جعفر الصادق 'ع' الأهلية، فرع ذي قار، العراق
Email:jawdat. kadhim@sadiq.edu.iq
Abstract:
Literary discourse is based on two basic elements، namely: (sound and meaning)، as one is inseparable from the other، and by noticing the interrelationship between these two elements، we feel that this art whose realization depends on confrontation and verbal communication، as the recitation significantly affects the recipient. ، balancing how the recipient is with writing، so the size of the emotional and emotional impact، focus and mental tension when listening to a specific sermon is greater for the recipient than it is when reading certain lines. Therefore، the speaker's creativity is achieved in speaking a sermon، and this in itself is a memorization of the semantic and intellectual depth، and the artistic use of audio tools، and the truest representation of what has been presented is listening to poetry and prose. The subject of our research is the rhetorical style of the knight of rhetoric and its origin، in which he gathered what he did not meet in others، until his style of honesty reached a level with which he was lifted from the arrogant courage.
Keywords: style، rhetoric، Imam Ali (peace be upon him)، judgment، Nahj al-Balaghah
المقدمة:
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه المنتجبين.
أما بعد، فهو كتاب نفيس، يشتمل على ألفاظ تهذّب المتكلّم، وتدرّب المتعلم، فيه ما هو حسن من الألفاظ، ورصين من المعاني، وقعه أحلى من نغم القِيان، وجماله أبهى من نِعَم الجنان، مطلع الكلام فيه كهيئة البدر، وسطوره مورد اكتساب أهل القدر، فيه من الكلمات الّتي وشيها حَبر، ومعانٍ ذات فقر، ومقاطع الخطب فيه غُرر، ومبادئها دُرر، (استعاراتها تحكي غمزات الألحاظ المِراض، ومواعظها تعبّر عن زهرات الرياض، جمع قائل هذا الكلام بين ترصيع بديع، وتجنيس أنيس، وتطبيق أنيق، فللّه دَرّ خاطر عن مَخايل الرشد ماطر، وعين الله إذا انهلّت فيه عزالي الأنواء أنْ يخضر رُبَاه، ويفوح رياه، ولا للساري في مسالك نهج البلاغة أنْ يُحمد عند الصباح سُراه، ولا لمجيل قِداح الطهارة إذا صدَقهُ رائد التوفيق والإلهام أنْ يفوز بقدحي المعلّى والرقيب، ويمتطي غوارب كل حظ ونصيب)(1). وبرهن على أنّ كثيراً من فصوله (نهج البلاغة) داخل في باب المعجزات المحمدية؛ لاشتمالها على الأخبار الغيبية، وخروجها عن وسع الطبيعة البشرية، وبين من مقامات العارفين التي يرمز إليها في كلامه ما لا يعقله إلاّ العالِمون، ولا يدركه إلاّ الروحانيّون المقرّبون(2).
من هنا فقد جاء البحث في (الأسلوب الخطابي في حِكَم نهج البلاغة _ دراسة موضوعيّة) بواقع مبحثين، كان المبحث الأول منهما على مطلبين، يتطرّق الأول منهما لبيان المعنى اللغوي والاصطلاحي للخطابة من جهة، وللأسلوب الخطابي من جهة أُخرى، وأما المطلب الثاني فقد عنى بالجانب الفنّي في حِكَمِه (ع)، فقد أشرنا إلى بلاغة الأداء وقوّة التأثير، وسحر الأداء، وموافقة الأسلوب لمقتضى الحال. ثم المبحث الثاني، فقد تناول التجليّات الشخصية لأمير الفصاحة والبلاغة (ع)، حيث جاء في موضوعاته بيان شيء من ذاته (ع)، والجانب السياسي والتاريخي والنفسي، ومدى تأثير هذه الأدوار في الأسلوب الخطابي عنده (ع)، بالإضافة إلى إيراد بعض من خُطبِه من أجل الوقوف على مواطن السجع غي المتكلّف، والبديع الّذي انقطع نظيره عند المتكلّمين وأرباب الكلمة، وجميل الوصف، والأداء الساحر، والشكوى والعتاب، وتربية النفس وتهذيبها وترويضها. ثم جاءت في النهاية قائمة بالمصادر والمراجع الّتي استُقِيَ منها في البحث، وهذا جهد المُقِل، وبضاعة الفقير إلى عفو ربّه، فما كان فيه من توفيق فمن الله وحده (وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ)(هود: 88). وما كان فيه من خطأ أو زلل أو نسيان فمنّي ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، ورحم الله رجلاً أهدى إليّ عيوبي.
المبحث الأول: المفاهيم الأساسية
المطلب الأول: التعريف بالخطابة
الخطابة في اللغة: خَطَبَ الناسَ وفيهم وعليهم خَطَابةً وخُطْبةً: ألقى عليهم خُطْبة. وخَطَب فلانةً خَطْبًا وخِطْبَة، طلبها للزواج. وخَطُب خَطابة: صار خطيبًا. وخاطبه مخاطبة وخِطابا، كالمه وحادثة، أو وجّه إليه كلاما. والخِطاب: الكلام، وفَصْل الخِطَاب هو خطاب لا يكون فيه اختصار مُخِلّ ولا إسهاب مُمِلّ، والخُطْبة: الكلام المنثور يخاطِب به مُتكلِّمٌ فصيحٌ جَمْعًا من الناس لإقناعهم، ومن الكتاب: صدْرُه جمع خُطَب، والخَطَّاب: وصف للمبالغة للكثير الخطبة [بضم الخاء وكسرها]. والخطيب الحسن الخُطبة، أو من يقوم بالخَطابة في المسجد وغيره، والمتحدث عن القوم. جمع خُطباء. والخَطْب والمخاطبة والتخاطب: المراجعة في الكلام، ومنه الخُطْبة، ويقال من الخُطْبة: خاطِب وخطيب، ومن الخِطبة: خاطب لا غير. والخَطْب: أيضًا الأمر العظيم الذي يكثر فيه التخاطب(3).
مصدر خطُبَ وخطَبَ/ خطَبَ على/ خطَبَ في(4). مصدر خطب، فن أدبي نثري شفهي غايته الوعظ أو إقناع السامعين بصواب قضية أو بخطأ أخرى(5). علم البيان والمعاني وعلم البلاغة. كلام يوجّه إلى الجماهير في مناسبة من المناسبات(6). علم يمكن حامله من مشافهة الجماهير بفنون القول المختلفة لإقناعهم واستمالتهم نحو قضية أو رأي ما(7).
الخطابة في الاصطلاح: قوة تتكلف الإقناعَ الممكنَ في كل واحد من الأمور المفرَدة(8). فن أدبي يعتمد على القول الشفوي في الاتصال بالناس لإبلاغهم رأياً من الآراء حول مشكلة ذات طابع جماعي". وأوضح عبد النور في (المعجم الأدبي) معنى الخطابة إيضاحاً وافياً بإلقاء الضوء على خصائص هذا الفن وعناصر أسلوبه ومؤهلات صاحبه(9). مشافهة، وجمهور، وإقناع، واستمالة(10).
وعَرَّفوا هذا العلمَ بأنه: مجموع قوانينَ تُعرِّف الدارسَ طرقَ التأثير بالكلام، وحسنَ الإقناع بالخطاب، فهو يُعنَى بدراسة طرق التأثير ووسائل الإقناع، وما يجب أن يكون عليه الخطيب من صفات، وما ينبغي أن يتجه إليه من المعاني في الموضوعات المختلفة، وما تكون عليه ألفاظ الخطبة وأساليبها وترتيبها، وهو بهذا ينير الطريق أمام من عنده استعداد الخَطابة ليربِّيَ ملكاتِه وينمِّيَ استعداداته، ويطبَّ لما عنده من عيوب، ويرشده إلي طريق إصلاح نفسه، ليسير في الدرب، ويسلك السبيل(11).
الأسلوب الخطابي: عرّفه معجم المصطلحات بقوله: (هو الذي يمتاز بقوة المعاني والألفاظ ورصانة الحجج، كما يمتاز بالجمال والوضوح وكثرة المترادفات والتكرار).
والخطابة ـ كما قال القدامى ـ فنّ يهدف إلى الإقناع والتأثير. وللوصول إلى الإقناع كان على الخطيب أن يتحلى بقوة المعاني وجزالة الألفاظ، وبالحجة والبرهان الساطع الذي يسقط دليل المخاطبين ويفضح زيف ادعاءاتهم. فالعقل الخصيب يستنبط الحجج والأدلة والبراهين التي ترسّخ مقولة الخطيب وتقنع المخاطبين بوجهة نظره(12). والأسلوب الخطابي يعرف على أنه أسلوب خطابي ذو قوة كبيرة في ألفاظه ومعانيه، وذلك لإثارة المخاطبين، ويجب أن يتسم الخطيب بقوته، وجرأته، وثقته بنفسه، وثقافته، ونبرة صوته القوية والمسموعة، ومتقن إيماءات الوجه وإشارات الجسم، يتميز الأسلوب الخطابي بعدد من الخصائص والسمات، وهي: اختيار الكلمات التي لها رنين، أي اختيار الكلمات الجزلة. تظهر مواطن الوقف التي تمتاز بالقوة وشفاء النفس. يتسم بالتكرار، وضرب المثل، واستخدام المرادفات. تتنوع ضروب التعبير، أي التنقل من الاستفهام إلى الاستنكار، والتعجب(13).
المطلب الثاني: الجانب الفني
تعد الخطابة عنصراً مهماً من عناصر الإبداع الفني منذ عصر الجاهلية عند العرب، والسبب في ذلك يرجع إلى الجانب التأثيري في نفوس الناس، واستمر الاهتمام بهذا العنصر الأدبي حتى بزوغ فجر الإسلام، إذ تمثّل ذلك باستعمال النبي الأكرم (ص) للخطابة في كثير من المناسبات، وكذلك الإمام علي (ع)، حيث اتخذت الخطابة أسلوباً متميزاً ذو صبغة جديدة، مكتسبةً معنىً اصطلاحياً يتمثل بالتكامل، حيث تمثلت الذورة في البيان وجزالة الألفاظ بعد النبي الأكرم (ص) عند أمير المؤمنين (ع) ويرجع السبب إلى اقتران جملة من الأسباب الذاتية والنفسية والتاريخية والسياسية به (ع).
-
بلاغة الأداء، وقوّة التأثير
برز الإمام علي (ع) خطيباً ذو مقدرة على التأثير في نفس المتلقّي، ويتبيّن هذا بأساليبه الخطابية المتنوعة، إذ يوصف كلامه بأنّه: (دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق)(14). ونهج البلاغة يمثّل: (أسس البيان العربي، مكانته تلي مكانة القرآن الكريم . . . وتتّصل به أساليب العرب، في نحو ثلاثة عشر قرناً، فتبني على بنائه، وتقتبس منه جذوتها، ويحيا جيّدها في نطاق من بيانه الساحر)(15).
والخطابة فرع من الجدل وعلم الأخلاق(16)، و (بطولات الإمام ما اقتصرت يوماً على ميادين الحرب، فقد كان بطلاً في صفاء رأيه، وطهارة وجدانه، وسحر بيانه، وعمق إنسانيته، وحرارة إيمانه، وسمو دعوته، ونصرته للمحروم والمظلوم من الحارم والظالم، وتعبّده أينما تجلّى له الحق)(17).
وينماز أسلوب خطبه (ع) بـ: (التكرار بغية التقرير والتأثير، وباستعمال المترادفات وباختيار الكلمات الجزلة ذات الرنين)(18)، و (الجنوح إلى الأسلوب الإنشائي المعتمد على الاستفهام والتعجب والدعاء، وأسلوب التوكيد)(19) ، و (بقـوة المنطـق وبراعـة البيـان اسـتطاع علي وابن عباس إقناع الخوارج بخطـئهم حين خرجـوا عليه في أول أمرهم فعادوا إلى الكوفة)(20).
-
سحر الأداء
ظهرت في أسلوب الخطابة حين مجيء الإسلام سمات عامّة (ناجمة عن قوة العاطفة وشدة إيمان الخطيب بما يقول وحرصه على إقناع المخاطبين برأيه واستمالتهم إليه وتقريرالفكرة في نفوسهم، كاللجوء إلى أساليب التوكيد المختلفة من تكرار وقسم)(21)، وقد بلغ أسلوبعليّمن الصدق حداً ترفع به حتى السجع عن الصنعة والتكلّف. فإذا هو على كثرة ما فيه من الجمل المتقاطعة الموزونة المسجّعة أبعد ما يكون عن الصنعة وروحها، وأقرب ما يكون من الطبعالزاخر. فانظر إلى هذا الكلام المسجع وإلى مقدار ما فيه من سلامة الطبع: "يعلم عجيج الحوحوش في الفلوات، ومعاصي العباد في الخلوات، واختلاف النينان في البحار العامرات، وتلاطم الماء بالرياح العاصفات- نهج البلاغة: الخطبة ١٩٨ ـ ٢(22).
وتكلّم في إحدى خطبه قائلاً: "وكذلك السماء والهواء، والرياح والماء، فانظر إلى الشمس والقمر، والنبات والشجر، والماء والحجر، واختلاف هذا الليل والنهار، وتفجر هذه البحار، وكثرة هذه الجبال، وطول هذه القلال، وتفرّق هذه اللغات، والألسن المختلفات. . . الخ"- نهج البلاغة: الخطبة ١٨٥ ـ ١٩.
يقول جورج جرداق: إذا قلنا: إنّ اسلوب عليّ توفّر فيه صراحة المعنى، وبلاغة الأداء، وسلامة الذوق الفنّي، فإنّما نشير إلى القارىء بالرجوع إلى نهج البلاغة ليرى كيف تتفجر كلمات عليّ من ينابيع بعيدة القرار في مادّتها، وبأية حلّةٍ فنّيةٍ رائعة الجمال تمور وتجري. وإليك هذه التعابير الحسان في قوله: "المرء مخبوء تحت لسانه" نهج البلاغة، قصار الحكم: ١٤٨ و ٣٩٢، وفي قوله: "الحلم عشيرة" نهج البلاغة، قصار الحكم: ٤١٨، أو في قوله: "من لان عوده كثفت أغصانهنهج البلاغة، قصار الحكم: ٢١٤، أو في قوله: "كل وعاءٍ يضيق بما جعل فيه إلا وعاء العلم فإنّه يتّسع نهج البلاغة، قصار الحكم: ٢٠٥، وجاء فيها: . . . فإنه يتّسع به، أو في قوله أيضاً: "لو أحبّني جبلٌ لتهافتنهج البلاغة، قصار الحكم: ١١١، أو في هذه الأقوال الرائعة: "العلم يحرسك وأنت تحرس المال نهج البلاغة، قصار الحكم: ١٤٧ ـ ٣، رب مفتونٍ يحسن القول فيهنهج البلاغة، قصار الحكم: ٩، إذا أقبلت الدنيا على أحدٍ أعارته محاسن غيره، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه نهج البلاغة، قصار الحكم: ٩، ليكن أمر الناس عندك ي الحق سواء نهج البلاغة: الكتاب ٥٩ ـ ١، افعلوا الخير ولا تحقروا منه شيئاً فإنّ صغيره كبيرٌ وقليله كثير نهج البلاغة، قصار الحكم: ٤٢٢، هلك خزان المال وهم أحياء . ما متّع غنيٌّ إلا بما جاع به فقيرنهج البلاغة، قصار الحكم: ١٤٧ ـ ٦، ثمّ استمع إلى هذا التعبير البالغ قمّة الجمال الفني وقد أراد به أن يصف تمكّنه من التصرف بمدينة الكوفة كيف شاء، قال: "ما هي إلا الكوفة أقبضها وأبسطهانهج البلاغة، قصار الحكم: ٣٢٨، وفيه: فما جاع فقير إلاّ بما متّع به غني، فأنت ترى ما في أقواله هذه من الأصالة في التفكير والتعبير، هذه الأصالة التي تلازم الأديب الحقّ بصورةٍ مطلقة ولا تفوته إلا إذا فاتته الشخصية الأدبية ذاتها.
ويبلغ أسلوب عليّ قمة الجمال في المواقف الخطابية، أي في المواقف التي تثور بها عاطفته الجياشة، ويتّقد خياله فتعتلج فيه صورٌ حارةٌ من أحداث الحياة التي تمرس بها. فإذا بالبلاغة تزخر في قلبه وتتدفّق على لسانه تدفق البحار.
ويتميز اسلوبه في مثل هذه المواقف، بالتكرار بغية التقرير والتأثير، وباستعمال المترادفات وباختيار الكلمات الجزلة نهج البلاغة: الخطبة ٢٥ ـ ١، ذات الرنين المتدفّق عذوبةً ومتانة، وقد تتعاقب فيه ضروب التعبير من إخبارٍ إلى استفهامٍ إلى تعجبٍ إلى استنكار. ولو قرّبنا بين الخطابة والشعر لوجدنا أن كلاهما يعتمدان على اللغة الدقيقة الّتي تتّسم بالوضوح، وأنّ كلاً منهما يخاطب العقل والعاطفة بقدرٍ مشترك تكون مقاييسه محتفلة فيما بينها، وقد لا يعير الخطيب أهمية للوزن، ولكن نراه يصوغ عباراته باستخدام ايقاع مثير للانفعال، في الوقت نفسه يمكن لنا ملاحظة التقطبع في الجمل مما يجعل الأمر أقرب إلى الكلام الموزون والمقفّى(23).
وقد اشتهر السجع –تواطؤ الفواصل في الكلام المنثور على حرف واحد-(24) (غير المتكلّف) في خطب الإمام علي (ع)، والّذي يحقق موسيقى الأسلوب(25)، في حين يرى البعض من الباحثين وجود شيء من التكلّف في السجع في بعض خطبه (ع)، فضلاً عن أن بعض الألوان الأُخرى ذات الصبغة البديعيّة، وهي الألوان الّتي لم تعرف الطريق إلى النّثر العربي إلّا مع العصر العبّاسي(26)، حيث اعتبر هذا الرأي ضعيف في أن (الخطباء تتكلّم عن الخلفاء الراشدين، فيكون في تلك أسجاع كثيرة، فلا ينهونهم)(27).
وفي خُطب أمير الفصاحة والبلاغة علي (ع) نرى تحقّق الموسيقى في الكلام والأسلوب، ويجعل فكر المتلقّي وقلبه ممسوكين عن طريق السجع غير المتكلّف، وقد جاء الانسجام والتوافق الصّوتي، مما يتركه في نفس المتلقّي وفكره، من هنا نلحظ أن العلاقة قد انبرت بين السجع والخطابة، ويمكن أن نتلمّس ذلك من خلال قوله (ع): (وَفَرَضَ عَلَيْكُمْ حَجَّ بَيْتِهِ الْحَرَامِ، الَّذِي جَعَلَهُ قِبْلَةً للأنام، يَرِدُونَهُ وُرُودَ الاْنْعَامِ، وَيَأْلَهُونَ إلَيْهِ وُلُوهَ الْحَمَامِ، جَعَلَهُ سُبْحَانَهُ عَلاَمَةً لِتَوَاضُعِهِمْ لِعَظَمَتِهِ، وَإِذْعَانِهِمْ لِعِزَّتِهِ. وَاخْتَارَ مِنْ خَلْقِهِ سُمّاعاً أَجَابُوا إلَيْهِ دَعْوَتَهُ، وَصَدَّقُوا كَلِمَتَهُ، وَوَقَفُوا مَوَاقِفَ أَنْبِيَائِهِ، وَتَشَبَّهُوا بِمَلاَئِكَتِهِ الْمُطِيفِينَ بِعَرْشِهِ، يُحْرِزُونَ الاْرْبَاحَ فِي مَتْجَرِ عِبَادَتِهِ، وَيَتَبَادَرُونَ عِنْدَهُ مَوْعِدَ مَغْفِرَتِهِ. جَعَلَهُ سُبْحَانَهُ للإسلام عَلَماً، وَلِلْعَائِذِينَ حَرَماً. فَرَضَ حَجَّهُ، وَأَوْجَبَ حَقَّهُ، وَكَتَبَ عَلَيْكُمْ وِفَادَتَهُ)(28).
وعند التحليل للسّجع في خطبته (ع) نلحظ أنّه يتمتّع بالقصر، حيث نرى أن الألفاظ من (2-10)، وكلّما كانت الألفاظ قليلة كان الخطاب أحسَن وأجوَد، وذلك لقرب الفواصل من السامع(29). وهذا النوع يُعدّ من أصعب أنواع السجع، وأوعرها طريقاً، وإنما يدل ذلك على أن المتكلّم متمكّن من الصياغة للنّص؛ (لأن المعنى إذا صيغ بألفاظ قصيرة عزَّ مواتاة السجع فيه لقصر تلك الألفاظ وضيق المجال في استجلابه) (30).
-
موافقة الأسلوب لمقتضى الحال
يجد المستمع لخطب الإمام علي (ع) تنوّع وتلوّن في الأساليب، ولم يأتِ ذلك اعتباطاً؛ بل جاء متماشياً مع الفكرة والحالة العاطفية للمتلقّي والمناسبة، ويتمثّل ذلك بلحاظ انسجام الأحرف مع بعضها، والحلاوة في وقعها، والتلاؤم في فِقرها، فنرى السجع ذو المقطع المغلق يطغى مرّة، والمفتوح مرّة أخرى، والترصيع، ولزوم ما لا يلزم، حيث يقوم (ع) بالتوظيف للأساليب والقطع الصوتية توظيفاً يتّسم بالدلالة بحسب المناسبة، كما والأصوات لها ايقاعها الموضوع بمهارة لغوية عالية الدّقة في الاختيار. إذ يبلغ الأسلوب عنده (ع) قمّة الجمال في المواقف الخطابية، أي في المواقف الّتي تثور بها عاطفته الجيّاشة، ويتّقد فيها خياله فتعتلج فيه صور ذات طابع انفعالي من أحداث الحياة الّتي اعتاد على ممارستها، إذ أن البلاغة زاخرة في قلبه، متدفّقة على لسانه كما هي البحار. ويتميّزاُسلوبُه بالتكرار بُغيةَ التقرير والتأثير، وباستعمال المترادفات وباختيار الكلمات الجزلة ذات الرنين المتدفّق عذوبةً ومتانة، وقد تتعاقب فيه ضروب التعبيرمنإخبارإلى استفهامٍ إلى تعجّب إلى استنكار، وتكون مواطن الوقف فيه قوّيةً شافيةً للنفس، وفي ذلك ما فيه من معنى البلاغة وروح الفنّ(31). وإذا لاحظنا خطبة من أشهر خطبه (ع) في الجهاد، فقد خطب بها في الناس لمّا أغار سفيان ابن عوف الأسدي على مدينة الأنبار بالعراق، وقتل عامله عليها: (هذا أخو غامد قد بلغت خيلُه الأنبار، وقتل حسّان بن حسّان البكري، وأزال خيلّكم عن مسالحها وقتل منكم رجالاً صالحين، وقد بلغني أنّ الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة، والاُخرى المعاهدة، فينزعُ حِجلّها، قُلبها، ورُعاثّها، ثم انصرفوا وافريّن ما نال رجلاً منهم كلمٌ، ولا أريق لهم دم، فلوأنّامرءاً مسلماً مات من بعد هذا أسَفاً، ما كان به مَلوماً، بل كان به عندي جديراً، فيا عجباً، والله يميت القلبَ ويجلب الهمّ اجتماعُ هؤلاء على باطلهم وتفرّقُكم عن حقَّكم، فقبحاً لكم حين صرتم غرضاً يُرمى: يغار عليكم ولا تغيرون، وتُغّيرون، وتُغزَون ولا تَغزُون، يُعصى الله وترضون)(32)، من هنا تتبيّن المقدرة عنده (ع)، من خلال هذه الكلمات الموجزة، حيث تدرّج في استنهاض إثارة الشعور عند المتلقّي، بغية الوصول به إلى ما يصبو إليه، إذ نلاحظ أنه (ع) قد سلك بهذا الأسلوب الطريق الّذي يصل إلى ذروة البلاغة في الأداء، والقوة في التأثير.
ومما جاء في عهده (عليه السلام):
(ثُمَّ انْظُرْ فِي أُمُورِ عُمَّالِكَ فَاسْتَعْمِلْهُمُ اخْتِبَاراً ولَا تُوَلِّهِمْ مُحَابَاةً وأَثَرَةً فَإِنَّهُمَا جِمَاعٌ مِنْ شُعَبِ الْجَوْرِ والْخِيَانَةِ وتَوَخَّ مِنْهُمْ أَهْلَ التَّجْرِبَةِ والْحَيَاءِ مِنْ أَهْلِ الْبُيُوتَاتِ الصَّالِحَةِ والْقَدَمِ فِي الإِسْلَامِ الْمُتَقَدِّمَةِ فَإِنَّهُمْ أَكْرَمُ أَخْلَاقاً وأَصَحُّ أَعْرَاضاً وأَقَلُّ فِي الْمَطَامِعِ إِشْرَاقاً وأَبْلَغُ فِي عَوَاقِبِ الأُمُورِ نَظَراً)(33).
لقد امتاز كلام الإمام وخطبه بخصائص لغوية وبدلالات مقصدية وبنظم سياقية اختص بها، وبذلك كان كلامه دالاً على شخصه فهو امتداد لخصائص الثقافة النبوية، وهنا يتوحد الدال والمدلول كما يتوحد النص ومنتجه فلا نستطيع الفصل بينهما)(34).
المبحث الثاني: التجلّيات الشخصية
-
ذاته
لا شكّ في أن الإمام علي (ع) كان إعداده ثقافياً من عند رسول الله (ص)، والتأهيل الّذي خصل عليه إنما كان تأهيلٌ خاصاً، حيث يقول (ص): (أنا مدينة العلم وعليٌّ بابُها)، ومن قول آخر له يخاطبه فيه: (أنت منّي بمنزلة هارون من موسى)، وقوله (ص): (علي أقضاكم)(35).
وحيث الخطابة فإنها تتناول في الإعداد الإسلامي العلم والقضاء، ولرجل الدولة مهام غير ذلك فيما يتعلّق ببيانه للمسلمين كافّة في الأمور الدستورية، وما يُذيعه إليهم من ملمّات أمور الدولة وقوانينها، وهو القائل (ع): (أيُّها النّاس: سَلُوني قَبلَ أنْ تَفقِدُونِي)(36)، وأن مؤرّخو السيرة النبويّة والسّلف الصالح قد أجمعوا على أن ما ادّعى أحداً غيره هذا القول إلّا وفضحه الله! ولو نظرنا إلى أمير المؤمنين (ع) من جانب أدبي، نجد أن ما اعتدنا سماعه منه (ع)، مُضافاً إليه العهود والمواثيق والرسائل الّتي أُبرمت منه بشكلٍ نهائي، وفي طليعة الأمر العهد الّي عهده (ع) لمالكٍ الأشتر، وقد عمل المرحوم الأستاذ توفيق الفكيكي على تفصيل البنود القانونية لذلك العهد في كتابه (الرّاعي والرّعيّة).
إنَّ كفايته (ع) الشخصيّة، والإعداد الّي تلقّاه من النبي الأكرم (ص)، والعنصر البلاغي الّي عليه اثنين حتى صارت من المسلّمات الّتي لا تحتاج إلى برهان أو دليل لإثباتها، جعله كل هذا جعله إماماً للبلغاء والخطباء وأرباب الكلمة والوعظ بلا مُنازع.
-
الجانب السياسي، وأثره في أسلوبه الخطابي
إنّ قرابة الربع قرن قد أتمّها الإمام علي (ع) في العزل السياسي الّذي تعرّض إليه، منذ وفاة النبي الأكرم (ص) إلى عهد خلافته (ع)، ناهيك عن أن الوقائع والأحداث الّتي كانت قد وقعت في فترة خلافته (ع) كانت دامية، وهي في الحقيقة قد فجّرت في نفسه الوجع والألم، وأجّجت كوامن الأسى والشّجى، وقد كان ذلك بيّنٌ في خطبه الّتي تناول فيها أغراض مختلفة على المستوى الإنساني، والاجتماعي، والمعرفي وغيره من المجالات الأخرى في الحياة. فالناكثون ومشاكلهم والقاسطون وجرائرهم والمارقون ونوازعهم كل أولئك عوامل سياسية جرت إلى حروب طاحنة كان الأسى يعتصر فيها قلب الإمام (عليه السلام) فينفح عن الأمة من جهة، ويهيئ لرد أعداء الإسلام من جهة أخرى، وما يحتاج ذلك من تحذير وإنذار وترغيب وترهيب وسياسة ودفاع وهجوم وتذكير بالله ودفع إلى الجهاد وإصرار على الحق وثبات على المبدأ(37).
-
الجانب التاريخي
إنّ للعامل السياسي دور كبير في نشأة التفرّق في جمهور المسلمين، حيث انتهوا إلى فرقاً وكُتلا وجماعات، وأنّ لكلِّ جمع من هذه الجموع لابدَّ من وجود قائد وموجّه، والهدف عند الإمام علي (ع) والغاية هي أن يعود بالإسلام إلى الأصول الأولى، والتزوّد من مناهجه، والتذكير بضرورة الرجوع إلى الله تعالى في الأقوال والأعمال، والنظر إلى قدرته وعظمته، والتمسّك بالضوابط الدينيّة، في حين أنّ المسلمون قد راقت لهم الدنيا وتوهّموا بزينتها، وفي هذا الشأن يقول (ع): (كَأَنَّهُمْ لَمْ يَسْمَعُوا اللهَ سُبْحَانَهُ يَقُولُ: تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لاَ يُريدُونَ عُلُوّاً في الْأَرْضِ وَلاَ فَسَاداً وَالعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، بَلَى ! وَاللهِ لَقَدْ سَمِعُوهَا وَوَعَوْهَا، وَلكِنَّهُمْ حَلِيَتَ الدُّنْيَا في أَعْيُنِهمْ، وَرَاقَهُمْ زِبْرِجُهَا !)(38)، حيث أن الناس قد يفصلهم فاصل زمني عن عهد النبي (ص)، حيث أن الزّمن قد شكّل عهداً جديداً في بزوغ شمس البلاغة والبيان علي ابن ابي طالب (ع)، حيث أنه لم يستحصل محيصاً من اجل استفراغ الطاقة الكامنة في قريحته، وبذل الإمكانات الخطابيّة جميعها بغية العودة بالناس إلى طريق الرشاد والهداية من خلال شتّى الأساليب البلاغيّة، حيث اقتنص (ع) الفرص والمناسبات جميعها من أجل الإرشاد والوعظ والتذكير بطريق الصواب وردّ الشبهات وتذليل العقبات من أجل المضي في طريق الهداية للناس، لاسيما وأن الكثير من المواقف المُحزنة الّتي تمثّلت بابتعاد المسلمين وتخلّيهم عن الجوهر الحقيقي للإسلام.
-
الجانب النّفسي
إن من سمات وشمائل الإمام علي (ع) التقوى والزهد والابتعاد عن الدنيا ومؤازرة الفقراء وتسليتهم، حتى أصبح بذلك خير نموذج للحاكم المُنصف العادل، ونلحظ ذلك بل وأكثر منه في خطبه (ع)، ومنها قوله: (أَأَقْنَعُ مِنْ نَفْسِي بِأَنْ يُقَالَ هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ولَا أُشَارِكُهُمْ فِي مَكَارِه الدَّهْرِ أَوْ أَكُونَ أُسْوَةً لَهُمْ فِي جُشُوبَةِ الْعَيْشِ)(39)، فنجده وهو بهذا المستوى البلاغي الرفيع يلقي الخطب والمواعظ، من هنا أصبح للخطابة أثر كبير في نفس المُتلقّي، وتطوّرت على يده (ع)، وأصبحت من الفنون ذوات التكامل الأدبي، والتأثير والاستقطاب.
الخاتمة:
إن المنهج الصحيح الذي اختطّه أهل البيت (عليهم السلام) إلى العالم يندرج في الإرشاد والنصح والوعظ الذي تركوه للأجيال القادمة، واشتمل ذلك على الوعظ والحكم والإرشاد والتوجيه الأخلاقي والتربوي، وأن كل ذلك إنما هو دستورًا يسلكه من أراد النجاة والسير في الدرب الصحيح، ومن تلك المواثيق ما خلّفه لنا الإمام علي (عليه السلام) في عهده المشهور إلى مالك الأشتر واليه على مصر، فقد احتوى هذا العهد على صور فريدة من الحكم والنصائح بأسلوب بلاغي فريد.
كذلك فإن قدرة الإمام علي (ع) على التضمين القرآني في خطبه ومواعظه، تجعل المتلقي لا يشعر بوجود ذلك التضمين إلّا بعد التفحص الدقيق والتمعن، ويكون ذلك باعتماد أسلوب اللمحة ذات الدلالة.
حيث تفرّد النهج بسمات قلما نجد لها مثيلاً في أحد الكتب الإسلامية سوى القرآن والمأثور من السنة النبوية، إذ لا يمكن أن نجد كتاباً تميز بهذا السجع المختلف والأسلوب الواحد من ذات الشخصية نفسها كما في نهج البلاغة. حيث يحافظ على نفس الحلاوة والطلاوة، والقدرة نفسها في التلاعب بالأحاسيس والعواطف، إذ نجد ما يصدر منه (ع) لا يحدّه زمان ولا مكان؛ بل نجد وجهته عالمية، وهدفه إنساني، حيث يخاطب كل إنسان على اختلاف زمانه ومكانه.
ومنذ صدور النهج عن جامعه، شاع في الناس ذكره، وتألق نجمه، وأعجب به كل من قرأه، أو سمع عنه، حيث تدارسوه في كل مكان؛ لاشتماله على لفظ منتقى، ومعنى مشرف، وما اشتمل عليه من حكم ومواعظ تؤدي مختلف الأغراض، نهج غاية في السبك، يجمع بين الفصاحة والبلاغة الشموليتين، يعد الذروة العليا من الأدب العربي.
شغل الإنسان بكل أبعاده، مختلف خطبه (ع) وكلماته بغية تحريره من الجهل، وتنوير عقله بالعلوم والمعارف، تمهيداً لإيقاظه من سباته وبعثه على التأمل في الكون وما يتخلله من أنظمة ونواميس وما يحكمه من إرادة خفية دقيقة التنظيم، ليخلص من ذلك كله إلى الإيمان بالله خالق الكون وواهب الحياة.
النتائج:
من خلال البحث والاستدلال فقد توصل الباحث إلى جملة من النتائج، كان أهمها:
1- إن الخطابة: هي الفن الذي يعبّر به عن الأشياء، حيث أنّ المتلقي يصغي إلى ما يتطرّق إليه المتكلم في موقف من المواقف المختلفة في المجالس المتعارف عليها في الحياة اليومية. وهذا يتطلّب من المتكلم أن يتمتع بثقافة واسعة من أجل تنسيق خطبته، وطرح الأفكار التي يقوم بمعالجتها، والطريقة التي يقوم بعرض تلك الأفكار من خلالها لتتوافق مع الدوافع النفسية والمعطيات العقلية عند المتلقي.
2- الأدوار المختلفة التي كانت في زمن الإمام علي (ع) كان لها دور كبير في تحديد المستوى البنائي لخطبه (ع)، ونلحظ هذا الاختلاف في التنوع السجعي بين الحين والآخر فيما يتفوه به (ع)، فنجده تارة يتغلب على خطبه الطابع السياسي، وتارة أخرى الطابع الاجتماعي بمختلف أحواله.
3- بلغ أسلوبه (ع) حد الترفع عن الصنعة والتكلف، ويتبين ذلك في جمله المتقطعة الموزونة المسجعة، التي هي بعيدة كل البعد عن ذلك.
4- نجد في كثير من خطبه (ع) انسجام وتوافق صوتي في التركيب البنائي للجمل، وقد يحدث ذلك تأثيراً كبيراً في نفس المتلقي، إذ أن تحقق الموسيقى في كلامه وأسلوبه يجعل المتلقي وقلبه ممسوكين له، متأثرين بما يتكلم به،
5- في بعض المشاهد نجده (ع) يعوّل في خطبه على التكرارات بغية التقرير والتأثير، ويتمثل ذلك باستعماله المترادفات، واختيار الألفاظ الجزلة ذات الرنين المتدفق عذوبة ومتانة.
التوصيات:إنّ المعاني الإنسانية الخالدة التي نادى بها نهج الإمام علي (ع) جعلت منه موضع اهتمام الباحثين ورجال الفكر في كل عصر وجيل، فقد ذهب الكثيرون إلى شرح تلك المعاني، وإثراءها بالدراسات، وربطها بالوقائع والأحداث، حيث ذهب (ع) إلى التوعية والإرشاد، وتسليط الضوء على مكامن العبادة والرجوع إلى طريق الحق والرشاد، ومن هنا فقد خلص الباحث إلى جملة من التوصيات، وأهمها:
1- مراجعة النهج مراجعة دقيقة، والتركيز على مواطن الاستشهاد والتصوير الفني لخطب الإمام علي (ع)، والإشارة إلى المفاهيم التي لها علاقة وجذر في القرآن الكريم.
2- تناول الخطب بحسب موضوعاتها، وتبويبها من حيث الهدف والبلاغة الأدبية، حيث أن التنوع في الأسلوب لم يأتِ اعتباطاً؛ بل جاء بحسب الطابع الذي كان في وقت الإلقاء.
3- إن الإمام علي (ع) هو الامتداد لخصائص الثقافة النبوية، وفي دراسة الإرث البلاغي والبياني له، مضافاً إلى طابع الزهد والتقوى الذي كان مجبولاً عليه؛ فإنه لا يحتاج إلى من يخوض في موضوعاتٍ مذهبية انزوائية، بل إنصافاً وعقلاً ومنطقاً أنه (ع) منقطع النظير.
قائمة المصادر والمراجع:_ القرآن الكريم
1. ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، دار الأمير للنشر – بيروت 1428.
2. ابن الأثير637، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، المكتبة الشاملة 2018.
3. أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني 502، المفردات في غريب القرآن، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، دار القلم / الدار الشامية – بيروت، الطبعة الأولى 1412.
4. أبو زهرة محمد مؤلف إبراهيم أحمد 1874-1945، الخطابة؛ أصولها، تاريخها في أزهر عصورها عند العرب، مطبعة العلوم / دار الفكر العربي الطبعة الأولى 1934.
5. إحسان النصر، الخطابة العربية في عصرها الذهبي، دار المعارف - القاهرة 1963.
6. احمد مختار عمر 1933، معجم اللغة العربية المعاصرة، ، عالم الكتب – القاهرة 1429، الطبعة الأولى.
7. أرسطو طاليس 384-322 فيلسوف يوناني، الخطابة.
8. السيد عبد العزيز الطباطبائي، ما قيل في نهج البلاغة من نظم ونثر، نقلاً عن مجلة تراثنا.
9. إسماعيل علي محمد، الخطابة في صدر الإسلام 1437، منتدى مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية 1433.
10. الشريف الرضي 359-406، نهج البلاغة، مترجم إلى الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والرومانية والروسية والأردية والفارسية وغيرها من اللغات.
11. عماد قطيش، إعراب نهج البلاغة، ، تقديم: السيد هاشم صفي الدين، دار الولاء_بيروت.
12. باسل زيدان، المعجم الجامع، الطبعة الأولى، تحقيق: نجيب جبر، وائل أبو صالح، حمدي الجبالي وآخرون، جامعة النجاح الوطنية – فلسطين2001.
13. جورج جرداق 1933-2004، الأسلوب والعبقرية الخطابية، موضوع في كتابه (الإمام علي صوت العدالة الإنسانية).
14. جورج جرداق 1933-2014، بلاغة علي (عليه السلام) في خدمة الإنسان – القسم الثاني.
15. جورج جرداق 1933-2014، روائع نهج البلاغة، 4 مارس2016، مترجم إلى الفارسية.
16. حسين لفته الحافظ 2018، أدوات الطلب ودلالاتها البلاغية في عهد الإمام علي (عليه السلام) إلى مالك الأشتر.
17. دايل كارينجي 1888-1955 كاتب أمريكي، فن الخطابة.
18. سميحة ناصر خليف 1990 – فلسطين، تعريف الأسلوب.
19. شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي 902، المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة، المحقق: محمد عثمان الخشت، دار الكتاب العربي - بيروت، الطبعة الأولى 1405.
20. صبحي الصالح 1926-1986، نهج البلاغة.
21. صبور عبد النور، المعجم الأدبي، دار العلم للملايين، الطبعة الثانية 1984.
22. عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، الليثي، أبو عثمان، الشهير بالجاحظ (255)، البيان والتبيين، دار ومكتبة الهلال بيروت.
23. قاسم البريسم، منهج النقد الصوتي في تحليل الخطاب الشعري، دار الكنوز الأدبية 2000.
24. مجدي وهبه، وكامل المهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مكتبة لبنان – بيروت.
25. مجد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيرازي الفيروز آبادي 817، القاموس المحيط، مطبعة بولاق بمصر 1303.
1- ما قيل في نهج البلاغة من نظم ونثر (مقال)
2- شرح نهج البلاغة: 4.
3- القاموس المحيط: 103-104، المفردات: 286.
4- معجم اللغة العربية المعاصرة.
5- الرائد في اللغة.
6- معجم المعاني الجامع.
7- المعجم المعاصر.
8- الخطابة: 9.
9- المعجم الأدبي.
10- فن الخطابة: 9.
11- الخَطابة؛ أصولها، تاريخها في أزهى عصورها عند العرب:9.
12- معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب: 23.
13- تعريف الأسلوب (مقال).
14- منھج النقد الصوتي في تحليل الخطاب الشعري، ص9.
15- روائع نهج البلاغة (المقدمة)
16- ينظر: الخطابة، أرسطو 30.
17- روائع نهج البلاغة (المقدمة).
18- المصدر السابق، ص30.
19- الخطابة العربية في عصرھاالذھبي 45.
20- المصدر السابق، ص47.
21- المصدر السابق، ص45.
22- الأسلوب والعبقرية الخطابية (مقال).
23- ينظر: الخطابة في صدر الإسلام: 1/12.
24- المثل السائر: 1/195.
25- ينظر: فن الخطابة: 192.
26- ينظر: الخطابة العربية في عصرها الذهبي: 44.
27- البيان والتبيين: 1/290.
28- شرح نهج البلاغة: 1/131.
29- ينظر: المثل السائر 1/135-236.
30- م. ن 1/235. ()
31- بلاغة علي عليه السلام في خدمة الإنسان (القسم الثاني).
32- نهج البلاغة: الخطبة 27-10.
33- ن. م: 435.
34- مقدمة لإعراب نهج البلاغة وبيان معانيه: 4.
35- المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة: ص20.
36- نهج البلاغة: تحقيق صبحي الصالح نهج البلاغة تحقيق صبحي الصالح ص280.
37- أدوات الطلب ودلالتها البلاغية في عهد الإمام علي (عليه السلام) إلى مالك الأشتر (مقال).
38- روائع نهج البلاغة: ص136.
39- نهج البلاغة، خطب الإمام علي (ع): ج3 ص72.
Jawdat Kazem Khader Al-Hasnawi || The rhetorical style in the rule of Nahj al-Balaghah: an objective study ||IbnKhaldoun Journal for Studies and Researches || Volume 2 || Issue 7|| Pages 222 - 239.
0
-
| Article Title | Authors | Vol Info | Year |
| Article Title | Authors | Vol Info | Year |