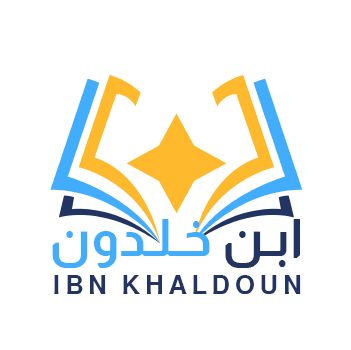2
7
2022
1682060055167_2326
https://drive.google.com/file/d/1Q0p73rJ2STGp4H5AhscbZkZwT_JwxGAX/view?usp=sharing
Study and analysis of oral comprehension strategies for a child suffering from reading difficulties
د. دحال سيهام: أستاذة محاضرة، علم النفس اللغوي والمعرفي (ارطوفونيا) جامعة الجزائر 2، الجزائر
Abstract:
The current study aims to analyze the oral comprehension strategies of a child who has difficulties learning to read. The study sample consisted of 40 school children divided into two groups: a control group (normal readers) and an experimental group (children with reading difficulties). In this study, the researcher used the following tests: intelligence test, reading test, and finally oral comprehension test. The study reached the following conclusions: There were statistically significant differences between the two groups in the grammatical morphological strategy, and the anecdotal strategy. There are statistically significant differences between the two groups in the immediate and total underlying strategy. The immediate infrastructure strategy affects the overall infrastructure strategy, and this is in the experimental group.
Keywords: reading, reading difficulties, oral comprehension, ordinary readers
المقدمة:
تعتبر القراءة خبرة لغوية، وعملية كاملة من عمليات التفكير والاتصال بكل ما تحمله هذه العملية من أطراف وتفاعلات ومقاصد. فالقراءة خبرة لا تقل قيمة عن الخبرات الحقيقية مثل: التفكير والحديث، ومختلف الخبرات التي يمر بها الفرد كالمشي، واللعب وتمدنا القراءة بمزيد من الخبرات البديلة التي تستطيع من خلالها التعرف على التجارب الحقيقية لغيرنا من بني الإنسان في مختلف الأزمنة والأمكنة ولفهم مراحل اكتساب القراءة وتطورها، اعتمد العلماء على دراسة وتفسير مختلف ميكانزمات اكتسابها عند الطفل، وما يملكه في كل مرحلة وكيفية انتقاله من مرحلة إلى أخرى. (Frith U., 1986)
فالقراءة هي وسيط من وسائط التعلم، وبدون القدرة على فهم المعنى المخبئ في النص المكتوب، فإن قيمة ذلك النص تضيع من أيدي القاري. حيث أن عملية القراءة لها أبعاد مهمة هي: التعرف على الكلمات، والفهم، والتفاعل، والتكامل بين كل هذه الأبعاد (Gertrude. H, 1995)
مع ظهور علم النفس المعرفي وتطور البحوث العلمية في هذا المجال، طرأت تغيرات في طريقة تناول هذا النشاط المعرفي (سواء من جانبه العادي أو المرضي) فأصبحت عملية القراءة تدرس في علاقتها مع بقية النشاطات المعرفية الأخرى، وأعتبر علم النفس المعرفي " الفهم " من بين النشاطات الأكثر أهمية في النظام المعرفي للفرد.
لهذا، يعتبر الفهم الشفهي نشاطا معرفيا يتطلب مهارات لا بد من توفرها عند القارئ. وقد دلت البحوث على أن هذا النشاط يتخل بشكل كبير في تطور عملية القراءة، لأن هذه الأخيرة تتطلب من القارئ أن يتأمل العناصر الصوتية الموجودة في السطور المكتوبة والطفل يتفاعل عموما مع المعنى الكامن للنص قبل أن يتمكن من التمييز الصوتي والبصري لكافة الكلمات المكتوبة. (2000 ,Mattei.F)
القراءة والفهم الشفهي عمليتان متداخلتان يصعب أن تستقل الواحدة عن الأخرى فالقراءة عملية فاعلية وأفضل أساليب تعليمها هو اعتبارها على أنها عملية اتصال ومهارة من مهارات اللغة. حيث يستطيع الطفل من خلالها أن يصوغ عبر الكلمات بكل ما يفكر فيه وما يستمع له. (1996، J.Giasson)
2. الإشكالية البحثية:
تعتبر القراءة من أهم أهداف المنظومة التربوية التي تسعى إلى تحقيقها في الطور الأول من التعليم، حيث يسعى المربون الى جعل الطفل يستوعب الميكانيزمات الأساسية لذلك. ويتم هذا عبر مراحل حيث يبدأ بالتعرف على بعض المفاهيم المتداولة في محيطه الاجتماعي لينتقل بعد ذلك إلى مرحلة فك الرموز الكتابية. وعلى هذا، ترى بعض الأبحاث أن القراءة هي نتاج نوعين من العمليات، النوع الأول وهو التعرف على الكلمات، والنوع الثاني يتمثل في عملية الفهم، هاتين العمليتين تعتبران ملزمان هامان في عملية تعلم القراءة (Content, 1990 Gombert, 1992 lecocq.1992)
إن اضطراب أحد الميكانيزمين يؤدي إلى اضطراب عملية القراءة، هذا ما يسبب معاناة الطفل على مستوى القراءة حيث يجد صعوبات في فك الرموز الكتابية أثناء عملية القراءة. فأي اضطراب على المستوى الأول (التعرف على الكلمات) يؤدي بالأطفال إلى اضطراب يسمي بعسر القراءة (dyslexies)، أما الاضطراب على المستوى الثاني (الفهم) يؤدي إلى اضطراب يسمى. (hyper lexiques).
ويعتبر الفهم عامة والفهم الشفهي خاصة عملية معرفية تساعد الطفل على تطوير مكتسباته المعرفية. فحسب (1990 ,Piaget, R) فالفهم الشفهي والقراءة عمليتان مرتبطتان إلى حد كبير، بحيث يصعب في بعض الأحيان التفريق بينهما. فحسب نفس الباحث دائما، تلعب الكفاءة في القرامة دورا هاما في عملية فهم النص الكتابي والشفهي وذلك باستعمال المكتسبات الأولية للقراءة.
فالفهم الشفهي هو القدرة والكفاءة التي تسمحان للطفل من فهم الحادثة في الوضعية الشفهية، وذلك بالرجوع إلى استراتيجيات تمكنه من الإجابة على الحادثة الشفهي (خمسي، ع، 1985).
وعلى هذا الأساس لنا أن نتساءل:
هل يوجد فرق في الفهم الشفهي بين أطفال يعانون من اضطراب صعوبات القراءة والقراء عاديين؟ على أي مستوى من الإستراتجيات الفهم الشفهي التحتية يجد الأطفال الذين يعانون من صعوبات في القراءة مشكل؟
3. الفرضيات:
- الفرضية الرئيسية: توجد فروق على مستوى استراتيجيات الفهم الشفهي بين الأطفال الذين يعانون من صعوبات في القراءة والقراء العاديين.
- الفرضيات الجزئية:
01 – يرجع اضطراب استراتيجية الفهم الشفهي الفوري إلى اضطراب على مستوى الاستراتيجية المصرفية البحرية والاستراتيجية القصصية.
02 - تؤثر الاستراتيجيات التحتية للفهم الفوري على الاستراتيجيات التحتية للفهم الكلي.
4. الإطار النظري للدراسة:
تعد القراءة من أهم الإكتسابات المدرسية حيث يبدأ تعلمها في الطور الابتدائي غير أن الكثير من الأشخاص يتعلمونها فيما بعد، أهميتها تكمن في أننا لا نستغني عنها في الكثير من نشاطاتها المدرسية، المهنية، والاجتماعية، خصوصا وأن العالم اليوم يتطور بسرعة مذهلة، أصبحنا نعتبر الأمي من لا يحسن استعمال تقنيات الاتصال الحديثة كالكمبيوتر والإنترنت، فما بالك بالذي لا يحسن القراءة والكتابة، لذلك نجد (1996,Andrieux. F) يتحدث عن نعمة القراءة التي لا يعرفها إلا الأميون.
لقد حاول الباحثون من مختلف التخصصات تعريف عملية القراءة، غير أن كل واحد منهم حسب تخصصه ومطلقاته النظرية، فنجد تعاريف بيداغوجية تربوية وأخرى نفسية عصبية، وكذلك تعاريف قدمها المختصون في علم النفس اللغوي.
تشير الدراسات إلى أن مفهوم القراءة يبدأ بشكل بسيط لا يتعدى التعرف على الحرف والكلمات المكتوبة وترجمتها إلى أصوات، إلا أنه قد تطور مفهوم هذه العملية وأصبح ينظر إلى القراءة على أنها عملية معقدة مما جعل العلماء يختلفون في تحديد مفهوم القراءة الخاص بها.
تري (1995 Guerra،A،): إن عملية القراءة لا تتمثل في ادراك الحروف وقهم معلى بل هي تحليل وتركيب معقد، هدفها بلوغ معنى جديد انطلاقا من التعبير اللساني اللغوية وهذا لا يتحقق إلا إذا كانت هاتان العمليتان متكاملتان۔ انطلاقا من هذا يبرز هذا التعريف عن وجود تكامل بين العمليات، هذا ما يمكن الفرد من القيام بعملية القراءة، وبالتالي القدرة والسرعة في ترميز الشكل الكلي للنص. فالقراءة السريعة تجعل الفرد يفهم أحسن.
فحسب (عبد الفتاح حافظ، 1998): القراءة هي عملية التعرف على الرموز المكتوبة والتي تستدعي معاني تكون قد تكونت من خلال الخبرة السابقة للقارئ في صورة مفاهيم وكذلك إدراك مضمونها الواقعي. يساهم في تحديد مثل هذه المعاني كل من الكاتب والقارئ يحاول الباحث أن يبين هنا أن عملية القراءة تتطلب تدخل الخبرة الشخصية للقارئ للتعرف على رموز النص المكتوبة، إلا أنه لم يشر إلى العمليات المعرفية التي يستلزم توظيفها لقهم المقروء.
أما (Goodman. S et Gray, J, 1998): يعرف القراءة بأنها عملية مركبة مؤلفة من عدد من العمليات المتشابكة، التي تسمح للقارئ بالوصول إلى المعنى المقصود من طرف الكاتب تصريحا أو تلميحا، استخلاصه، إعادة تنظيمه والاستفادة منها.
ويرى (1999.Plaza): أن عملية القراءة في اكتساب الطفل كل القواعد الخاصة بتجميع الحروف والحركات الانتاج وحدات مقطعية، كما أن عليه تعلم تخزين المعلومات على شكل كلمات مستقرة حتى يتمكن من النطق بها سواء كانت مكتوبة أم لا.
يعرف كل من (1997 ,Leybaert et Alegria): إن عملية القراءة هي نشاط معقد يتطلب تدخل عدة ميكانيزمات المعالجة هي: التعرف على الكلمة، معرفة الكلمات، التعرف على المعاني والإدماج التركي والدلالي. أن القارئ المصاب بصعوبات القراءة هو ذلك الذي لم يستجب لتلك البرامج التي وضعت لتلبية متطلبات عالية للتلاميذ، والذي لم يكتسب المهارات والقدرات الضرورية للقراءة العقيدة، فرسخت لديه العادات الخاطئة الأساليب السمينة في القراءة.
يبدأ الاضطراب بصورة تدريجية، ذلك أن الطفل يصادف في بادئ الأمر شيئا من الصعوبة أو يخطئ في الإجابة لبعض التعليمات. ومن الملاحظ أن المدرس يواصل في تنفيذ برنامجه المقرر، ويسير معه غالبية التلاميذ تاركين ورانهم هذا العلمية، وسرعان ما يجد التلميذ المضطرب نفسه متأخرا عن زملائه وليس في وسعه أن يقرأ بصورة تمكنه من اللحاق بهم، وهذا الوضع يمكن أن يؤدي إلى به إلى تنمية بعض العادات في القراءة كان يقرأ خطأ فيتراكم هذا كله إلى أن يظهر جليا عليه صعوبات في القراءة، لهذا أختلف الباحثون في تحديد مفهوم صعوبات القراءة، لكن قبل التطرق إلى التعريفات، تجدر الإشارة إلى أن لم نتناول مصطلح عسر القراءة لعدة أسباب منها:
-
عدم وجود اضطراب عسر القراءة بمعنى الكلمة (pur).
-
عدم وجود اختيارات التشخيص عسر القراءة بأنواعه.
-
الدراسة التي نحن بصدد القيام بها تتناول صعوبات في القراءة لأننا لا نستطيع تحديد نوع من انواع عسر القراءة.
مفهوم صعوبات القراءة:من أهم التعريفات نجد:
-
تعريف (Barel-Maisonny، S): «هو عدم القدرة على فك الرموز الكتابية ليتعدى بعد ذلك إلى الكتابة وفهم النصوص، وكل الاكتسابات المدرسية الأخرى، فحسب هذه الباحثة إن الطفل يكتب القراءة ما بين 5 و8 سنوات ".
-
يعرف (Herman،R) الاضطراب على أنه: " اضطراب مرتبط بنقص في التوجه الجانبي، حيث أن الشخص له الصعوبة التوجه في الفضاء الخارجي، وهذه الصعوبة تؤثر على قدرة التعامل مع الرموز مثل الأرقام والحروف ".
-
يرى (Frith، U, 1988): «الاضطراب على أنه القدرة على التحكم في بعض الاستراتيجيات ويحدد ذلك بعدم القدرة على اكتساب الاستراتيجيات الأبجدية".
-
أما (1999 ,Peretti C): " فيعرف صعوبات القراءة على أنها نقص في قدرات التعرف على الكلمات الكتابية ويظهر هذا من الفرق بين السن الحقيقي وسنه في القراءة الذي قدر حسب الباحث بحوالي سنتين ".
-
أما (Kershner، O, 1998): " فيعرفا الاضطراب على أنه خلل في الوظيفة الانتباهية داخل المخ، لأن قدرات الانتباه تنمو وتطور بشمر الطفل، هذا الخلل يسمح لنا بالتفريق بين الطفل الذي يعاني من صعوبات في القراءة، والقارئ الجيد، كما يضيف إلى عدم التوافق بين مراقبة الانتباه في النصف الأيسر للمخ، واللغة في النصف الأيمن يؤدي إلى ظهور اضطرابات أو صعوبات تعلم القراءة ".
التعريف الاجرائي: اضطراب القراءة هو اضطراب يمس القدرات المعرفية للطفل هذا ما يعرقل استعمال مكنزمات القراءة.
إن موضوع اكتساب ميكانزمات القراءة هام جدا، الشيء الذي جلب اهتمام العديد من الباحثين، حيث قاموا بوضع فرضيات تسمح أهم بإيضاح وإثبات الضرورة الحتمية للتعلم الخاص بالقراءة. فقدرة الطفل على فك الرموز الكتابية، مع غياب المعنى الحقيقي اللص، هذا ما يسمح للمحور المعجمي بالمسيطرة على النص. (Gough et Juel, 1989)
لكن تعلم القراءة تتطلب من الطفل أن يكون منظم في تطوير مكتسباته خاصة منها المعرفية. فمن الناحية اللسانية أن إتقان اللغة الشفهية تبني وتسهل الطفل تعلم اللغة المكتوبة، كما يمكن أن نفترض أن بعض المكتسبات في مجال اللغة المكتوبة في استمرارية المكتسبات والمعارف اللسانية الشفهية في سن مبكر.
إضافة إلى هذا الطفل الذي يتحكم في اللغة المكتوبة يمتلك مخزون لساني مميز (خاص) مستمد من تجربته الشفهية. فالمعارف الشفهية تبني القاعدة الأساسية للغة، لكن هذا لا يكفي للدخول في اللغة المكتوبة هذه الفرضية تم إثباتها من خلال دراسات (1990 ,Gernsbeher) فكانت النتائج الملاحظة على عينة الدراسة، أن هناك علاقة ارتباطية قوية بين الفهم الشفهي والفهم الكتابي.
الدراسات التي أقيمت حول الدور الشفهي في الكتابي:تكون اللغة الشفهية واللغة المكتوبة عاملان (Entités) يكتسبها الطفل في مراحل مختلفة من حياته:
-
إن إتقان الشفهي ذو طبيعة بيولوجية فهو مرتبط بتطور اللغة فاكتساب الكفاءة في اللغة الشفهية يتم بناؤها مبكرا في مستوى تحتي لفظي،
وهذا في المرحلة الحسية الحركية مع تفاعلات، واحتكاك الطفل ووسطه العالي والاجتماعي. لكن هذا التطور نجده في وسط أين تكون الأشياء طبيعية وضرورية، وهي عادات تسمح للطفل أن يقوم بمبادلات اجتماعية مرمزة. (1991 Bruner، J,)
كل شكل شفهي يكون مخزن في المعجم الأهلي ليعاد الى السجل اللساني، ليتم بعد ذلك التلفظ بالملفوظات الخاصة إن الوسط العائلي وعمر الممارسات اللغوية والمبادلات الاتصالية، تشجع الطفل على تعلم تخزين في الذاكرة مجموعة غير منتهية من الأشكال الشفهية، والتي تكون لها علاقة باللغة المستعملة في الحياة اليومية. ومع نهاية مرحلة اكتساب اللغة الشفهية يمتلك الطفل معجر داخلي أو كلمات مخزنة بطريقة مستقرة.
-
عكس اللغة الشفهية التي تبني بطريقة عفوية، لكن اكتساب القراءة يكون بطريقة منظمة، هي سجل في إطار علمي منظم. إن النقطة الأساسية لاختلاف الشفهي عن الكتابي تكمن على مستوى التعريف بالكلمات التي تتطلب فك ترميز (رموز) معين لشكل كتابي خلال فترة تعلم القراءة، نضيف التعدد الأشكال الشفهية المخزنة في الذاكرة عدد غير منتهي من الأشكال الكتابية. (1982,Fou Cambert)
دور الشفهي في الكتابي:
بينت عدة أبحاث تجريبية أن هناك علاقة ارتباطيه قوية، وهي علاقة وظيفية متواجدة بين الشفهي والكتابي. (1990Pertti, 1989 ;Gernsbacher,)
من بين الاستراتيجيات المطبقة لتعلم القراءة، هي تعلم كيفية الجمع بين الاستراتيجية (Graphophonologique) التي تسمح للطفل بوضع العلاقة بين patterns خطي ومعارف فونولوجية معجمية (فمرادتيه)، التي هي شبه موجودة ويتم تطويرها من اللغة الشفهية.
أما الباحثان (Gough, Tumer, 1986): يؤيدان فكرة أن القدرة على القراءة يمكن أن تقيم انطلاقا من التوحيد بين التعرف على الكلمات الكتابية والفهم الشفهي، بحيث يمكن إثبات هذه النظرية عند الطفل الذي يعاني من صعوبات تعلم القراءة، والتي تندرج منها نوعين من ضعاف القراءة: المجموعة الأولى التي تكون منحصرة حول فك الترميز الكلمات، أما المجموعة الثانية التي تكون متمركزة على مستوى الفهم الشفهي.
أما بالنسبة (1996 ,Content): يرى أن العلاقة بين الفهم الشفهي والكتابي هي علاقة بسيطة، هذا إذا افتراضيا وجود عنصر وحيد يمكن دمج كل النحو والتراكيب، وإما عن طريق جهاز التعرف على الكلمات الكتابية، أو عن طريق جهاز التعرف على الكلمات الشفهية. يبقى التأثير على الشفهي لشرح السهولة أو الصعوبة التي يواجهها الأطفال على اكتساب الكتابة. أما في مجال اضطرابات اللغة الكتابية، هناك دراسات التي بينت أن هناك علاقة قوية بين اضطرابات اللغة الشفهية في المرحلة التحضيرية، وصعوبات تعلم القراءة:
المعجم الشفهي سند للدخول للكتابي:-
تسمح اللغة الشفهية للطفل لإيحاء والتعبير عن الكلمة الصحيحة، بمعنى لفظ الكلمة حسب اللغة الممارسة في وسطه اللساني والاجتماعي.
-
هناك دراسة تؤكد أن المعطى يسمح بتذكير (الكلمة أو الجملة) أثناء عملية الشرح الكتابي. من هنا يصبح هناك نقطة لتعلم القراءة.
-
إن الطعن في المعجم الشفهي يسمح في المشاركة في بعض الأشكال، كما يكون باستطاعته إيجاد الكلمة المقررة بصفة صحيحة، حتى وإن كانت هذه الكلمة لم تكتب ولم تلفظ شفهيا من قبل، أي كلمة جديدة. هذا المرجع للرمز الشفهي الذي يكون عنصر مهم في سيرورات تعلم القراءة، وكذا توظيف الروابط بين الرمز الشفهي والكتابي، الذي يؤدي بالضرورة إلى الاهتمام بالشفهي أولا ثم الكتابي.
من خلال هذا التقديم حول أهم العلاقات المجردة بين الشفهي والكتابي، واللغة الشفهية والكتابية، تسمح بتعلم القراءة وطرق توظيف سيرورات تعلم القراءة وميكانزمات |كتسابها. من هنا يمكننا أن قدم تعريف الفهم وكذا أهم المكتسبات التي تدخل في سيرورة الفهم.
هل يوجد فرق في الفهم الشفهي؟هذا ما أدي بالباحثين إلى القيام بعدة دراسات في علم النفس المعرفي والتي بفضلها تمكنوا من اختيار العلاقة بين التعرف على الكلمات والفهم ومدى ارتباطها بصعوبات القراءة. (1995 Perfetti, 1995 ; Algeria)
أعطت هذه الدراسات نتائج هامة عند الأطفال الذين يعانون من صعوبات في القراءة حيث أظهرت وجود ميكانزم أدنى يسمح بالتعرف على الكلمة، التي من خلالها يقوم الطفل بتجميع الأصوات التكوين الإشارات الكتابية، ليتم بعدها تشكيل الكلمة.
وميكانزم أعلى هو الفهم الكلي للكلمة الذي يؤدي إلى فهم النص، كل هذا يسمح للطفل بالقيام بالنشاطات اللغوية، وكذا القيام بعملية الترميز والمعالجة الفونولوجية.
ظهرت في هذا السياق عدة دراسات حول موضوع صعوبات تعلم القراءة وعلاقته بالعمليات المعرفية نذكر منها: الفهم، الذاكرة، الانتباه، لكن هذه الدراسات لم تعمل على شرح الآليات المعرفية للتعرف على المشكل الأساسي الذي يجعل من الطفل يعاني من صعوبات القراءة، بمعلى تحليل العملية المعرفية التي نحن بصدد دارستها۔
ويعتبر الفهم عامة والفهم الشفهي خاصة عملية معرفية تساعد الطفل على تطوير مکتسباته المعرفية. فحسب (1990 ,Pagét, R) فالفهم الشفهي والقراءة عمليتان مرتبطتان إلى حد كبير، بحيث يصعب في بعض الأحيان التفريق بينهما. فحسب نفس الباحث دائما، تلعب الكفاءة في القرامة دورا هاما في عملية فهم النص الكتابي والشفهي وذلك باستعمال المكتسبات الأولية للقراءة.
هكذا فالفهم الشفهي هو القدرة والكفاءة التي تسمحان للطفل من فهم الحادثة في الوضعية الشفهية، وذلك بالرجوع إلى استراتيجيات تمكنه من الإجابة على الحادثة الشفهي (خمسي، ع، 1985).
ولهذا فقد قسمت الباحثة استراتيجيات الفهم الشفهي إلى ما يلي:
-
استراتيجية الفهم الفوري :(immédiate): وتعتبر القاعدة الأساسية التعرف على المكتسبات اللسانية الطفل، انطلاقا من استراتيجيات تحتية:
-
استراتيجية الفهم المعجمي: (lexicale): هي أسهل إذا ما قورنت مع الاستراتيجيات الأخرى، حيث تسمح للطفل بفهم الحادثة انطلاقا من مكتسباته المفرادتية.
-
استراتيجية الفهم الصرفي-النحوي: تعتبر هذه الاستراتيجية متوسطة الصعوبة تسمح للطفل بالتعرف على العناصر المكانية الخاصة بها.
-
استراتيجية الفهم القصصية :(narrative): تعتبر الاستراتيجية الأكثر صعوبة، وتعالج المكتسبات اللسانية من النوع الأعلى.
-
استراتيجية الفهم الكلي :(globale): تسمح هذه الاستراتيجية بالتعرف على السلوك المتخذ من طرف الطفل في حالة الوقوع في الخطأ، وبالتالي التعرف على profil، انطلاقا من:
-
سلوك المواظبة: وهو يسمح بمراقبة السلوك الطفل ومدى قدرته على المواظبة في حالة كانت إجابته صحيحة او خاطئة.
-
سلوك تغيير التعيين: يسمح هو الأخر بمراقبة مدى قدرة الطفل على إعادة تحليل الحادثة في حالة الإجابة الخاطئة.
-
سلوك التصحيح الذاتي: يسمح بمراقبة السلوك الثاني (سلوك تغيير التعين)، بالإضافة إلى مراقبة قدرة الطفل على التحكم في تصحيح خطنه، وذلك عند انتقاله من استراتيجية سهلة إلى أخرى أصعب.
فحسب تجربتنا الخاصة ومن خلال أبحاثنا على عينات من الأطفال، لاحظنا أن سبب صعوبات تعلم القراءة قد يكون راجع إلى عدم قدرة الطفل على الاستعمال الصحيح لاستراتيجيات الفهم الشفهي.
وبالتالي تجعله غير قادر على معالجة المعلومة الشفهية وهذا النقص المعجم الداخلي الذي تم بناؤه في المراحل الأولى من اكتساب اللغة، يسبب فقر على مستوى المخزون اللساني.
5.عينة البحث:
تمت دراستنا على 40 تلميذا: 20 تلميذا عادي، و20 الباقية تلاميذ يعانون من صعوبات في القراءة. وقد تم اختيارهم في وفق المعايير المعروضة في الجدول التالي:
الجدول (1): معطيات عامة تخص مجموعة الدراسة:
المجموعتين
المعايير
الأطفال العاديين
(المجموعة الضابطة)
الأطفال الذين يعانون من صعوبات في القراءة (المجموعة التجريبية)
الجنس
(10) بنات و(10) ذكور
(10) بنات و(10) ذكور
السن
9-10 سنوات
11-12 سنوات
المستوى الدراسي
الطور الثاني (السنة الرابعة)
الطور الثاني (السنة الرابعة)
مستوى القراءة
جيد (15/20)
ضعيف (04/20)
سوابق الأطفال المرضية
لا شيء
لا شيء
الملاحظات
نشاط دائم في القسم والمشاركة في كل المواد
نشاط محدود، وخمول وعدم المشاركة في القسم
6. أدوات البحث:
بحكم طبيعة هذه الدراسة التي تتمثل في دراسة الفروق في الفهم الشفهي بين الأطفال العاديين، والأطفال الذين يعانون من صعوبات في القراءة، ومن أجل التأكد من صحة الفرضيات التي انطلقنا منها وضبط المتغيرات من جهة أخرى. لهذا قمنا بتطبيق ثلاثة اختبارات مختلفة وهي كالتالي:
-
اختبار الذكاء الغيرلفظي KAB-C
-
اختبار القراءة المطبق من طرف الباحثة " غلاب " على المجتمع الجزائري
-
اختبار استراتيجيات الفهم الشفهي الذي تم تكييفه من طرف الباحثة " دحال "
وفيما يلي سوف نقوم بتقديم كل اختبار على كل حدي:
1– اختبار الذكاء KAB –C
الاختبار عبارة عن بطارية صممت من طرف الباحثان (Kaufman، S, Nadee, L,1993) هدفه التشخيص الفارقي، كما أنه يقيس مستوى الذكاء والمعارف عند الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين المتين ونصف (2,5)، واثني عشر سنة ونصف (12,5). للتذكير استعد سلم الذكاء، من السيرورات الذهنية، التي تم تطويرها من طرف المختصين في علم النفس العصبي وعلم النفس المعرفي
*-الهدف من الاختبار:
يستعمل اختبارKAB-C التقييم النفسي والإكلينيكي في الحالات العادية، كما يسمح بتقييم الأطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم. هدفها هو إعداد الكفالة البيداغوجية وهذا بالنسبة للأطفال في السن التحضيري، والذين يعانون من قصور. إضافة الى هذا تواجد أهداف أخرى ألا وهي:
-
قياس نسبة الذكاء.
-
يسمح لنا بمقارنة المعارف المكتسبة والقدرات المستعملة لحل مشكل جديد
الجدول (2): يمثل أهم البنود التي سيختبر فيها الطفل، مع تعليمة كل بند
البنود
التعليمات
1- الذاكرة الفورية للأرقام
اسمع جيدا، ثم أعد ما سمعته بنفس الترتيب
2- سلسلة الكلمات
إسم جيدا، ثم أعد لكلمات التي سمعتها بالترتيب
3- حركات اليد
أنظر جيدا إلى يدي، وأعد الحركات الترتيب الصحيح
4- التعرف على الكلمات
دقق جيدا في الصور، ثم قل ما إسم الشكل المرسوم فيها
5- المثلثات
أنظر جيدا إلى الشكل، وعليك أن تعيد نفس الشكل الذي شاهدته
6- سلسلة الصور
رتب الصور حسب تسلسلها الزمني
7- الذاكرة الفضائية
أنظر جيدا للصورة، سوف أخفيها، وعليك أن تحدد المكان الذي كانت فيه على الجدول
8- Matrices Analogique
أنظر إلى الشكل، عليك أن تعرف على الصورة التي تتوافق مع الشكل
2 – اختبار القراءة:
اختبارL'alouette"، وهو عبارة عن نص تم تصميمه من طرف الباحث (Lefavrais ,1967) ليتم بعد ذلك تعديله من طرف الباحث (1980 ,Debray). ليطبق على مجموعة جزائرية من طرف الطالبة. (غلاب، ص، 1998). وقد صمم هذا الاختبار الأهداف عديدة منها:
-
تشخيص صعوبات القراءة.
-
خروج الفاحص من الأحكام الذاتية، ويكون لديه مرجع موضوعي.
-
تحديد مستوى القراءة عند الأطفال المتمدرسين مين سواء كانوا جيدين (Norma lecteurs) في القراءة أو ضعاف (Mauvais lecteurs).
مبدأ الاختبار:
يتكون نص القراءة الL'alouette من مقاطع سهلة القراءة بالنسبة للأطفال ذويسبع سنوات، هذا لكي يتمكنوا من تكوين كلمات بسيطة، ليتم بعد ذلك تجميعها على شكل جمل بسيطة وسهلة من الناحية الصرفية. كما أنه مزين برسوم أو صور. وعليه النص يتكون 265من كلمة و29 سلسلة مقطعية.
3 – اختبار استراتيجيات الفهم الشفهي O52:
صمم هذا الاختبار من طرف الباحث "عبد الحميد خميسي" سنة 1987 بفرنسا وبالضبط بمركز علم النفس التطبيقي بباريس، وطبق على أطفال فرنسيين، نظرا للحاجة الماسة لمثل هذه الأداة في الوسط الإكلينيكي الجزائري، ارتأينا تطبيقه على مجموعة من الأطفال الجزائريين والمتكونة من:
-
المجموعة الأولى: وهي مجموعة من الأطفال العاديين في (المجموعة الضابطة).
-
المجموعة الثانية: وهي مجموعة من الأطفال الذين يعانون من صعوبات في القراءة(المجموعة التجريبية).
أ) الهدف من الاختبار: هدف الاختبار إلى الكشف عن استراتيجيات الفهم الشفهي المستعملة من طرف الأطفال الصغار هذه الاستراتيجيات لا تتعلق بفهم المقروء فقط،
ب) مبدأ الاختبار: يحتوي الاختبار على 52 حادثة، والإجابة لاتتقيد بالمصطلحات التي اكتسبها الطفل في المدرسة فقط وإنما تسمح بالكشف والتعرف على المكتسبات القاعدية التي تحصل في سن مبكرة. والتي يتم بعد ذلك تطويرها في المدرسة، أن كانت مبنية على قاعدة أساسية ومن هذا يمكن الكشف على الاستراتيجيات التي يستعملها الطفل من أجل فهم حادثة في الوضعية الشفهية. ولهذا فعلى الطفل أن يجيب بالتعيين على الصورة. وأهم الاستراتيجيات التي نجدها في هذا الاختبار هي:
- الاستراتيجية الفورية والتي تنقسم الى:
-
-
الاستراتيجية المعجمية.
-
الاستراتيجية الصرفية النحوية
- الإستراتيجية القصصية: الاستراتيجية الكلية والتي تسمح بالتعرف على سلوك الطفل في حالة الإجابة الصحيحة او الخاطئة، وتنقسم هي الأخرى الى:
-
سلوك المواظبة.
-
سلوك تغيير التعيين.
-
سلوك التصحيح الذاتي.
قبل القيام بتطبيق الاختبار لابد من التأكد من أن الطفل يفهم ما معنى التعيين على الصور الاختبار يحتوي على 52 حادثة موزعة على 30 لوحة، كل لوحة تحوي 4 صور وهناك بعض اللوحات تستعمل أكثر من مرة، أي لوحة واحدة يمكن أن تضمن حادثتين في وقت واحد، وتنقسم اللوحات إلى ثلاثة أجزاء:
*- الجزء (أ):
يحتوي هذا الجزء على 17 حادثة موزعة على 14 لوحة تسمح باختبار الاستراتيجية المعجمية، والتي يرمز لها (L). ومن المفروض أن الطفل البالغ من العمر 5,4– 6 سنوات قادر أن يجتازها بنجاح.
أهم اللوحات التي نجدها في الاستراتيجية المعجمية هي: اللوحة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السابعة، العاشرة الحادية عشرة الثالثة عشرة السادسة عشرة، العشرين، الثالثة والعشرين، الخامسة والعشرين، والثامنة والعشرين. تجدر بنا الإشارة إلى أن عدد الحادثات لا يتوافق مع عدد اللوحات وهذا راجع أن هناك لوحات تمثل حادثتين مختلفتين في نفس الوقت من أهم هذه اللوحات اللوحة الأولى الثانية والثالثة.
الجزء (ب):
يحتوي هذا الجزء على 23 حادثة موزعين على 17 لوحة، يسمح لنا هذا الجزء باختيار الاستراتيجية الصرفية النحوية، والتي يرمز لها ـ (M-s)، من المفروض أن الطفل له قدرة على اجتياز هذه الإستراتيجية في سن الخامسة ونصف.
أهم اللوحات التي نجدها في هذه الاستراتيجية هي: اللوحة الرابعة، الخامسة السابعة الثالثة عشر، الرابعة عشرة السادسة عشرة، السابعة عشرة، الثامنة عشرة التاسعة عشر، الواحدة والعشرين، الثانية والعشرون، الثالثة والعشرين، الخامسة والعشرين السادسة والعشرين، التاسعة والعشرين واللوحة الثلاثين.
ونذكر أن هناك لوحات تعلل حادثتين في نفس الوقت.
تعتبر هذه الاستراتيجية أصعب من الاستراتيجية السابقة (المعجمية)، وهذا الاستعمال متغيرات الصرف والنحو نذكر على سبيل المثال: حروف الجر، الضمائر، البنية الزمانية، الجمع، المفرد، المثنى، المذكور... الخ. هذا ما يظهر في كل اللوحات ما يسمح للطفل بتنشيط قدراته اللسانية (métalinguistique)، وبالتالي تمكنه من اختبار صورة عن أخرى.
الجزء (ج):
يحتوي على 12 حادثة موزعة على 12 لوحة، أي لكل حادثة لوحة، يسمح لنا الجزء(ح) باختبار الاستراتيجية القصصية التي يرمز لها (C) من المفروض أن الطفل قادر على اجتياز هذه الاستراتيجية انطلاقا من 6 سنوات إلى ما فوق.
أهم اللوحات التي نجدها في هذه الاستراتيجية هي: اللوحة السادسة، التاسعة العاشرة الحادية عشرة الثانية عشر، الخامسة عشرة الثامنة عشرة، العشرون، الرابعة والعشرون، السابعة والعشرون، الثامنة والعشرون، التاسعة والعشرون.
ج - أدوات الاختبار:
يتكون الاختبار من الأدوات التالية:
- دفتر يحوي أهم الخطوات التي يجب أن تباعها لتطبيق الاختبار (Manuelle).
- دفتر ثاني يجمع كل لوحات الاختبار (52 لوحة).
- ورقة التنقيط التي يتم من خلالها تسجيل إجابات الطفل الخاصة بكل استراتيجية وهي عبارة عن ورقة مزدوجة مقسمة على النحو التالي ونجد:
-
الصفحة الأولى: تحتوي على معلومات خاصة بالطفل، إضافة الى قواعد حساب النقاط المحصل عليها، ومخطط يعكس مستوى الفهم الشفهي لكل حالة.
-
الصفحة الثانية والثالثة: توجد فيها الجمل الخاصة ب 52 حادثة الموزعة على مختلف الاستراتيجيات. وهي مقسمة الى 7 أعمدة، يتم تسجيل في كل عمود العلامة المناسبة
-
العمود الأول (L) والعمود الثاني (M) والعمود الثالث(C) يتم فيهم تسجيل الإجابة الخاصة بالتعيين الأول لكل استراتيجية.
-
العمود الرابع (D2) يتم فيه تسجيل الإجابات الخاصة بالتعيين الثاني ان كان التعيين خاطئ في الأول۔
-
العمود الخامس (P) يتم فيه تسجيل الإجابات بعد التعيين الأول والثاني، إن كانت الإجابات خاطئة في الحالتين۔
-
العمود السادس (AD1) والسابع (AD2) يتم فيهما تسجيل الإجابات في حالة ما إذا تعيين الصور لا يتوافق مع المعنى المطلوب من طرف الفاحص (Aberrante)
-
الصفحة الرابعة والأخيرة توجد فيها مخططات خاصة بالتجانس الناتج حتى يتمكن المختص من معرفة نوعية السلوك الذي يسلكه الطفل عند استعماله لاستراتيجيات الفهم في الوضعية الشفهية.
د) -التعليمة: يجب على الفاحص أن يتأكد في البداية من فهم الطفل لمعنى التعيين على اللوحة التي تحوي على 4 صور. ولهذا فاللوحة (0) الموجودة في البداية تستعمل للتدريب وتقدم الطفل على النحو الآتي: "سوف نقوم بلعبة: أنا سأقوم بقراءة جملة، وأنت عليك أن تشير الصورة التي تتناسب الجملة".
مثال: 0-1- أرني الصورة " البيت الصغيرة ".
0-2-أرني الصورة الرجل مربع اليدين ".
وبالتالي تكون التعليمة العامة للاختبار على النحو التالي:
" أرني الصورة... "
يجب أن تعطي التعليمة:
-
-
بصوت عالي.
-
دون إصرار أو إلحاح.
-
دون تغيير في حدة الصوت۔
هـ) -التنقيط:
تعطى علامة (+) في حالة إصابة الطفل صحيحة في التعيين الأول، وتوضع العلامة أمام إحدى الخانات الثلاث (L، M-S، C )، وهذا حسب كل استراتيجيات أما في حالة الإجابة الخاطئة، يتم وضع رقم الصورة التي أشار إليها الطفل في الخانة المناسبة إذا أخفق الطفل في التعيين الأول، تعطى له فرصة ثانية، ويتم تدوين العلامة في الخانة(D)، وهي خاصة بالتعيين الثاني و
و) -طريقة حساب النقاط:
*-في المرحلة الأولى: يكفي حساب عدد العلامات (+) الموجودة داخل الأعمدة السبعة ويتم وضع النتيجة النهائية في أسفل الورقة، وهذا تحت کل عمود حسب الترتيب التالي: L-M-s-C-D2-P-DA1-DA2
*-النقطة N2: هي حصيلة جمع نقاط الأعمدة الثلاث (L، M-s, C)، وفق القانون التالي :
N1= L = Ms + C
*-النقطة N2: يمكن التحصيل عليها انطلاقا من النقطة (N1) بالإضافة إلى النقطة (D2) المحصل عليها خلال التعيين الثاني، ثم بعد ذلك يتم تطبيق القانون التالي:
N2= N1 + D2
*-النقطة p: يتم الحصول عليها بجمع كل العلامات المحصل عليها في العمود الخاص بها، ليطلق بعد ذلك القانون التالي:
P= p/52- N1 * 100
*-النقطة A-c: يتم حساب هذه النقطة انطلاقا من النقطتين الأول والثاني، يتم بعد ذلك تطبيق القانون التالي:
Ac= N2- N1/52-N1*100
*-النقطة C-D: يتم حسابها من نقطة A-c بتطبيق القانون بالتالي:
C-D+ 100-A-c-p
وانطلاقا من كل هذه النقاط المحسوبة يمكن التوصل الى التعرف على الاستراتيجيات التي يستعملها الطفل لفهم الحادثة، وكذا التعرف على السلوك الذي يسلكه الطفل اتجاه هذه الحادثات سواء كانت الإجابات صحيحة أم خاطئة، والحصول على كل هذه المعلومات يوجد في الورقة التنقيط منحنين:
-
المنحنى الأول الموجود في الورقة الأولى من ورقة التنقيط يسمح بالتعرف على مستوى الفهم عند الطفل، انطلاقا من النقطتين N.N.
-
المنحى الثاني الموجود في الورقة الأخيرة، دائما من ورقة التنقيط يسمح من التحقق من تجانس النتائج، وكذا التأكد حقا من أن الطفل متموضع في المنطقة العادية (normalité).
ي) التعديلات التي أقيمت على الاختبار بعد تكييفه من طرف الباحثة (د. دحال، 2006):
التعديل الوحيد الذي قمنا به في هذا الاختبار هو ترجمة الجمل الخاصة بالحادثات والتي يقوم الفاحص بإلقائها على المفحوص. أما الصور التي يقوم الطفل بالإشارة إليها لا تحتاج الى أي تكييف، لأنها صور مألوفة لدى الطفل ولا توجد صور لا تتماشى مع ثقافة المجتمع الجزائري.
فيما يخص الترجمة فقد قمنا بترجمة الجمل مع المحافظة على كل خصائص الجملة من فعل، أسم، ماضي، مضارع، نفي، المثنى، الجمع المذكر، المؤنث، ... الخ.
ليتم بعد ذلك عرضها على أساتذة اللغة العربية في الطور الثاني والثالث المتحكمين. وأجرينا كذلك بعض التصحيحات إن اقتضى الأمر. ثم قما بتجريبها على مجموعة أطفال عاديين متعثرين في السنة الرابعة، والناطقين باللغة العربية وهكذا، فقد تم تطبيق الاختبار على مجموعة من الأطفال من نفس المدارس السابقة النكرة الذين لا يعانون من أي مشكل تقسي، نطقي، سمعي بصري، ولا اضطرابات عضوية ولا وظيفة، يعتزون بمستوى جيد في القراءة واللغة هؤلاء الأطفال تتراوح أعمارهم ما بين 7سنوات و7سنوات ونصف، وعددهم 57طفل متهم الذكور والإناث.
*- طريقة العمل والتعليمة: قمنا باتباع طريقة لتطبيق الاختبار وهي الطريقة الفردية، بعد نهاية الفترة الدراسية الصباحية والمسائية أما التعليمة فقد كانت نفس التعليمية المعطاة في الاختبار بمعنى " أرني الصورة.. " يتم شرح الطريقة الطفل بقولنا "سأقرأ عليك جملة، وعليك الاستماع جيدا وان تضع إصبعك على الصورة التي تتوافق مع الجملة".
عرض وتحليل النتائج: -
-
عرض وتحليل نتائج اختبار الذكاء:
من خلال النتائج المتحصل بعد تطبيق اختبار KAB-C وتحويل النقاط الخام إلى نقاط معيارية تمكنا من حساب نسبة الذكاء، التي قدرت بـ 90,30% عند الأطفال الذين يعانون من صعوبات في القراءة. هذا يدل على أن هذه المجموعة من الأطفال لا تعاني عجز من على مستوى الذكاء، كما هو الحال عند أطفال المجموعة الأولى والمقدر ب 97,96%.
2 – عرض نتائج اختبار القراءة:
الجدول (05): يمثل نتائج اختبار القراءة للمجموعتين
الخصائص
المجموعات
معدل الأخطاء
مدة القراءة
نوعية القراءة
المجموعة الأولى
180
557
طويلة
المجموعة الثانية
0
238
جيدة
نلاحظ من خلال الجدول: أن أطفال هذ المجموعة ارتكبوا أخطاء أثناء عملية القراءة، حيث تنوعت هذه الأخطاء بين الحذف، القلب، الإضافة، الإبدال والخلط، إضافة الوقت المستغرق في القراءة الذي كان طويلا ونوعيتها التي كانت طويلة ومتقطعة في أغلب الأحيان.
اتسمت النتائج المحصل عليها في اختيار القراءة، باللجلجة والتردد، فجاءت غير مفهومة، وقد أظهر أطفال هذه المجموعة عدم القدرة على ربط وترتيب الحروف والكلمات. بعضهم أهمل قراءة بعض الكلمات والبعض الآخر أهمل سطورا وفقرات بأكملها.
لقد استخرجا أخطاء الإبدال، الحذف، الإضافة والقلب تكررت مرارا في قراءتهم مما جعلنا نعجز عن فهم قراءة أغلبهم. فقد بلغت نسبة الأخطاء عند هذه المجموعة 81,6% ما يعادل 180 خطأ من مجموع 229 كلمة.
أما فيما يخص الزمن المستغرق والذي يعتبر عاملا أساسيا في تقييم مستوى القراءة، فقد لاحظنا أن جميع أطفال هذه المجموعة استغرقوا وقتا أطول، فقد تجاوز الزمن المستغرق 10د عند أغلب الأطفال، هذا ما يجعل النص يفقد البنية الكلية وكذا المعنى الحقيقي.
وخلاصة القول مستوى أطفال هذه المجموعة في القراءة ضعيف، بسبب عدم قدرتهم على التحكم في ملزمات القراءة، فهي مجموعة تشكو من صعوبات في القراءة، لأنهم لا يزالوا لم يتحكموا بطريقة جيدة في ميكانزمات القراءة.
أما أطفال المجموعة الثانية بمستوى جيد في القراءة، هذا ما تظهره النتائج المدونة في الجدول (05)، نلاحظ أن عدد الأخطاء المرتكبة منعدم، كذلك الزمن المستغرق في القراءة كان واحد عند أغلب أطفال هذه المجموعة تقريبا. هذا ما يدل على تحكمهم الجيد في ميكانزمات القراءة، ومدى تطورهم الجيد لقدراتهم اللسانية والمعرفية.
هذا ما يسمح من تصنيفه كقارئ جيد (Bons lecteur). ويترجم هذا في قدرته على التعرف على الحرف بعد القيام بعمليتي التراسل والتجميع بسرعة. حيث أن القارئ الجيد لا يظهر أثناء عملية القراءة فرق في الزمن بين كلمة وأخرى.
في الأخير وانطلاقا من الجدول (4) يمكن أن نضيف ان هذه المجموعة من الأطفال هم قراء جيدون (Bons lecteur). وهذا استنادا إلى نسبة الأخطاء التي كانت منعدمة ومن خلال مدة زمنية أقصاها 4 دو24 ثا.
إذن الفرق واضح بين المجموعتين وهو يؤكد أن أطفال المجموعة التجريبية يعانون فعلا من صعوبات كبيرة في القراءة تجسدت في العدد الكبير والمتنوع من الأخطاء والزمن الطويل الذي استغرقه في القراءة مقارنة مع أطفال المجموعة الضابطة، هذا من جهة ومن جهة أخرى نوعية القراءة المتقطعة والرديئة جعلتنا نتحقق من التشخيص الأر طوفوني الذي خضع له أطفال هذه المجموعة بقي أن نشير في الأخير لاحظنا بالنسبة للمجموعة الضابطة تجانسا في نتائج أفرادها.
أن الفروق مهمة بين المجموعتين، لكن بالنسبة للفروق داخل كل مجموعة فنجدها مهمة في المجموعة التجريبية ومنعدمة في المجموعة الضابطة.
3 – عرض نتائج اختبار استراتيجيات الفهم الشفهي(O52) المكيف من طرف د. دحال:
3 – 1 – نتائج المجموعة الأولى:
سنعرض نتائج اختبار الفهم الشفهي بالنسبة لكل استراتيجية وهذا بعد تجميعها وفق خصائص إحصائية معينة، تسمح لنا بالدراسة الإحصائية في الفصل المقبل ثم تحليلها.
الجدول رقم (06): يمثل نتائج الاختبار(O52) وفق خصائص إحصائية
L
M-S
C
N1
D2
N2
P
A-C
C-D
Lec
X
16,5
23,3
11,5
50,4
1,6
52
0
0
0
126
0,51
0,75
0,60
0,67
0,59
0
0
0
0
0
Max
17
23
12
52
3
52
0
0
0
125
Min
16
21
10
49
1
52
0
0
0
125
%
97,5
97,2
96,3
97,1
96,9
100
0
0
0
100
توضح النتائج المعروضة في الجدول (06) أن أطفال مجموعة الأولى نجحوا في الاختبار بصفة جيدة، حيث ان اغلب الأطفال استطاعوا الإجابة (التعيين) للمرة الأولى.
هذا مسا تؤكده النسب المئوية المعروضة في الجدول (10)، وذلك في لكل الاستراتيجيات المعجمية، الصرفية النحوية، القصصية)، يظهر أن نسبة النجاح في الاستراتيجية المعجمية أكبر مقارنة بالاستراتيجية المصرفية النحوية والاستراتيجية القصصية، هذا لا يعني ان الطفل لا يحسن استعمال الاستراتيجيات الأخرى والأكثر تعقيدًا الى الاختلاف في درجة الصعوبة بترك النتائج تتفاوت بشكل طفيف.
انطلاقا من هنا يمكن التعرف على السلوك الذي يسلكه الطفل لأن من خلال النتائج تبين أن الطفل اتخذ السلوك الجيد سواء من حيث التصحيح الذاتي، او سلوك المواظبة، أو كذا سلوك تغير التعيين في حالة كانت الإجابة خاطئة أما فيما يخص نسبة الإخفاق والتي كانت ضعيفة في بعض الأحيان، ترجع إلى تسرع الطفل في إعطائه للإجابة، وليس لأنه لا يحسن استعمال الاستراتيجيات. فبعض الأطفال يقومون بعملية التعيين قبل أن يكمل الفاحص الجملة الخاصة بالحادثة. من هنا يمكن القول إن الطفل الناطق باللغة العربية يستعمل نفس الاستراتيجيات المقترحة في اختبار 52-0، التي يستعملها الطفل الفرنسي، هذا يؤكد أكثر نتائج المرحلة ما قبل التجريب التي قمنا فيها ببعض التعديلات على اختبار الفهم الشفهي.
أما فيما يخص مدى قدرة الطفل على التحكم في ميكانزمات القراءة، يمكن القول إن هذا الأخير قادر على استعمال استراتيجيات الفهم وتطويرها وفق نموه الزمني، وفقالمخططين (1-2)، حيث المخطط الأول يوضح مستوى الفهم بالنسبة لكل أطفال المجموعة الأولى الذي قدر ب 51,2.
3 – 2 – نتائج المجموعة الثانية:
الجدول رقم (07): يمثل نتائج اختبار الفهم الشفهي وفق خصائص إحصائية
L
M-S
C
N1
D2
N2
P
A-C
C-D
Lec
X
13,3
10,5
5,5
29,5
5,83
33,2
71,5
8,01
1,01
70,3
0,86
1,65
1,83
2,05
2,83
1,85
2,59
2,38
0,95
24
Max
15
13
7
32
9
37
83
18
2
95
Min
12
6
3
27
2
31
60
3
0
50
%
73
46,3
45,3
56,4
44,2
54,8
28,5
8,08
1,01
43,6
تبين النتائج الموضحة في الجدول (07) ان أطفال المجموعة التقية أخفقوا في استعمال استراتيجيات الفهم الشفهي، بحيث لم يتمكنوا من الإجابة إلا بعد إعادة التعليمية للمرة الثانية وهناك بعض الأطفال لم يتمكنوا من الإجابة حت بعد إعادة التعليمة مرة ثانية، وأصروا على الإجابة الأولى رغم أنها خاطئة.
أضف الى ذلك فالجدول (12) يظهر أن نسبة الرسوب كانت كبيرة في كل من الاستراتيجية الصرفية-النحوية والقصصية على عكس الاستراتيجية المعجمية التي تبين نجاح أطفال هذه المجموعة في التعيين. أن إخفاق الأطفال في التعيين الأول والثاني يدل على عدم قدرتهم على التحكم الجيد في هذه الاستراتيجيات.
حيث أن الأطفال هذه المجموعة لا يمكنهم القيام بالتصحيح الذاتي في حالة الإجابات الخاطئة، كما أنه لم يكن باستطاعتهم التحكم الجديد في الإجابة سواء كانت خاطئة أو صحيحة هذا ما يبقيهم في الخطأ والاستمرارية فيه، هذا ما تؤكده نتائج سلوك المواظبة والاستمرارية من هنا يمكن القول إن عدم القدرة في التحكم في استراتيجية الفهم الفوري أدى بالأطفال الذين يعانون من صعوبات في القراءة إلى عدم القدرة على التحكم في استراتيجية الفهم الكلي، بمعنى آخر عدم اتخذ السلوك المناسب أثناء عملية التعيين.
3–3– التحليل الإحصائي للنتائج:
لدراسة الفروق بين المجموعتين قمنا بحساب " t " وتحصلتا على النتائج التالية:
Sig Bilatérale
ddf
t
000
19
49,643
N1-1-1-N1-2
تبين من خلال المعالجة الإحصائية أن 49,643 = t عند مستوى 0,001= &
هذا ما يبين وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المجموعتين الضابطة والتجريبية فيما يخص متغير استعمال استراتيجيات التهم الشفهي الفوري،
إذ أن المجموعة الضابطة تتقن استعمال الاستراتيجيات بطريقة جيد عكس المجموعة التجريبية التي لم تستطع استعمال هذه الاستراتيجيات. والسبب يرجع إلى أن المجموعة التجريبية تعاني من اضطراب صعوبات تعلم القراءة. يمكن القول من هذا أنه يجد فرق على مستوى استراتيجيات الفهم الشفهي بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة هذا ما تؤكد الفرضية الرئيسية.
تتبين من خلال المعالجة الإحصائية أن 30,96 = t عند مستوى 0,001= & مما يدل على وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية من حيث متغبر استعمال استراتيجية الفهم الكلي وهذا راجع إلى عدم قدرة الأطفال في التحكم في سلوكا تهم بسبب الاضطراب، عكس المجموعة الضابطة التي تعاني من أية صعوبات ما جعلها تتحكم بطريقة جيدة في استراتيجية الفهم الكلي، وبالتالي باتخاذ السلوك السليم للإجابة على الأسئلة. إذن يمكن القول إن المجموعة الضابطة تتمتع بالتوظيف الجيد الاستراتيجيات الفهم الشفهي عكس المجموعة التجريبية. فالتناسب طردي بين استراتيجية الفهم الفوري واستراتيجية القيم الكلي،
أي كلما كانت نسبة النجاح عالية في الاستراتيجية الفهم الفوري كلما كانت نسبة النجاح عالية في الاستراتيجية الفهم الكلي هي الأخرى. هذا ما يزيد تأكيد الفرضية الرئيسية.
تفسير ومناقشة النتائج:
إن السؤال المراد الإجابة عنه هو " على أي مستوى من استراتيجيات الفهم الشفهي التحية يجد الطفل الذي يعاني من صعوبات في القراءة مشكل؟ " والإجابة على هذا السؤال استعملنا التباين (ANOVA) الذي اظهر النتائج التالية:
Signification
F
Moyennes des Carres
ddi
Somme des Carres
025,
1,417
1
18
19
Lexical Inter- Group
Enter- Group
Total
000,
8,861
1
18
19
Moph- Synt
Inter-Group
Enter- Group
Total
000,
10,051
1
18
19
Narrative
Inter-Group
Enter- Group
Total
يبين الجدول الإحصائي أعلاه بأن النتائج متقاربة جدا بين المجموعتين بالنسبة للاستراتيجية المعجمية، كما أن المعالجة الإحصائية لم تظهر أية فروق ذات دلالة إحصائية بين المجموعتين هذا ما توضحه قيمة 1.471=F المحسوبة.
أما بالنسبة الاستراتيجية الثانية يعني الصرفية النحوية فيظهر أن هناك فرقا بين المجموعتين التجريبية والضابطة حيث قدرت قيمة 881 =F وهي دالة عند مستوى 0.001=&. وهنا يمكن القول إن الأطفال الذين يعانون من صعوبات في القراءة لم يتمكنوا من التعيين بطريقة جيدة على الإجابة الصحيحة، وهذا يدل على أن المجموعة التجريبية تواجه مشكل أمام هذه الاستراتيجية لما تحويه من تغيرات في البني النحوية الصرفية للجمل.
نذكر على سبيل المثال: البنية الزمانية، الأمر، الجمع والمؤنث أي الانتقال من بنيات لسانية بسيطة إلى بنيات لسانية أعقد. أما فيما يتعلق بالاستراتيجية الثالثة أي " القصصية " قتبين أن هناك فرقا بين المجموعتين التجريبية والضابطة، حيث أن درجة 10,051=F وهي دالة عقد المستوى 0.001=& ما يبين أن أطفال المجموعة التجريبية لا يستطيعون الوصول إلى درجة تطيل البنيات اللسانية أكثر تعقيدا من الاستراتيجية الثانية، الشيء الذي جعلهم يخفقون في التعيين وعدم قدرتهم على الوصول إلى الإجابات الصحيحة.
يظهرأن هناك فروقا ذات دلالة إحصائية بين أجوبة المجموعتين التجريبية والضابطة، مما يسمح بالإجابة على الفرضية الجزئية الأولى، التي تقول بان الأطفال الذين يعانون من صعوبات في القراءة يجدون صعوبة على مستوى الاستراتيجية التحتية الثانية والثالثة، هذا ما يؤثر سلبا سلوكياتهم. هكذا فالنتيجة الإحصائية توضح الفرق الموجود بين أطفال المجموعتين والذي يعود إلى وجود اضطراب على مستوى الفهم الشفهي، الراجع بالدرجة الأولى إلى مشكل صعوبات تعلم القراءة الذي تعاني منه المجموعة التجريبية وهو الفرق الوحيد الموجود بين المجموعتين آن عدم تحكم الطفل الذي يعاني من صعوبات في القراءة في أحد ميكانزمات القراءة ألا وهو الفهم الشفهي يرجع إلى تأخر أو عدم اكتساب الطفل استراتيجية من استراتيجيات لاكتساب القراءة.
وحسب الباحث (Frith ,1985) إن اضطراب المرحلة الأول (الحرفية) يؤدي إلى اضطراب كل المراحل الباقية، والطفل الذي يعاني من صعوبات في القرادة ليس بإمكانه التعرف على الحروف وبالتالي لا يمكنه القيام بعملية التجميع ليصل إلى الكلمة وبعدها إلى الجملة.
وللتأكد من صحة الفرضية الجزئية الثانية التي تقول إن استراتيجيات التحتية للفهم الفوري تؤثر سلبا على استراتيجيات التحتية للفهم الكلي، قعدا بالتحليل التباين بين الاستراتيجيتين. فقد قدرت قيمة 19.97=F وهي دالة عند مستوى 001 =& هذا يؤكد الفرضية الجزئية الثانية تأكيدا قطعيا۔ إن النتائج التي توصلنا إليها والتي تم تأكيدها إحصائيا، كانت نفس النتائج التي توصلت إليها بعض البحوث والدراسات، نذكر منها دراسة عبد الحميد خمسي (1989) الذي لجأ إلى تطبيق استراتيجيات الفهم الشفهي على مجموعة من الأطفال الذين يعانون من صعوبات تعلم القراءة، توصل إلى أن أطفال هذه المجموعة لم يتمكنوا من استعمال هذه الاستراتيجيات خاصة بالنسبة للاستراتيجية الصرفية النحوية وكذا القصصية التي يتم تعويضها باستراتيجيات أخري، الشيء الذي أثر على الاستراتيجية الكلية التي عرضت هي الأخرى من طرف الأطفال باستراتيجيات تعويضية
الخاتمة:
امن خلال الدراسات النظرية التي تطرقنا إليها في الجانب النظري والتي بينت وأكدت أن الفهم الشفهي يلعب دورا هاما في المعالجات المعرفية هذا من جهة، ومن خلال دراستنا والتي كان الهدف منها دراسة الفهم الشفهي عند الأطفال الذين يعانون من صعوبات تعلم القراءة من جهة أخرى يمكن استخلاص ما يلي:
-
بينت نتائج هذه الدراسة والتي تمثلت في دراسة الفروق بين أطفال يعانون من صعوبات تعلم القراءة وأطفال عاديين (المجموعة الضابطة) أن التباين بين هاتين المجموعتين كبير وواضح وذو دلالة إحصائية.
-
أظهر التحليل أن الأطفال الذين يعانون من صعوبات تعلم القراءة لهم توظيف سيئ لهذه الاستراتيجيات (الصرفية النحوية، القصصية) واتضح أن مستوى القيم الشفهي ضعيف بالمقارنة مع مجموعة الأطفال العاديين. هذا ما تؤكده الفرضية الجزئية، فأي مشكل على مستوى الاستراتيجيات التحتية الفورية يؤثر بالضرورة على الاستراتيجيات التحتية الكلية، والنتائج الإحصائية تؤكد ذلك.
-
إن تعقد وأهمية كل من عمليتي الفهم الشفهي والقراءة كوظيفتين معرفيتين لا يمكن أن يثبط عزيمتنا كمختصين بل العكس يجب أن يكون بمثابة محفز يجعلنا نقوم بالاختبارات اللازمة التي تجعلنا نفهم بصفة جيدة الاضطراب.
قائمة المصادر والمراجع:
أولا: المراجع العربية:
-
إبراهيم، عبد العليم (1994)، الموجه الفني لمدرسي اللغة العربية، الطبعة 15، القاهرة: دار المعارف.
-
أبو العزائم، إسماعيل (1993)، القراءة الصامتة السريعة، القاهرة، عالم الكتب.
-
أحمد، عبد الله أحمد وممحد، فهيم مصطفى (1994)، الطفل ومشكلات القراءة، الطبعة الثالثة، القاهرة: الدار المصرية.،
-
الأسعد، عمر (1989)، اللغة العربية بين المنهج والتطبيق، عمان: دار المكتبات والوثائق الوطنية.
-
بوند، جاي وتنكر، مايلز وواسون، بار بارا (1984)، الضعف في القراءة- تشخيصه وعلاجه، ترجمة: محمد منير مرسي وإسماعيل أبو العزائم، القاهرة: عالم الكتب.
-
بيرانا، دونالد (1990)، القراءة الوظيفية،ترجمة: محمد قدري لطفي، القاهرة: مكتبة مصر.
-
جراي وليم (1981)، تعليم القراءة والكتابة، ترجمة: محمود رشدي خاطر وكافية رمضان وحسن شحاتة، القاهرة: دار المعرفة.
-
الجمبلاطي، علي والتوانسي، أبو الفتوح (1985)، الأصول الحديثة لتدريس اللغة العربية، القاهرة: نهضة مصر للطبع والنشر.
-
خاطر، محمود رشدي ومكي، أحمد وشحاتة، حسن (1994)، تطوير مناهج تعليم القراءة في مراحل التعليم العام في الوطن العربي، تونس: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
-
دلي، جعفري (1993): دراسات في القراءة السريعة، الطريقة السريعة لزيادة قدرتك على التعليم،ترجمة: عبد الطيف الجميلي، تونس: المنظمة العربية لتربية والثقافة والعلوم.
-
سمك، محمد صالح (1995): فن التدريس للتربية اللغوية، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.
-
السيد، محمود أحمد (1989): القراءة مفهوما وأهمية ومتطلبات، التربية الجديدة، بيروت: مكتب اليونسكو الإقليمي لتربية في الدول العربية، العدد التاسع والثلاثون، السنة الثالثة عشر، 38-52.
-
شحاتة، حسن (1992): تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق، القاهرة: الدار المصرية اللبنانية.
-
الشرقاوي، أنور محمد (1991): التعلم نظريات وتطبيقات، الطبعة الرابعة، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية
-
صالح، أحمد زكي (1987)، إختبار الذكاء المصور، القاهرة، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية.
-
عبد الرحمن، حسين راضي ومصطفى، زايد خالد (1991)، طرق تعليم الأطفال القراءة والكتابة، أربد: دار الكندي لنشر والتوزيع.
-
عبده، عبد الهادي وعثمان، فاروق (1995): سيكولوجية القراءة، القاهرة: دار المعارف.
-
عصر، حسني عبد الهادي (1992): القراءة طبيعتها- مناشط تعليمها- وتنمية مهاراته، الإسكندرية: المكتب العربي الحديث.
-
كمال، جوزال عبد الرحيم (1998): الإستعداد لقراءة وعلاقته بالتدعيم السري والمشاركة الوالدية وأفكار ودراك طفل الروضة للقراءة، دراسات نفسية، رابطة الأخصائيين النفسيين المصرية، المجلد السابع، العدد الأول، 68-112.
-
كريمان.. بدير، اميلي. صادق (200): تنمية مهارات اللغوية للطفل، الطبعة الأولى، القاهرة: عالم الكتب.
-
لطفي، محمد قدري (1995): التأخر في القراءة- تشخيصه وعلاجه في المدرسة الابتدائية، القاهرة: مكتبة مصر.
-
لطفي، محمد قدري (1996): معجم المصطلحات التربوية المعرفة في المناهج وطرق التدريس، الطبعة الأولى، القاهرة: عالم الكتب.
-
مجاور، محمد صلاح الدين (1984): دراسة تجريبية لتحديد المهارات اللغوية في فروع اللغة العربية، الكويت: دار القلم.
-
مجاور، محمد صالح الدين والشيخ يوسف وعبد الحميد، جابر (1995): سيكولوجية القراءة، القاهرة: مكتبة النهضة العربية.
-
مصطفى، فهيم (1999): مهارات القراءة- قياس وتقويم، الطبعة الأولى، القاهرة: مكتبة الدار.
-
الملا، بدرية سعيد (1989): التأخر في القراءة الجهرية تشخيصه وعلاجه، الطبعة الأولى، الرياض: دار عالم الكتب للنشر والتوزيع.
ثانيا: المراجع باللغة الفرنسية:
-
-
Ammar, M. (1997). Les stratégies d'identification de mots écrit en arabe, thèse de doctorat, psychologie sciences de l'éducation, paris.
-
Bouchard, M. (1999). Apprendre à lire comme on apprend, Ede. hachette, paris.
-
Carbonne, S et Gillet, P. (1996). Approche cognitive des troubles de la lecture et de l'écriture chez l'enfant et l'adulte, Ede: Solal, Marseille.
-
Chevrle Muller, C. (1996). Le langage de l'enfant, Edi: Masson, France.
-
Derguini, M. (2002). De l'oral à l'écrit, collection savoir psychologique, No1, Edition du laboratoire de l'éducation - Formation-travail, Alger.
-
Estienne, F. (1998). Méthode d'entrainement a la lecture et dyslexie, stratégie du lire, Ede: Masson, Paris.
-
Filjakow, J. (1995). L'acquisition de la langue écrite, Glossa. Unadrio, No48.
-
Florim. A. (2000). Le développement du langage, Ede: Dunod, Paris.
-
Ghellab. S. (1998). Trouble de l'apprentissage de la lecture à l'école fondamentale : Elaboration d'un test en langue avale. Thèse de magistère. Institut de psychologie et des sciences de l'éducation universitaire d'Alger
-
Gombert, J.E (1997). Mauvais lecteurs : plus de dis synoptique que de dyslexique. Glossa, Unodrio N°56.
-
Gregorie, Jet Plerant, B. (2001). Evaluer troubles de la lecture : les nouveaux modèles théorique et leurs implication diagnostique, Edi : de Bock Université, Paris.
-
Guez-Benals, V. (1996). La rééducation des troubles spécifique du développement du langage écrit, Glossa, Unadrio N°53.
-
Khomsl, A. (1994). A propos des stratégies de compréhension chez l'enfant dyslexique, in
-
Khomsl, A (1987). Evaluation de la compréhension et rappel de récit chez l'enfant. Question de logopédie, 15, 107 - 132.
-
Khomsl, A (1989). Evaluation la compréhension en lecture, Nantes, travaux de psycholinguistique . université de Nantes.
-
Kremer, J.M. (1994). Les 500 conseils de l'orthophoniste : trouble de langage, Edi : Lyon, Paris.
-
Morand. P. (1995). La psychologie de l'enfant. Edi :Marabout, Belgique.
-
Nouani, H. (1996). Embauche d'analyse du discours, psychologie. N°5-6, S.A.R.P, Alger.
-
Peereman, R. (1992) Lecture, écriture, orthographe, trouble, Lille, presses université de Lille.
-
plaza.M. (1995). Evaluation de la dyslexie chez une fille dysxique, Glossa. Unadrio, N°48.
-
Roulin, JL (1998). Psychologie cognitive, Edi: Breal, Rosny, France.
-
Segui, J. (1992). Le composant cognitives de la lecture, in p. le coq (eds). La lecture : processus, apprentissage, troubles Lille, presses université de Lille.
-
Sprengh. C et Casalis. S.lire : lecture et écriture acquisition et troubles du développement, Edi; PUF, paris,1996.
-
Valdois. S (1996).approche cognitive des troubles de la lecture et de l'écriture chez l'enfant et l'adulte. Edi: sodal. Marseille, 1996.
-
Vanhout, A. (1998). Dyslexie. Edi : Masson, Paris.
Dahal Siham || Study and analysis of oral comprehension strategies for a child suffering from reading difficulties || Ibn Khaldoun Journal for Studies and Researches || Volume 2 || Issue 7 || Pages 500 - 530.
0
| Article Title | Authors | Vol Info | Year |
| Article Title | Authors | Vol Info | Year |