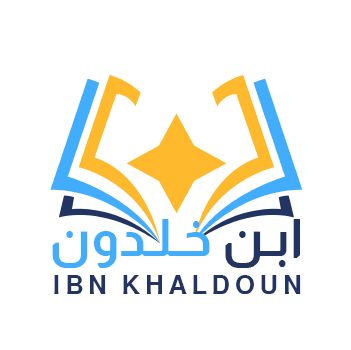2
7
2022
1682060055167_2329
https://drive.google.com/file/d/1kzNTg8ATHv4dMnigZoTYJMqnDrZwOi9m/view?usp=sharing
The grammatical explanation of Ibn Babshath in his book Sharh Al-Mahsebah (Fasl Al-Ism as a model)
م. د. وليد فياض حسن سعود الجبوري: مدرس دكتور في اللغة والدلالة، وزارة التربية والتعليم، صلاح الدين، العراق
Abstract
Grammarians have trolled the argument in Arabian speech which they extract this issue from Arabian speech and their scales. Ibn Babshath is a one of grammarians who is deal with the argument in his book under title (Sharah Mokadamat Al- Mahsabah). The study is reorganization the manner of Ibn Babshath by insertion the sections of the book the argument among all parts of speech which are: the nouns, the verbs, and the consonants. This study is limited on separation of noun and explanation of his different arguments such as: Deuteronomy, retribution, equation, scure ambiguity, the resin of the opposite, alacrity, heavy, and precaution. The opposite explanation in the introduction is lifing Al-Muthanna by al-alph without al-waw in order to deffereniate between Al-Muthanna and plural so that tha argument is consider as (slipt ) argument. It is employed on all types of nouns, and arguments. The argument extract according to the descriptive analysis approach based on the reconazation of arguments and identified its grammar benefits . we find the objective and series study in the introduction of Ibn Babshath to whom concerns shed light on the rest sections of Al- Mahsabah introduction.
Keywords: Aben Babshath, Sharh Al-Mahsebah, name , bug kinds of bug
المقدمة:
تعد العلة السمة البارزة في الدرس النحوي، والركيزة الرئيسة في معالم المنهج النحوي، والذي استمد بنيانه من استقراء كلام العرب وأقيستهم، إذ سبق العلة الأحكام النحوية المفصلة لأجزاء الكلم والجمل ومواقعها وطريقة النطق بها، والعلة أهم مفصل أو ركيزة مهمة من ركائز الإفصاح في النظام النحوي، وطريقة العرب في كلامهم قياساً على القرآن وفصيح كلام العرب.
والعلة في أصلها ممزوجةٌ وكامنة في نفوس وطبائع العرب قبل وضع النحو، ولا يخفى دور النحاة في تقعيد اللغة على وجوهها المختلفة وتصانيفها تحت أبواب مختلفة كالمعربات ومنها المرفوعات والمنصوبات، والمبنيات ومنها الأسماء والضمائر والحروف المبنية، ثم بعد ذلك تناول النحاة العلة ابتداءً من الحضرمي مروراً بأطوارها بالخليل وسيبويه والمبرد، وعلل النحو للزجاجي، وفي كتاب الخصائص لابن جني (ت 392هـ) حتى السيوطي (ت 911).
وبما أن العلة في عصورها المتأخرة وليدة الاستقراء الذي اعتمد على القياس الفطري في بدايته أدى إلى تعددت مؤلفات العلل واختلاف مشاربها الكلامية والفلسفية حتى ألفينا بعض الشروح لم تسمِ كتب أو شروح للعلة، بل تكون العلة حاضرة في إسلوبها التعليمي كما في شرح المقدمة المحسبة لطّاهر بن بابشاذ التي هي محل البحث والدراسة.
وسيتناول البحث جانباً من جهود أحد علماء النحو الذي ساهم في دراسة العلة وهو: طَاهِر بن أَحْمد بن بابشاذ (أَبُو الحسن) النَّحْوِيّ المصرِيّ أحد الْأَئِمّة في والأعلام في عُلُوم العَرَبيّة المتوفى سنة تسع وَسِتّينَ وَأَربَعمِائة سنة (469ه) على الأرجح، فوقع الاختيار على كتابه (شرح المقدمة المحسبة) ليكون باباً نطلع فيه على جهوده في علم النحو. فبات عنوان البحث (التعليل النحوي عند بابشاذ في كتابه شرح المقدمة المحسبة (فصل الاسم أنموذجاً).
أما سبب اختيار موضوع الدراسة وهدفه، فكان دور الدراسة في السنة التحضيرية للدكتوراه الأثر لدراسة العلة عند بابشاذ الذي لم يلقَ كتابه اهتماماً كغيره بين الكتب، ولم يسلط الضوء على جهده في التعليلات. فاستهواني تفصيله وتصريحه للعلة مما حملني لدراسة مقدمة المحسبة لابن بابشاذ والتعرف على طريقة صياغة التعليل النحوي لديه.
فهل أدت العلة دورها التعليمي في مقدمة المحسبة أم اتخذت دوراً جدلياً معقداً لا يجدي النفع المرجو في تعلم النحو؟ أم أنّ تنوع التعليل عند بابشاذ عالج مشكلة فهم النحو بالإفصاح عن كلام العرب وتعزيز الحكم النحوي؟
وعلى ذلك تم اختيار الموضوع وتقسيم البحث إلى مقدمة وتمهيد وإفراد مضمون البحث إلى أنواع الأسماء الظاهرة تحت أسم الفصل المسمى (فصل الاسم) والتي تنوعت العلل فيه حسب ورودها بالموضوع المدروس. وتضمن التمهيد التعريف بنشأة العلة النحوية وتعريفها لغة واصطلاحاً، وتطورها، والتعرف على حياة المؤلف اسمه وكنيته، ولقبه، وشيوخه، وتلاميذه، ومؤلفاته، ووفاته. وموقفه من المذاهب النحوية وموضوع الكتاب ومنهجه وإسلوبه في التعليل.
أمَا منهج البحث هو المنهج الوصفي التحليلي، فيميز البحث تعليل المؤلف للمسألة النحوية وما يسبقها من أمثلة يقع عليها حكم العلة أو الحكم النحوي، ثم نقل أقوال بعض النحويين لهذه المسائل وتفصيل ما استدلوا به وبيان السبب إن أمكن أو ما ترجح في المسائل. واقتضت هذه الدراسة الاعتماد على مصادر ومراجع كثيرة منها كتب النحو بشكل عام ككتاب سيبويه (ت180هـ) والمقتضب للمبرد ( ت285هـ) ثمار الصناعة في علم العربية لأبي عبدالله الملقب بالجليس( ت490ه)، و شرح المفصل للزمخشري (ت538هـ). ثم الكتب التي أفردت للعلة النحوية ككتاب علل التثنية، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي (المتوفى: 392هـ) وكتاب العلل في النحو لابن الوراق(ت381هـ)، إضافة إلى بعض الكتب والدراسات الحديثة ككتاب العلة النحوية نشأتها وتطورها للدكتور مازن المبارك وكتاب الخلاف النحوي بين البصريين والكوفيين لمحمد خير الحلواني وكتاب الفكر النحوي عند العرب أصوله ومناهجه للدكتور مزهر علي الياسري.
التمهيد (نشأة العلة النحوية وتطورها)
تباينت أقوال الباحثين في بدايات في نشأة العلة النحوية إذ يرى بعضهم أن العلة انمازت نتيجة التأثر بالجانب الفقهي أي تأثروا بعلل الفقه (0). ويرى آخرون أن العلة هي نتيجة تأثر بعض النحاة بالفلسفة وعلم الكلام (0). ويرى فريقٌ ثالث أنها لم تتأثر بعلم الكلام والفلسفة ولا بعلل الفقهاء بل هي وليدة بواعث إسلامية عربية الهدف منها تقعيد وتقنين اللغة وتفسير ظواهرها(0). والحقيقة أن العلة موجودة مع وجود النحو و نشأته؛ وذلك لميل الإنسان وسؤاله عن العلة واستقصاء أسبابها وهذا جانب فطري مع ولادته دون اكتساب له.
مفهوم العلة، تعريفها لغة واصطلاحا.
أولاً: العلّة لُغةً: العِلَّة: الْمَرَض. عَلَّ يَعِلُّ واعْتَلّ، وأعلَّه الله، وَرجل عليل (0). وعلّ يعِلّ ويَعُلُّ من عَلَل الشَّراب، وقد اعتلَّ العليل عِلَّةً صعبة (0). واعْتَلَّ إذَا تمسك بحجة، وَأَعَلَّهُ جَعلهُ ذَا علَّةٍ ومنه إعْلَالَاتُ الْفُقَهاءِ واعتلالاتهم وَعَلّلْتُهُ عَلَلًا من باب طلب سَقَيْتهُ السَّقْيةَ الثانِيَةَ (0). والفعْلُ: علَّ القومُ إبِلَهُم يَعُلُّونها عَلاًّ وعَلَلاً، والإبلُ تَعُلُّ نفسها عَلَلاً، والعلة السبب (هذا علة لهذا أي سبب) (0). والمعنى ها هنا أقرب المعاني اللغوية إلى المعنى الاصطلاحي.
ثانياً:العلة في الاصطلاح: هي تَغْيِير الْمَعْلُول عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ (0). العلةُ هي:" جملة ما يتوقف عليه وجود الشيء، وقيل: هي تمام ما يتوقف عليه وجود الشيء (0). وعرّفها بعضهم بأنها ما يثبت بها الكلام(0) أو العلة: تفسير الظاهرة اللغوية والنفوذ إلى ما وراءها وشرح الأسباب التي جعلتها على ما هي عليه، ويتجاوز الأمر الحقائق اللغوية، ليصل إلى المحاكمة الذهنية (0). وعرّفها الجرجاني( ت816ه) بأنّها ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجا ومؤثراً فيه(0).
ابن بابشاذ النَّحْوِيّ: اسمه، ولقبه، وكنيته.
طَاهِر بن أَحْمد بن بابشاذ أَبُو الحسن النَّحْوِيّ الْمصْرِيّ أحد الْأَئِمّة فِي والأعلام فِي عُلُوم الْعَرَبيّة وفصاحة اللسَان توفي بِمصر سنة تسع وَسِتّينَ وَأَرْبَعمِائة وَقيل سنة اربَع وَخمسين (0).
هو أبو الحسن طاهر بن أحمد بن بابشاذ بن دأوود بن سليمان بن إبراهيم النحوي الجوهري المصري، وقد أشار ابن خلكان إلى أن أصل ابن بابشاذ من بلاد الديلم، وذكر القفطي أن جده أو والده قدم إلى مصر تاجرا وأن أصله من العراق، ووصف الفيروز أبادي في كتاب البلغة ابن بابشاذ بأنه عربي الأصل، كذلك أشار ابن الجزري في ترجمته لأحمد ابن بابشاذ والد طاهر إلى أنه عراقي الأصل(0).
شيوخه: تلقلى ابن بابشاذ العلم عن عدد من الشيوخ، إذ لم يذكر من هؤلاء سوى ثلاثة منهم ومن بينهم والده، وهم: 1- والده أبو الفتح أَحْمد بن بابشاذ النَّحْوِيّ. 2- وأَبو نصر القاسم بن محمّد الواسطي. 3-الحوفي (ت 430 ه) أبو الحسن الحوفي. 4- الخطيب التبريزي( 421-502)(0).
تلاميذه: كان لأبي الحس تلاميذ من أهل مصر ومن أهل الأندلس بعد أن تصدر للتدريس وعلى ذلك حفظت المصادر بعض تلاميذه ومنهم: 1- ابن الفحام 422- 516.2- ابن الحصار 427-511. 3- السعيدي 420- 520. 4- أبو الأصبع الزهري.
مؤلفاته: ولأبي الحسن مصنفات مفيدة تركها ابن باب شاذ وأكثرها في النحو والتي ذاع صيتها بين شروح الكتب النحوية التي أقبل عليها الطلبة يطلبونها ويدرسونها منها:1 - " المقدمة " المشهورة، وشرحها. 2- شرح الجمل " للزجاجي.3- شرح كتاب الأصول لابن السراج. 4- شرح النخبة. 5- شرح الأصول لابن السراج. 6-التذكرة في القراءات السبع. 7- المفيد في النحو. 8- التعليقة (0).
وفاته: أرخ ابن خلكان وفات ابن بابشاذ عشية الثالث من رجب سنة469ه(0).
موقفه من المذاهب النحوية: كان مذهبه بصرياً على حد قول ابن الأنباري أنَ ابن بابشاذ وابن علي بن فضال المجاشعي من حذاق النحاة المصريين على مذهب البصريين(0).
موضوع الكتاب ومنهجه: كان موضوع الكتاب يضم قواعد في النحو والصرف والخط ويعرضها عرضاً واضحاً بلا إيجاز مخل، أما طريقته فتقوم على إيراد النص ثم شرحه (0).
إسلوبه في التعليل: كان يعمد في كتابه على ذكر الحكم النحوي أو الظاهرة النحوية في السياق المدروس ثم يضمن تعليله ويعلل، مثل ذلك: إعراب الأسماء الستة بالحروف كالعوض من حذف لامها(0). فحذفت لاماتها للعوض جاءت العلة هنا علة (علة عوض)، ويسري ذلك عل علة الخفة والشبه والثقل والفرق وأمن اللبس والمعادلة.
فصل الاسم
يُفصّلُ ابن بابشاذ أن اسلوبه في تنظيم الفصل حيث يشتمل على ثلاثة أشياء ما في نفسَه، وما تسميته، وما حكمه، وبهذه الاشياء الثلاثة يظهر كل ما يدور ويفسر في المقدمة، فيقوم بحكمه على اطلاق الحكم بتفسيره للدرس النحوي. وميز الاسم بقوله:" الاسم ما أبان عن مسمى، شخصًا كان أو غير شخص، مثل: رجل وامرأة وزيد وهند ونحوه من المرئيات. وعالم ومعلوم ونحوه من الصفات. وعلم وقدرة وفهم ونحوه من المعاني" (0). والظاهر من التصنيف الذي تصدر مقدمة المحسبة لاسيما الثلاثة فصول أن التقسيم لم يخرج عن سابقيه إذ إن كل كلمة لا تخرج من ثلاثة أشياء اسماً، أو فعلاً أو حرفاً، والعلة في ذلك السماع؛ لأنهم استقروا وتصفحوا أجزاء الكلام وما تركب منه فوجدوها محصورة في هذه التقسم لا تخرج عنه (0). والعلة مبنية للحكم، وكذا العلل هي بجعل جاعل هو باحث النحو لتأييد الحكم الموجود في النص(0). ويُشْرِعُ ابن بابشاذ بتفصيل ما سنه في مقدمته في قسمة الأسماء إلى (ظاهر ومضمر وما بينهما (المُبْهَم) (0).
وعليه قسْمَ الأسماء كلّها ثلاثة: ظَاهرٌ، ومُضْمرٌ، وما بينهما وهو يسمّى المُبهَم، وميز أنواع الأسماء التي أجرى عليها الشرح والتفصيل، إذ يقول (وجْملةُ الأسماء الظاهرة والمعربةِ عشرةُ أنواع ) والتي هي محل دراستنا بتقسيم الفصل على عشرةُ أنواع. وذكر أنها أسماء صحيحة وأسماء معتلة، وأسماء مفردة، وأسماء مضافة وأسماء منصرفة، وأسماء غير منصرفة، وأسماء منقوصة وغير منقوصة، وأسماء مقصورة وغير مقصورة، وأسماء مثناة وغير مثناة، وأسماء مجموعة جمع السلامة، وأسماء مجموعة جمع تكسير(0). أما الصنف الأول من هذه الأسماء الظاهرة هي التي يدخلها الرفع والنصب والجر والتنوين، ولها أنواع عدة من هذه الأسماء، الأسماء المفردة الصحيحة المنصرفة.
أولاً: الأسماء المفردة الصحيحة المنصرفة.
لقد فسر أبو الحسن الأسماء المفردة الصحيحة المنصرفة بأنها نوع أولٌ يدخله الرفع والنصب والجر والتنوين، وقال مفرد احترازاً من التثنية والجمع، لأن اعراب التثنية والجمع بالحروف لا بالحركات ما خلا جمع التكسير إذ أن اعرابه كإعراب الأسماء المفردة، ويعلل الإعراب بالحروف دون الحركات) للتفريق، أم قوله (صحيح) احترازاً هي (علة الاحتراز) من المعتل الذي آخره (ياء خفيفة قبلها كسر) (كالقاضِي والدّعي) أو الألف كالفتى والمولى وهذا لا يدخله رفع ولا جر ثم يعقب بقوله (منصرف) احترازاً من الاسم الذي لا ينصرف مثل (أحمد وأحمر) والعلة فيها لأن الاسم الذي لا ينصرف لا يدخله التنوين والجر، وهذا ما يمكن إدخاله في علة الاحتراز أيضاً على حد قوله، فإن كان بهذا الشرط أي يدخله (الرفع والنصب والجر فضلا عن التنوين) فقد استوعب الإعراب كله لأنه متمكن أمكن (0). (ومن المتمكن الأمكن) قوله: هذا فَلْسٌ، وفَرسٌ، ورأيت فَلْساً، وفَرساً، ومررت بفلْسٍ وفَرسٍ (0).
ويقسمُ النحويون الاسم إلى متمكن وغير متمكن، وأن المتمكن ينقسم إلى متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن: المتمكن الأمكن: هو الذي لا يشبه الفعل ولا الحرف، وهو الاسم المعرب المصروف، أي الذي يقبل التنوين حين يكون نكرة؛ ولذلك يسمى هذا التنوين تنوين التمكين، والمتمكن غير الأمكن: هو الذي يشبه الفعل مثل: أحمد ويزيد وتعز، فهذه الأسماء يمكن أن تكون أسماء ويمكن أن تكون أفعالا، وحيث أن الفعل لا ينون ولا يجر، عوملت هذه الأسماء معاملة الأفعال، وهي الأسماء الممنوعة من الصرف: حضر أحمدُ، رأيت أحمدَ، مررت بأحمدَ، أما غير المتمكن: هو الذي يشبه الحرف، من حيث البنية، ومن حيث المعنى؛ لأن الحرف ليس له معنى في ذاته، وإنما يشير إلى معنى في غيره، فكذلك أسماء الإشارة والأسماء الموصولة (0).
وعلى نسق الأسماء يجمع الشارح جعفر، زِبْرجٍ، بُرْثُنٍ، دِرْهَمٍ، قِمَطْرٍ، وطخْدَبٍ ويكون جمع هذه الأسماء بعدها رباعية، أما العشرة الأول: فَلْسٍ، وفَرَسٍ، وكَتِفٍ، وعَضُدٍ، وحِبْرٍ، وعِنَبٍ، وإِبِلٍ، وقُفْلٍ، وصُرَدٍ، وعُنُقٍ، فهي مختلفة الأوزان ويجمعها أنها ثلاثية كلها، واختتم الأوزان بـ سَفَرجَل، قرطَعْبٍ، جَحْمَرِشٍ، وقذعملٍ بالخماسية مختلفة الأوزان(0).
وهذا ما يعكس مدى دقة بابشاذ في تنظيم الابواب والفصول وتتابع الثلاثي بالرباعي والخماسي حتى يبلغ لهذه الاصول بعشرين مثالاً، ثم يفصّل للإعراب حالتان في حال الوصل، وحال الوقف، فالوصل يقتضي ثبات الإعراب للبيان، والوقف يقتضي زوال الإعراب للإستراحة (0). لذلك قيل إذا وصل الكلام ثبت تنوينه وحركته وإذا وقف عليه سقط حركته وتنوينه، فثبوت الحركة دليل على رفعه أو نصبه أو جره، وكذلك التنوين يعد دليل حذفه ويزول التنوين بزوال الحركة؛ لأنه تابع لها، وبهذا سُكن حرف الإعراب كقولنا: نَفَعني زيدْ في الرفع، وانتفعت بزيدْ بالجر، وفي المتن يذكر (غالباً) فأبان أن في الوقف يسقط التنوين وحركته غالباً، وهذا احترازاً من وجوه أُخر تجيز الوقف على المرفوع في االإشمام والروم والتضعيف، وكأن تعليله بالوصل والوقف على نية الاحتراز، وهذه ما علله ابن بابشاذ على أنها علة الاحتراز(0).
وأما السكون هو الاصل؛ لأنه سالب الحركة بالجملة، وأما الإشمام والروم أو النقل فهو لعلة نسيان الحركة التي كانت في الوصل، فكان ظهور الفتحة لخفتها وهذه العلة( علة خفة) فثبوت الفتحة في الوصل والوقف لعلة خفتها(0).
ثم يلي تصنيفه بعشر أمثلة ثلاثية يجمع فيها أصول الثلاثي كلها بقوله: فَلسٍ، فَرَسٍ، كَتِف، عَضدٍ، حِبْرٍ، وعِنَبٍ، وابِلٍ، وقُفْلٍ، وحُرَدٍ، وعُنُقٍ، إذ يبين سبب ترتيبه للأسماء بهذا الترتيب ويقول: بنت هذا الترتيب؛ لأنه بدأ بالأخف منها فإذا ما عدنا للأول (فَلْس) وجدناه أخفها، فهو مفتوح الأول وساكن الثاني، وكذا: فَرَسٌ فهو أخف من كَتِف؛ لأن مفتوح العين أخف من مكسور العين حتى المثال الرابع هو فتح العين، أما إذا انتقلنا إلى مكسور الأول وساكن الثاني في حِبْرٌ نجده أخف من عِنَب الذي هو أخف من إبِلٍ لأن الكسرة الواحدة أخف من الكسرتين وعلى التوالي نجدها أخف من عُنُق وبهذا اكتملت الأمثلة الثلاثية فوجهُ ترتيبها أن بعضها أخف من بعض على هذا النوع من ترتيب الأسماء(0).
وعلى ذلك يمكن اطلاق تسمية هذه العلة أنها (علة تخفيف) والتي أشار إليها النحاة من قبل، إذ جاء منها في علل النحو لابن الوراق؛ وذلك عند زيادة الألف في جمع المؤنث السالم اذ يقول: والجمع ثقيل فوجب أن يدخل أخف الحروف، فكانت الألف أحق بذلك لخفتها (0).
النوع الثاني: الاسم المفرد الصحيح المنصرف المضاف إلى ياء المتكلم أو ما فيه ألف ولام.
وهذا النوع الثاني، يدخله الرفعُ والنصبُ والجرُّ من غير تنوين، وهو جميع ما ذكرناه إذا كأن مضافاً إلى غير ضمير متكلم، أو فيه ألف ولام، وهذا النوع يتفق مع الأول بدخول الرفع والنصب والجر، إلا أن الأول يكون بتنوين والثاني من غير تنوين، والسبب أنه لم يجمع بين (الألف واللام) لأن الألف واللام دليل التعريف والتنوين في وضعه الأول دليل على التنكير، والإضافة لا يجمع بينها وبين التنكير لذا نقول: نفعني الغلامُ، ونفعتُ الغلامَ، وانتفَعتُ بالغلامِ. والإضافة لا يجمع بينها وبين التنوين، فالتنوين دليلٌ الانفصال، والإضافة عن الاتصال ولا يجتمع الأمران في حال واحد. ولذا نقول: نفعني غلامُ الرجل، وغلامُه، وغلامُكَ. وقوله هذا احترازاً من غلامي إذ أن هذا ونحوه لا يدخله الإعراب بحال والسبب أن ياء المتكلم لا يكون اقبلها إلا مكسوراً إذا كأن حرفاً صحيحاً كما في قولك: نفعني غلامي، ونفعتُ غلامي، وانتفَعتُ بغلامي (0). فقولنا: نفعني غلامُ الرجل، وغلامُه، وغلامُكَ قرنها بلفظ الاحتراز من غلامي حتى يميز ويحترز بين ما يدخله الإعراب من غيره. وهذه العلة هي والتي عبر عنها ب(علة الاحتراز).
النوع الثالث: الممنوع من الصرف.
وهذا النوع (يدخله الرفعُ والنصبُ ولا يدخله الجرُّ ولا التنوين، وهو كلُّ اسم غيرِ منصرف مما قد اجتمع فيه علتان فرعيتان من عللٍ تِسع، أو ما يقوم مقامها. مثل: إبراهيمَ، وزينبَ، وطلحةَ، وعُمَرَ، وعثمان، وأحمدَ، وحضرموتَ، وأحمرَ، وحمراءَ، وأحادَ، وسكران، وسكرى، ومساجدَ) يمثل هذا النوع من الأسماء، الأسماء غير المنصرفة، وهي ما ينقصها الجر والتنوين وهذا النقص لعلة أن كل اسم لا ينصرف مشبه للفعل لا جر ولا تنوين، وسبب شبه الفعل اجتماع علتين فرعيتين فيه، من قبل أن الفعل فرع على الاسم ويعود الشبه إلى وجهين الأول: أن الفعل لا يستقل بنفسه ولابد للاسم معه وبذلك هو فرعٌ على الاسم، والثاني: أن الأفعال مشتقة من المصادر، وهذا من بين الأشارات على تأثره بالبصريين بجعل الفعل مشتق من المصدر، وبهاذين العلتين يصبح الاسم مشبه بالفعل وفرعُ عليه، وعليه يكون التعليل للشبه بين الفعل والاسم هو (علة الشبه) التي قربت بينهما(0).
النوع الرابع: جمع المؤنث السالم
يميز سيبويه جمع المؤنث السالم فيقول: تخالف الألف والتاء في جمع المؤنث السالم الواو والنون، والياء والنون في جمع المذكر السالم في أشياء، فإن التاء في جمع المؤنث يجري عليها حركات الإعراب؛ كقولك: هؤلاء مسلمات، ورأيت مسلمات، ومررت بمسلمات (0).
وهذا النوع الرابع فهوما يدخله الرفعُ والجرُّ مع التنوين، أو ما قام مقامه، وهو كل اسمٍ مؤنثٍ مجموعٍ بالألف والتاء، مثل: الزَّيْنَبَاتِ والمسلماتِ والحبلياتِ والصَّحْراواتِ، ولا يدخله لفظ النصب، ويدخل هذه الأسماء الرفع والجر مع التنوين، الزيَنبَاتِ المسلماتِ، الحَليماتِ والصحراواتِ، ولا يدخلها النصب وهذا النوع يدخله الخبر مخالفا لما قبله، لأن لفظ الجر والعلة على أن المنصوب هنا محمول على مجرور، ومجرور مالا ينصرف محمول على النصب الزيَنبَات المسلماتُ، الحَليماتِ وهذا يجتمع في عله أن جمع المؤنث السالم فرع (محمول) على جمع المذكر السالم، والعلة هنا علة (حمل أوعلة نظير) كما وجهها العلماء فقالوا: رأيت الزيدين حملاً على مررت بالزيدين، ورأيت الهندات (0). كذلك حُمل منصوب جمع المؤنث على مجروره. وأشار سيبويه بأن حمل جمع المؤنث على جمع المذكر، في أن جعل للرفع علامة يفرد بها وللنصب والجر علامة واحدة اشتركا فيها كقولك: جاءني مسلمات، ورأيت مسلمات، مررت بمسلمات (0).
والنوع الخامس: المنقوص
وهذا النوع (خامس يدخله النصب وحده مع التنوين أو ما قام مقامه من ألف ولام أو وهذا النوع خامس يدخله النصب وحده مع التنوين أو ما قام مقامه من ألف ولام أو إضافة، ولا يدخله رفعٌ ولا جرٌّ، وهو كلُّ اسمٍ منقوصٍ آخره ياء خفيفة قبلها كسر، مثل: القاضِي وقاضٍ والمعْطِي والمُنْتَمِي والمُسْتَدعِي، إذ يرى شارح المقدمة أن امتناع دخول (الرفع والجر) على هذه الأسماء لثقلها على الياء المكسورة ما قبلها؛ ولذلك سمي منقوصاً؛ لأنه نقص حركتين وأبقى على حركة واحدة في حال النصب، فإن قلنا: هذا قاضٍ، ومررت بقاضٍ ففيه عاملاً، حذف حركة، وحذف حرف، ففي الحركة حُذفت الضمة أو الكسرة وحذفت للثقل، فالمراد بالحرف (الياء) حذفت لالتقاء الساكنين، والساكنان التنوين والياء، فالعلة هنا علة (ثقل) أي ثقل بقاء حركة وحرف لذا حذفت لثقلها(0).
والعلة في هذا الموضع علة (ثقل) أي ثقل الحركة والحرف والتي أشار لها غير قليل من النحويين أمثال ابن الوراق، وقال علة الثقل أو الاستثقال: وهي أن يستثقلوا عبارة أو كلمة أو حرفا أو حركة (0).
أما في النوع السادس من الأسماء التي يدخلها التنوين وحده ولا يدخله رفع ولا نصب ولا جر هو كل اسم مقصور أخره ألف مفرده مثل: العَصَا وعَصاً والمعطي، إلا أنه لم يعلل أن تسمية الاسم المقصور مقصوراً؛ لأنه قصر على الإعراب كله حبس عنه مالم يدخله رفع ولا نصب ولا ج، وامتناعه لأن الالف ساكنه لا تتحرك وتحريكها يردها لأصلها وردها لأصلها يؤدي لثقل استعمالها فأصل عصاً، عَصَوٌ وفي (فتىً) فتيٌ(0).
ونرى أن ترجيح الشارح لبعض الأوجه يظهر في قوله: قسْ على ذلك تصب أن شاء الله أو فأعرف ذلك تصب أن شاء الله(0). ويميل الطاهر بن أحمد بن بابشاذ أحياناً إلى الإحالة في شرحه بعض المسائل التي يرى أن تفصيلها يكون أتم في فصل أو صنف لاحق كما في قوله: وسترى ذلك مبيناً في فصل العوامل أن شاء الله تعالى(0).
النوع السابع: الاسم المقصور.
وعرف ابن يعيش الاسم المقصور بأنه: ما في أخره ألف نحو العصا (0) وهذا النوع يدخله التنوين وحده، أو ما قام مقامه من ألف ولام، أو إضافة، ولا يدخله رفعٌ ولا نصبٌ ولا جرٌّ، وهو كلُّ اسمٍ مقصورٍ آخره ألف مفردة، مثل: العَصَا وعَصا، والمُعْطَى والمُنْتَمَى إليه والمُسْتَدْعَى، فما يعلل به من أن الاسم المقصور، مقصور لأنه قصر على الإعراب كله أي حُبس عنه فلم يدخله رفعٌ ولا نصبٌ ولا جرٌّ، وامتناعه لأن الألف ساكنةٌ لا تتحرك وتحريكها يردها لأصلها، وردها لأصلها يؤدي لثقل استعمالها فأصل عصىاً عَصَوٌ(0).
النوع السابع: ما أخره ألف تأنيث مقصور
وهو ما كَانَت أَلفه للتأنيث؛ نَحْو: حُبْلَى، وسكرى فقد تقدم قَوْلنَا فِيهِ أَنه لَا ينْصَرف فى معرف وَلَا نكرَة وَأما مَا كَانَت الْألف فِيهِ زَائِدَة للإلحاق فمصروف فى النكرَة؛ لِأَنَّهُ مُلْحق بالأصول، وممنوع من الصّرْف في الْمعرفَة؛ لِأَن أَلفه زَائِدَة كزيادة مَا كَانَ للتأنيث (0). وهذا النوع لا يدخله تنوين ولا إعراب، وهو مع ذلك اسم معربٌ حُكْمًا وتقديرًا، وهو كل اسمٍ آخره ألف تأنيث مقصورة مثل: حُبْلَى وسَكْرَى وذِكْرَى وجُمَادَى، ويفرد صاحب المقدمة نوعًا سابعًا لا يدخله تنوين ولا اعراب وهو مع ذلك اسم معرب حُكْمًا وتقديرًا، يرى الطاهر أن هذه الأسماء معربه مع عدم ملازمة الإعراب فيها وعدم التنوين، وهنا يذكر عللاً لكون الاسم معرب:
أولها: أنه لم يشبه الحرف فيكون مثل الاسم الموصول (الذي، التي)
ثأنيها: لم يتضمن معنى الحرف فيكون مثل أسماء الاستفهام (اينْ، كيفَ)
ثالثها: لم يقع موقع الفعل المبني فيكون (نزالِ)، (تراكِ)
وبما أن هذه العلل الثلاث الموجبة للبناء لم تقترن بهذه الأسماء تجعلنا نحكم ببنائها فأصبحت معربة، ويمكن أن نطلق على هذه العلل الثلاث: (علة فرق)، اذ ميزت المعرب عن المبني، وقد عرفت (علة الفرق): أنها علة تتصل بقصد الإبانة(0). وهذه العلل قد فرقت بين المبني والمعرب كما ورد. وعلل بعد ذلك أن الف التأنيث لا يدخلها إعراب ولا تنوين بأي حال، ويعلل أنها من جملة ما لا ينصرف، وبالطبع أن كل ما لا ينصرف لا ينون بأي حال من الأحوال ولا ألفها منقلبة عن شيئ بلا المقصور قبلها، ويرى أن من قال:هذه دنيًا وكذلك حُبَليً وكذا قول القائل: صُلاةٌ، ودنْياهٌ خطأ، ويرى السبب ؛ أنه جمع بين علامتي تأنيث، وذلك غير جائز)(0).
النوع الثامن: الأسماء الستة
ذهب الكوفيّون إلى أن الأسماء الستة المعتلّة وهي: أبُوكَ، وأخُوكَ وحَمُوكَ، وهَنُوكَ، وفُوكَ، وذو مال مُعْرَبَة من مكانين. وذهب البصريون إلى أنها معربة من مكان واحد، والواو والألف والياء هي حروف الإعراب. وإليه ذهب أبو الحسن الأخفش في أحد القولين(0). وهذا النوع يكون (رفعه بالواو، ونصبه بالألف، وجره بالياء، وهي ستة أسماء معتلةٍ مضافةٍ إلى ظاهر أو مضمر ليس بمتكلم)، مثل قولك: أخوه، وأبوه، وحَموه، وفُوه، وهَنُوه، وذو مالٍ، وتعد الأسماء السته معربة بالحروف خلافا للأسماء السالفة من الأسماء المعربة بالحركات لفظًا أو تقديرًا، أما التعليل في كونها معربة بالحروف وكونها مضاف، لأنها أسماء اعربت لاماتها وضمنت معنى الإضافة فجعل اعرابها بالحروف كالعوض من حذف لامها(0). ولأنها أسماء حذفت لاماتها للعوض وبهذا تكون العلة هنا عند الطاهر علة (علة عوض) أي يعوض الاسم بالضمير عوضًا عن اللام المحذوف من هذه الأسماء، والأصل بالإعراب أن يكون بالحركات والإعراب بالحروف فرع عليه (0). واختلف النحاة في إعراب هذه الأسماء، وذكر السيوطي اثني عشر مذهب مذهبًا في إعراب الأسماء الستة(0). والمشهور من هذه المذاهب أنها معربة بالحروف لمناسبة هذه الحروف لعلامات الإعراب الاصلية(0). فالواو نائبة عن الضمة والألف نائبة عن الفتحة والياء نائبة عن الكسرة، وعلل الجليس إعراب هذه الأسماء بالحروف بدل الحركات بقوله:( وأُعربت هذه الأسماء بالحروف توطئة للتثنية والجمع) (0). لقد وضح ابن يعيش وهذه التوطئة بقوله: وقال قومٌ إنما اعربت هذه الأسماء توطئة لإعراب التثنية والجمع بالحروف، وذلك، لأنهم لما اعتزموا التثنية والجمع بالحروف جعلوا بعض المفردة بالحروف حتى لا يستوحشوا الإعراب في التثنية والجمع السالم بالحروف (0). وصارت هذه الأسماء أولى بالتوطئة من غيرها لأن هذه الأسماء لا تنفك من إضافة المعنى والاضافة على المفرد، فالمفرد أصل والإضافة فرع عليه كما أن التثنية فرع على الواحد فهما مشتركان في الاصل، فكانت أولى من غيرها في هذا الحكم، أما الوجه الثاني أن هذه الأسماء تفرد في اللفظ فيصير اعرابها بالحركات نحو قولك: هذا ابٌ، ورأيت أباً، ومررت بأبٍ فقد لزمت أوساطها الحركات فلما ردوها إلى أصلها في الاضافة وقد كانت أوساطها تدخلها حركات الإعراب أرادوا أن يبقوا على هذا الحكم فيها ليدل بذلك على أنها مما يصح أن يعرب بالحركات في حال الافراد فوجب أن يضموا أوساطها في الرفع فلما ضموا وسطها أنقلب أخرها واوًا ؛ لأن أصلها (فَعَل) فحقُ أواخرها أن تقلب ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها، والألف متى أنضم ما قبلها صارت واوًا وكذلك إذا انكسر ما قبلها صارت ياءً فلهذا وجب أن تختلف أواخر هذه الأسماء(0). وقال ابن يعيش جُعل اعرابها بالحروف كالعوض من حذف لاماتها (0). وهذا ما علل به ابن بابشاذ بقوله: لأنها أسماء حذفت لاماتها للعوض.
النوع التاسع: المثنى
أوجز الزمخشري بتعريف المثنى فقال: وهو ما لحقت آخره زيادتان: ألف أو ياء مفتوح ما قبلها، ونون مكسورة، لتكون الأولى علماً لضم واحد إلى واحد، والأخرى عوضاً مما منع من الحركة والتنوين الثنتين في الواحد(0). ويرفع بالألف، وينصب ويجر بالياء المفتوح ما قبلها، وهو كلُّ اسمٍ مُثَنَّى، مثل: الرجلَينِ والمرأتَينِ، العلة في إعراب التثنية بالحروف أن المثنى اكثر من الواحد فيجعل إعرابه بشيء أكثر من الواحد، ولا أكثر من الحركة إلا الحرف، والعلة في اختصاص المرفوع بالألف دون الواو، التي هي علامة الرفع، أنهم لو اعربوا المثنى في الرفع بالواو لالتبس بالجمع وهنا تسمى (علة أمن اللبس) (0).
والقياس في الإعراب أن يكون في الحركات الضمة للرفع، والفتحة للنصب، والكسرة للجر(0). إلا أن ثمة أسماء جاءت على غير القياس فأُعربت بالحروف بدل الحركات، والقياس في الإعراب أن تكون الواو للرفع، والألف للنصب، والياء للجر لمجانسة الواو للضمة والألف للفتحة والياء للكسرة، إلا أن المثنى جاء مخالفًا للقياس من وجهين الأول: أنهُ إعرب بالحروف والقياس والإعراب بالحركات، والوجه الثاني: أن علامة الرفع فيه هي الألف والقياس أن تكون علامة الرفع الواو (0).
أما جمع المذكر السالم في حالة الرفع فقد خالف القياس من وجهٍ واحد وهو الإعراب بالحرف بدل الحركة، وقد علل الجليس رفع المثنى بالألف والجمع بالواو العلة في اختصاص رفع التثنية بالألف هو رفع الجمع الموصوف بالواو، إنّ التثنية أعم ثم أن الألف أخف، والواو أثقل فجُعل الأخف مع الأثقل، والأثقل مع الأخف لتقع المعادلة(0). فالعلة هنا هي (علة معادلة)، وقد سبق ابن جني إلى هذا التعليل بقوله:" فجعلوا الألف الخفيفة في التثنية الكثيرة وجعلوا الواو الثقيلة في الجمع القليل ليقل في كلامهم ما يستثقلونه ويكثر ما يستخفونه" (0). فتعليل الجليس يوافق تعليل ابن جني سوى بعض الاختلاف البسيط بقوله: فجعل الأخف مع الثقل والاثقل مع الأخف والظاهر أن الجليس يريد بالأثقل الأكثر وقوله: الأخف يريد به الأقل بدليل قوله:" ولهذه العلة بعينها وجب رفع الفاعل ونصب المفعول لأن الفاعل نوع واحد والمفعول أكثر من نوع"(0). أما سيبويه فقد رفع المثنى بالألف ويكون في الرفع ألفًا ولم يكن واوًا ليفصل بين التثنية والجمع(0). فالعلة عند سيبويه هي علة (فرق)(0). وتعليل الجليس كون الالف والياء في المثنى هي حروف الإعراب هي علة(تشبيه)، وعلل ابن الوراق بأن الألف في التثنية والواو في الجمع، والياء في التثنية والجمع هي حروف الإعراب بقوله: " وإنما وجب أن تكون هذه الحروف حروف اعراب لأن معنى الكلمة إنما يكتمل بها وصارت آخر حرف في الاسم، وبهذا وجب أن تكون حروف الإعراب " (0). والعلة عند الوراق علة (تشبيه) إلا أن ما يلاحظ أن التشبيه يختلف بين ابن الوراق والجليس بأن ابن الوراق شبه هذه الحروف بالأصلية في الاسم.
النوع العاشر: جمع المذكر السالم
وميز النحويون جمع المذكر ومنهم القاسم بن علي بأنه كلُّ جَمعٍ صح فيه واحده ثم أتَى بعد التَّنَاهي زائده فرفعه بالواوِ والنونُ تبَع نحوُ شَجَاني الخَاطِبُونَ فِي الجُمَعْ، ونصبُهُ وجرُّهُ بالياءِ عندَ جميعِ العَرَبِ العَرْبَاءِ(0). ويكون جمع المذكر السالم" رفعه بالواو المضمومِ ما قبلها ما لم يكن آخره ألفاً، ونصبه وجرّه بالياء المكسور ما قبلها ما لم يكن آخره ألفاً أيضاً، وهو كلُّ جمعٍ لمذكرٍ عَلَمٍ يعقل. أو لصفات من يعقل، مثل: الزيدينَ والمسلمينَ"، إنما كان رفعه بالواو لأنه أكثر من التثنية فجعل إعرابه في الرفع بحرف أقوى واثقل وهو الواو المضموم وهذه تسمى (علة المعادلة) التي ذكرها الجليس في تقسيماته للعلة (0).
الخاتمة:
بما أن العلة جاءت ملازمةً لنشأة النحو إلا أن أوائل النحاة لم يقصروا استنباط العلة عليهم، إذ يفسح الخليل كما مرَّ في الإيضاح للزجاج أن من أورد تعليلاً أليق من تعليله فليأت به، وهذا ما سلكه المتأخرون، إذ عمل النحاة ومنهم بابشاذ باسلوب الوصف والتحليل التعليمي لشرح المقدمة المحسبة التي يعرض فيها قواعد النحو عبر عرض النص ثم التعقيب عليه وشرحه ليزيد الفهم ويرسخ الحكم على سنن العرب. فيمكن إيجاز اهم نتائج البحث بما يأتي.
1- تعد العلة في شرح المقدمة مشوبة بغموض لا يميزها الدارس بصورة يسيرة حتى يدركها في درج الكلام، فتعبر عن الحكم الوارد في العلة ومحلها إذ يورده بألفاظ منها قوله: احترازاً أو للفرق أو للشبه.
2- يسوق بابشاذ العلة من دون التصريح بها لتفسير الحكم النحوي الذي يشكل به الدرس النحوي.
3- لم يكن بابشاذ مجرد ناقل للأحكام والعلل النحوية بل نراه يرجح ويورد في قوله: وقسْ على ذلك تصب إن شاء الله.
4- يتفق بابشاذ مع كثير من النحاة لاسيما البصريون منهم في التعليل النحوي لمسائل متنوعة ومن الذين تأثر بهم سيبويه، إذ يظهر ذلك حتى في أسلوبه وترجيحه لأقوالهم مثل جعل أصل الفعل هو المصدر.
5- يتباين رأي بابشاذ في كثير من المسائل النحوية حتى يكاد ينفرد بها وهذا يدل على نضوج عقلية ابن بابشاذ في النحو.
6- تنوع العلل عند ابن بابشاذ كعلة العوض والمعادلة والتشبيه والفرق وأمن اللبس أو علة نظير، والثقل، والخفة أو التخفيف والاحتراز، ويردُّ بعضها دون تصريح بها على أنها علة بل باللفظ كالترك للخفة أو الاحتراز، وبهذا التحديد يتميز جهد ابن بابشاذ التعليمي لطلاب العلم والدارسين من تلاميذه ومن تلاهم وتزود من علمهم، وهذا ما تخصص في فصل واحد هو فصل الاسم، فكيف بمن ولج فصول شرح المحسبة.
قائمة المصادر والمراجع:
- أصول النحو العربي: محمد خير الحلواني، دار الأطلسي، الرباط، 1983.
- أصول النحو العربي في رأي النحاة ورأي بن مضاء وضوء علم اللغة الحديث، محمد عيد، عالم الكتاب.
- الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين: عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري، أبو البركات، كمال الدين الأنباري (ت: 577هـ): المكتبة العصرية، الطبعة: الأولى 1424هـ- 2003م.
- التطبيق النحوي، عبده الراجحي، المعارف للنشر والتوزيع.
- التعريفات: علي بن محمد بن علي الجرجاني (ت816هـ)، تحقيق: إبراهيم الأبياري- دار الكتاب العربي – بيروت، ط1، 1405هـ.
- الفكر النحوي عند العرب أصوله ومناهجه: الدكتور علي مزهر الياسري، الطبعة الأولى، الدار العربية للمطبوعات، بيروت ـ لبنان، 2003م.
- الكتاب، عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أبو بشر، الملقب سيبويه (ت: 180هـ)، تح عبد السلام محمد هارون، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1977.
- الكليات: أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي أبو البقاء الحنفي (ت 1094 هـ)، تحقيق: عدنان درويش ـ محمد المصري، مؤسسة الرسالة بيروت ـ لبنان.
- المحكم والمحيط الأعظم: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (ت: 458هـ)،تحقيق: عبد الحميد هنداوي- دار الكتب العلمية – بيروت، ط 1، 1421 هـ - 2000 م.
- المفصل في صنعة الإعراب: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله (ت: 538هـ)
- المقتضب، محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالى الأزدي، أبو العباس، المعروف بالمبرد (المتوفى: 285هـ)، مراجعة أميل يعقوب، دار الكتب.بيروت لبنان، ط1، 1999.
- الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة «من القرن الأول إلى المعاصرين مع دراسة لعقائدهم وشيء من طرائفهم»، جمع وإعداد: وليد بن أحمد الحسين الزبيري، إياد بن عبد اللطيف القيسي، مصطفى بن قحطان الحبيب، بشير بن جواد القيسي، عماد بن محمد البغدادي: مجلة الحكمة، مانشستر – بريطانيا، الطبعة: الأولى، 1424 هـ - 2003 م.
- النحو العربي (العلة النحوية نشأتها وتطورها): د. مازن المبارك- المكتبة الحديثية- ط1- 1385هـ- 1965م.
- الوافي بالوفيات،صلاح الدين الصفدي تح: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث – بيروت.
- تهذيب اللغة: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري(ت370هـ)، حققه: محمد عوض مرعب- دار إحياء التراث العربي - بيروت، دمشق، ط1، 2001م.
- ثمار الصناعة في علم العربية لأبي عبدالله الحسن بن موسى بن هبة الله الدينوري الملقب بالجليس ت490ه، تح محمد بن خالد الفاضل، دار الثقافة والنشر جامعة الامام ابن سعود الاسلامية1990.
- حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك: أبو العرفان محمد بن علي الصبان ( ت 1206 هـ )، دار احياء الكتب العربية، مصر.
- رسالة الحدود: علي بن عيسى بن علي بن عبد الله، أبو الحسن الرماني المعتزلي (ت: 384هـ)، تحقيق: إبراهيم السامرائي- دار الفكر – عمان.
- شرح ابن عقيل. قاضي القضاة بهاء الدين عبدالله ابن عقيل الهمداني، تح: محي الدين عبد الحميد، مكتبة الهداية.بيروت لبنان، ط1، 2008.
- شرح الأشموني علي بن محمد بن عيسى، أبو الحسن، نور الدين الأُشْمُوني الشافعي (المتوفى: 900هـ)، دار الكتب العلمية بيروت- لبنان.
- شرح المقدمة المحسبة: طاهر بن احمد بن بابشاذ (ت 469 هـ)، تحقيق: خالد عبد الكريم، الطبعة الأولى، المطبعة العصرية الكويت، 1976م.
- شرح كتاب سيبويه: أبو سعيد السيرافي الحسن بن عبد الله بن المرزبان (ت: 368 هـ)، تحقيق: أحمد حسن مهدلي، علي سيد علي، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.
- شرح المفصل للزمخشري، تأليف موفق الدين أبي البقاء ابن يعيش، تح:أميل يعقوب، دار الكتب.بيروت لبنان، ط1، 2001م.
- علل التثنية، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي (ت: 392هـ)،تح: الدكتور صبيح التميمي،مكتبة الثقافة الدينية – مصر.
- علل النحو: أبو الحسن محمد بن عبدالله الوراق (ت 381 هـ)، تحقيق: ت ت محمود جاسم درويش
- لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري (ت:711هـ)- دار صادر– بيروت، ط1.
- مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو: الدكتور مهدي المخزومي، مطبعة، المعارف، بغداد1955م.
- ملحة الإعراب: القاسم بن علي بن محمد بن عثمان، أبو محمد الحريري البصري (ت: 516هـ)، دون تح: دار السلام - القاهرة/ مصر، الطبعة: الأولى، 1426هـ -2005م
- نزهة الألباء في طبقات الأدباء: كمال الدين عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري أبو البركات الأنباري (ت 577 هـ)، تحقيق: ابراهيم السامرائي، الطبعة الثانية، مكتبة المنار، الزرقاء ـ الأردن، 1985م.
- همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، جلال الدين السيوطي (المتوفى: 911هـ) تح عبد الحميد هنداوي، المكتبة التوفيقية.
- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي (ت: 681هـ) تحقيق: إحسان عباس: دار صادر – بيروت، تحقيق: د. علي بو ملحم، مكتبة الهلال – بيروت، الطبعة: الأولى، 1993.
0) ينظر: الفكر النحوي عند العرب أصوله ومناهجه: الدكتور علي مزهر الياسري، الطبعة الأولى، الدار العربية للمطبوعات، بيروت ـ لبنان، 2003م.: ص257.
0) ينظر: النحو العربي (العلة النحوية نشأتها وتطورها): د. مازن المبارك- المكتبة الحديثية- ط1- 1385هـ- 1965م: ص51.
0) ينظر: مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو: الدكتور مهدي المخزومي، مطبعة، المعارف، بغداد1955م.: ص41.
0) المحكم والمحيط الأعظم: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (ت: 458هـ)،تحقيق: عبد الحميد هنداوي: ج1، ص 94.
0) تهذيب اللغة: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري(ت370هـ)، حققه: محمد عوض مرعب- دار إحياء التراث العربي - بيروت، دمشق، ط1، 2001م.:ج1، ص80.
0) تهذيب اللغة: ج2 ص426.
0 () لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري (ت:711هـ)- دار صادر– بيروت، ط1.: ج11ص471.
0) رسالة الحدود: علي بن عيسى بن علي بن عبد الله، أبو الحسن الرماني المعتزلي (ت: 384هـ)، تحقيق: إبراهيم السامرائي- دار الفكر – عمان: ص 67.
0) التعريفات: علي بن محمد بن علي الجرجاني (ت816هـ)، تحقيق: إبراهيم الأبياري- دار الكتاب العربي – بيروت، ط1، 1405هـ.: ص 154.
0) ينظر: الكليات: أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي أبو البقاء الحنفي (ت 1094 هـ)، تحقيق: عدنان درويش ـ محمد المصري: ج1 ص 621.
0) أصول النحو العربي: محمد خير الحلواني، دار الأطلسي، الرباط، 1983: ص 108.
0) التعريفات للجرجاني: ج1 ص 154.
0) الوافي بالوفيات، صلاح الدين الصفدي تح: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث – بيروت. ج16 ص224.
0) شرح المقدمة المحسبة: طاهر بن احمد بن بابشاذ (ت 469 هـ)، تحقيق: خالد عبد الكريم، الطبعة الأولى، المطبعة العصرية الكويت، 1976م ج1 ص7-8.
0) المحسبة ص17- 18.
0) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي (ت: 681هـ) تحقيق: إحسان عباس: دار صادر – بيروت، تحقيق: د. علي بو ملحم، مكتبة الهلال – بيروت، الطبعة: الأولى، 1993.ج2 ص515. المحسبة ص25، 28، 40، 41. الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة «من القرن الأول إلى المعاصرين مع دراسة لعقائدهم وشيء من طرائفهم»، جمع وإعداد: وليد بن أحمد الحسين الزبيري، إياد بن عبد اللطيف القيسي، مصطفى بن قحطان الحبيب، بشير بن جواد القيسي، عماد بن محمد البغدادي: مجلة الحكمة، مانشستر – بريطانيا، الطبعة: الأولى، 1424 هـ - 2003 م.ج2 ص 1073.
0) المحسبة /22.
0) نزهة الألباء في طبقات الأدباء: كمال الدين عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري أبو البركات الأنباري (ت 577 هـ)، تحقيق: ابراهيم السامرائي، الطبعة الثانية، مكتبة المنار، الزرقاء ـ الأردن، 1985م:
ص 263.
361. المحسبة ص 60.
0) المحسبة: ص45.
0) المحسبةج1ص119.
0) ينظر ج 1ص94.
0) ينظر: ثمار الصناعة في علم العربية لأبي عبدالله الحسن بن موسى بن هبة الله الدينوري الملقب بالجليس ت490ه، تح محمد بن خالد الفاضل، دار الثقافة والنشر جامعة الامام ابن سعود الاسلامية1990. ص 139.
0) ينظر: أصول النحو العربي في رأي النحاة ورأي بن مضاء وضوء علم اللغة الحديث، محمد عيد، عالم الكتاب. ص144.
0) ينظر المحسبة ج1، ص98.
0) ينظر المحسبة ج1، ص99- 100.
0) ينظر: المحسبة ج1، ص101
0) ينظر: المحسبة ج1، ص101
0) ينظر: التطبيق النحوي، عبده الراجحي، المعارف للنشر والتوزيع،ج1ص148.
0) ينظر: المحسبة ج1، ص101- 102.
0) ينظر المحسبة: ج1، ص103.
0) ينظر المحسبة: ج1، ص104.
0) ينظر المحسبة: ج1، ص104.
0) ينظر المحسبة: ج1، ص 100-101 .
0) ينظر: علل النحو: أبو الحسن محمد بن عبدالله الوراق (ت 381 هـ)، تحقيق: ت ت محمود جاسم درويش: ص66.
0) المحسبة: ج1، ص105.
0) لمحسبة: ج1، ص106.
0) ينظر: شرح كتاب سيبويه: أبو سعيد السيرافي الحسن بن عبد الله بن المرزبان (ت: 368 هـ)، تحقيق: أحمد حسن مهدلي، علي سيد علي، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.: ج 1، ص 145.
0) ينظر: العلل النحوية، حميد القلي: ص59.
0) ) ينظر: شرح كتاب سيبويه: ج1، ص 145.
0) ينظر: المحسبة: ج1، ص113.
0) ينظر: علل النحو: ص69.
0) ينظر: المحسبة: ج1، ص 116.
0) ينظر المحسبة: ج1، ص119- 118.
0) المحسبة: ج1، ص 149.
0) ينظر: شرح المفصل للزمخشري، تأليف موفق الدين أبي البقاء ابن يعيش، تح:أميل يعقوب، دار الكتب.بيروت لبنان، ط1، 2001م ج 4 ص33.
0) ينظر: المحسبة: ج1، ص 116.
0) ينظر: المقتضب، محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالى الأزدي، أبو العباس، المعروف بالمبرد (المتوفى: 285هـ)، مراجعة أميل يعقوب، دار الكتب. بيروت لبنان، ط1، 1999:ج، 338.
0) ينظر: علل النحو: ص 67.
0) ينظر: ج1، ص 119.
0) الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين: عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري، أبو البركات، كمال الدين الأنباري (ت: 577هـ): المكتبة العصرية، الطبعة: الأولى 1424هـ- 2003م.: ج1، ص 17.
0) المحسبة: ج1، ص.119.
0) ينظر: شرح المفصل: ج 1، ص152.
0) ينظر: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، جلال الدين السيوطي (المتوفى: 911هـ) تح عبد الحميد هنداوي، المكتبة التوفيقية: ج1، ص 135.
0) ينظر: شرح ابن عقيل. قاضي القضاة بهاء الدين عبدالله ابن عقيل الهمداني، تح: محي الدين عبد الحميد، مكتبة الهداية. بيروت لبنان، ط1، 2008: ج1، ص44.
0) ثمار الصناعة: ص 227.
0) شرح المفصل: ج1، ص 153.
0) علل النحو: ص214.
0) شرح المفصل: ج1، ص 153.
0) المفصل في صنعة الإعراب: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله (ت: 538هـ): ص 229.
0) المحسبة: ج1، ص.128.
0) المقتضب: ج1، ص 52.
0) حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك: أبو العرفان محمد بن علي الصبان ( ت 1206 هـ )، دار احياء الكتب العربية، مصر: ج1، ص66.
0) ثمار الصناعة: ص230.
0) علل التثنية، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي (ت: 392هـ)،تح: الدكتور صبيح التميمي،مكتبة الثقافة الدينية – مصر: ص 71.
0) ثمار الصناعة: ص230.
0) الكتاب، عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أبو بشر، الملقب سيبويه (ت: 180هـ)، تح عبد السلام محمد هارون، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1977: ج1، ص17.
0) ثمار الصناعة: ص223.
0) العلل في النحو: ص234.
0) ملحة الإعراب: القاسم بن علي بن محمد بن عثمان، أبو محمد الحريري البصري (ت: 516هـ)، دون تح: دار السلام - القاهرة/ مصر، الطبعة: الأولى، 1426هـ -2005م: ص 19-20.
0) ينظر المحسبة: ج1، ص 133.
|
Waleed Faiadh Hasan Aljuboury || The grammatical explanation of Ibn Babshath in his book Sharh Al-Mahsebah (Fasl Al-Ism as a model) || Ibn Khaldoun Journal for Studies and Researches || Volume 2 || Issue 7 || Pages 240 - 261. |
0 |
| Article Title | Authors | Vol Info | Year |
| Article Title | Authors | Vol Info | Year |