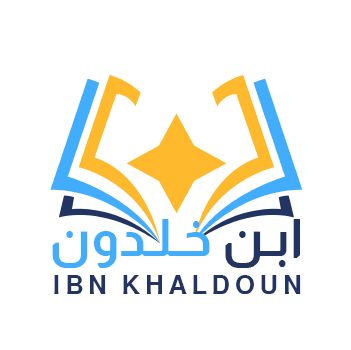2
7
2022
1682060055167_2330
https://drive.google.com/file/d/1YS_P_Avd8DhXkj4sWw8hs89HNlVa-Nvc/view?usp=sharing
Non-Islamic religious urban monuments and coping mechanisms: A reading of the Fatimid state's handling
م.د. شاكر عويد نفاوة: قسم معلم الصفوف الأولى، كلية التربية الأساسية، جامعة ذي قار، العراق
Abstract:
The research aims to identify the fact that the Fatimid state deals with the effects of non-Islamic religious construction, especially since it is one of the countries that advocated the application of the principles of Islamic law, as the effects of urbanization for non-Islamic nations and the nature of dealing with them is one of the most important principles of application of the Muhammadan Sharia that the Prophet Muhammad came (And the importance of his dealings with it in a manner consistent with what the Noble Qur'an came with, and the nature of his dealings with those effects. Therefore, the research came to shed light on the statement of the mechanism of the Fatimid state's dealing with the effects of non-Islamic religious construction and to stand on the most important data that resulted from that interaction.
Keywords: Fatimid state, urban monuments, Muslims, Christians, Fatimid caliphs
المقدمة:
إنَّ الآثار العمرانية واحدة من أهم الموضوعات التي طرحها القرآن الكريم وأشار لها في آياته المباركة، بل وأوضح لنا طبيعة تعامله مع تلك الآثار العمرانية خصوصاً الدينية منها، إذ أنها تشكل مرتكزاً مهماً في حياة الأنسان لأنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحياته ومعتقده الديني.
لذا يمكن القول أنَّ طبيعة التعامل مع تلك الآثار جاء بشكل متباين ومختلف بحسب معطيات المرحلة التي تمر بها الدول والأمم التي عاصرت وجود تلك الآثار، ومن ثم نجد أن هذا التعامل قد أنسحب لأجيال لاحقة وأصبح التعامل معها منسجم مع توجهات تلك الدول وطبيعة حكمها ومعتقداتها الدينية، إذ أن اختلاف المعتقد الديني قد أسهم في إعطاء مساحة واسعة كان نتاجها تعاملاً فكرياً مخالفاً للطرح القرآني وما جاءت به الشريعة المحمدية من مبادئ وتعاملات دينية.
يمكن القول وخلال المدة التي تلت عصر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أصبحت النظرة والتعامل مع الاثار الدينية تشكل خطراً واضحاً، لأنها أصبحت تهدد أمن وحياة الأمم غير الإسلامية، على أساس انه أصبح يُنظر لكل شاخص حضاري أو أنساني بأنه دلالة للشرك والوثنية وعامل من عوامل غطاء العقيدة الدينية.
ومن ثم نجد وحسب ما طرحناه في بحوث سابقة بأنه أصبح التعرض لتلك الآثار متناغماً لمعتقد هذه الدولة أو تلك، متناسين ما جاءت به الشريعة المحمدية من تعاملات مع تلك الآثار. الأمر الذي أسهم في ولوج نتائج سلبية أضرت بمبادئ الإسلام المحمدي الأصيل.
ومن خلال تلك التعاملات وما جاءت به الدول الإسلامية أصبح على الباحث الوقوف على بيان طبيعة تعامل الدولة الفاطمية مع آثار العمران غير الإسلامية وأهم المعطيات التي أسهمت في ذلك التعامل والوقوف على أهم المرتكزات الشرعية التي استندت إليها في تعاملها مع تلك الآثار والتي سنوضحها في ثنايا البحث.
مشكلة الدراسة:
تُعد الآثار العمرانية ذات البعد الديني واحدة من أبرز الموضوعات التي تناولها الذكر القرآني وأشار إليها في أغلب آياته المباركة؛ لما لها من أهمية واضحة وجلية، إذ أنها تشكل مرتكزاً مهماً من مرتكزات الدراسات الأكاديمية لتوضيح معناها وشرعية وجودها، نظراً لأرتباطها بحياة الإنسان وطبيعة تعامله معها.
ومن ثم فقد تعددت الدراسات التاريخية حول طبيعة تعامل الدول الإسلامية مع آثار العمران للأمم غير الإسلامية، خصوصاً تلك التي ترتبط بعقيدة الإنسان من آثار دينية لها أهميتها الحضارية وأبعادها الروحية، حيث تجسدت تلك المعالم الأثرية بطبيعة حركة الإنسان وتعامله معها، الأمر الذي أنتج معتركاً عقدياً حول طبيعة فهمه لها وأصل وجودها، وهذا الأمر أسهم بولوج فكر مخالف للنظرة القرآنية حول ضرورة بقائها من عدمه، فتعاملت بعض الدول الإسلامية بشكل سلبي أعتمدت على الهدم الكلي لتلك الآثار ومحوها، كونها دلالة للشرك والوثنية بحسب زعمهم، مما ادى ذلك الفعل إلى خروج عن أصل الإسلام وعدم فهم المقاصد الحقيقية للرسالة الإسلامية إذا ما علمنا أنه تعامل بإيجابية مع تلك الآثار. فضلاً عن أنَّ القرآن الكريم حافلاً بذكر تلك الآثار العمرانية وبيان أهميتها الدينية وانعكاساتها الإيجابية. لذا يمكن أن نلخص مشكلة البحث من خلال التساؤلات الآتية:
-
هل أن الدولة الفاطمية تعاملت بشكل سلبي مع آثار العمران الدينية للأمم غير الإسلامية؟.
-
ما هي آليات تعامل الدولة الفاطمية مع أهل الذمة ومراكزهم الدينية؟.
منهجية الدراسة:
أعتمد الباحث في دراسته على المنهج التاريخي الذي يجسد الاحداث وبيان حقيقتها العلمية، فضلاً عن أعتماد المنهج التحليلي لأغلب المرويات التاريخية ومقارنتها بالدلائل والقرائن التاريخية على أسس منهجية تعتمد على النقد والتحقيق من صحتها وترتيبها وفقاً لأسس منطقية للتوصل إلى حقائق علمية لفهم طبيعة وأهمية الدراسة.
أهمية الدراسة:
تمثل الآثار العمرانية الدينية للأمم غير الإسلامية منطلقاً فكرياً أسهمت في بيان الحقيقة الدينية لها وإيجاد سياسة تميز طبيعة تعامل الأمم الإسلامية معها.
ومن ثم يمكن القول إن أهمية الدراسة المأخوذة من نتاج ما ذكرناه من مضمون العلاقة بين الدولة الفاطمية واهل الذمة ما هي إلا أهمية بُنيت على أساس ذكر طبيعة التعامل، والذي كان ذو وجهين لمختلف حكام الدولة الإسلامية. فكل حاكم بنى علاقته مع اهل الذمة حسب ما رآه من سابقية ممن سبقه في الحكم. أما كان مقلداً لهم بالمثل في المعاملة وكان ذات سلوك حسن معهم وأتم معهم الصلح وبناء ما كان لهم من آثار دينية وأخذ بيدهم بالمشورة وغيرها، أو أنه كان حاكماً أستبد برأيه الخاص ونمّى موقفه السياسي بشكل سلبي بتعامله معهم. أو أنه قسى في بداية حكمه ثم أستلهم رخاوة المعاملة فيما بعد لينتج الصلح في نهاية الأمر الذي كوّن نوع من اللين والعنف في سياسته هو الآخر.
وما كان لنا إلا أن نبين نتاج دراسة كونت طبيعة التعامل بين الدولة الفاطمية وأهل الذمة حسب ما كان من سياسة متبعة عكس لنا أهمية الأخذ منها لضرورة الفهم والعلم بالشيء لضرورة تاريخية.
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى جملة من النقاط أهمها:
-
بيان طبيعة تعامل الدولة الفاطمية مع آثار العمران الدينية للأمم غير الإسلامية، خصوصاً وأنّ هناك دراسات بينت طبيعة تعامل الدول الإسلامية مع تلك الآثار بشكل سلبي، أنتجت معتركاً فكرياً بين المذاهب والأديان السماوية.
-
تعدد أدوار مختلفة ذُكرت نحو آلية التعامل من قبل الحكام الفاطميين آنذاك، والتي أختلفت فيما بينهم، من مقيد متشدد تارةً، وبين مساير متودد تارةً أخرى.
-
بيان أهمية الدين الإسلامي كونه خاتم الاديان من جهة، وبين طبيعة تعامله الطيب مع بقية الأديان السماوية من جهة أخرى.
المبحث الأول: آلية التعامل الفاطمي مع أهل الذمة
الذمة في اللغة هي العهد والأمان والضمان. وأهل الذمة هم المستوطنون في بلاد الإسلام من غير المسلمين؟ وسموا بهذا الاسم لأنهم دفعوا الجزية فأمنوا على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم؟ وأصبحوا في ذمة المسلمين. وكانت تقاليد الإسلام تقضي بأنه إذا أراد المسلمون غزو إقليم وجب عليهم أن يطلبوا من أهله اعتناق الإسلام؟ فمن استجاب منهم طبقت عليه أحكام المسلمين ومن امتنع فرضت عليه الجزية (0). وهذا ما اشار له القرآن الكريم: (قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ)[التوبة: 29].
يمكن القول إن المجتمعات غير الإسلامية كانت تشكل نسبة كبيرة في مصر وكان غالبيتهم من الأقباط (0)، وهذا ما أشار له المقدسي بقوله: " أن عامة أهل مصر نصارى يقال لهم الأقباط ويهود قليل " (0)، فضلاً عن فئات أخرى كان يشكلها المجتمع المصري من أهل الذمة مثل النسطورية (0) والملكانية (0) واليعقوبية (0). وبما أن أساس الوجود الفاطمي في مصر، لذا ينبغي الإشارة الى وجود هذه الفئات والتي شكلت الغالبية العظمى من سكان مصر معقل الفاطميين لذا تمحورت طبيعة تعامل الخلافة الفاطمية معهم كونهم يشكلون النسبة الأكبر من السكان، الأمر الذي يتطلب دراسة آلية التعامل الفاطمي مع هذه الفئات وحسب المعطيات والدلائل التي أشارت لها كتب التاريخ.
من أهم المرتكزات الأساسية لحكم الدولة الفاطمية هو البناء العقدي الذي تأسست عليه هذه الدولة، إذ يتبين لنا من خلال مطالعة تاريخ هذه الدولة وطبيعة حكمها للدولة الإسلامية أنها جاءت لنشر الدين الإسلامي الصحيح الذي جاءت به سنة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، وهذا ما يوضحه لنا الشهيد الأول بقوله: "وكان (الفاطميون) شيعة اسماعيلية، سعوا كثيراً لنشر التشيع في (مصر وإفريقيا) والأقطار الأخرى التي كانت تحت يدهم"(0). مما يعني أنها نادت بنشر تعاليم الدين الصحيح الذي سعى إليه أهل البيت (عليهم السلام) لتثبيت معالم الشريعة الإسلامية بين صفوف المسلمين. وبما ان الشيعة الإمامية هم من يتمثل بآل البيت (عليهم السلام) ويسيروا بحسب نهجهم المتمثل بتعاليم السماء وما جاءت به السنة النبوية من تعاليم دينية، لذا يمكن القول إن الدولة الفاطمية وهي واحدة من الدول الموالية التي جاءت لنشر الدين بين صفوف المجتمعات الإسلامية خصوصاً تلك التي سيطروا عليها.
ومن خلال ذلك يمكن أن نبين طبيعة تعامل الدولة الفاطمية مع المجتمعات غير الإسلامية، إذ توضح لنا كتب التاريخ جملة من المعطيات التي توضح طبيعة هذا التعامل الذي يتماشى مع سياستها الدينية وما يفرضه عليها الواقع السياسي الذي يرجح حقيقة التعامل الإيجابي دون غيره من تعاملات خارجة عن نطاق الشريعة الإسلامية.
إنَّ سياسة الخلفاء الفاطميين وطبيعة تعاملهم مع أهل الذمة قد استندت في طبيعتها إلى أصل الفعل النبوي وما أحدثه من تعامل معهم بضرورة احترامهم وعدم مضايقتهم في ممارسة حياتهم الدينية والاجتماعية وغيرها.. فضلاً عن عدم ظلمهم في كل التعاملات، لما لهم من حقوق على المسلمين، إذ جاء في قول الرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) محدثاً عن اهمية هذا الجانب بقوله: " ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة " (0). فهو تحذير للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في ضرورة معاملتهم برفق وعدم ظلمهم، لذا جاء تعاملات الدولة الفاطمية مطابقة لتوجيهات الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وما فرضه على المسلمين.
أن أولى اهتمامات حكام الدولة الفاطمية وطبيعة تعاملهم مع البلدان غير الإسلامية هو ما يفرضه الواقع السياسي والديني عليهم من توجهات، إذ بعد توسع الدولة الفاطمية واستقرارها في مصر سنة (358 هـ/968 م)(0)، بدأ حكام الدولة الفاطمية بتأسيس علاقة طيبة مع المجتمع وتحديداً مع النصارى، إذ توضح لنا المصادر بأن حكام الدولة الفاطمية بدأوا بتقريب النصارى منهم وأشغالهم بمناصب لها أهميتها في سياسة الدولة (0)، مما يعطي إيحاءً لنا بدور حكام الفاطميين في جذب هذه الطوائف وتقريبها من المسلمين، والذي بدوره يحقق سياسة الأمن والاستقرار لها.
تنوعت المناصب الإدارية التي شغلها أهل الذمة في الدولة الفاطمية من خليفة لآخر وحسب الحاجة لهم في تولي تلك المناصب، فقد كان الخليفة الفاطمي المعز لدين الله (341 هـ- 365 هـ/ 951 م – 974 م) يعتمد اعتماد كبير عليهم في إدارة أمور الدولة لما لهم من خبرة كبيرة أسهمت في اعتماد الخلفاء عليهم، وهذا يُبين لنا حقيقة التسامح الديني الكبير الذي أظهره الخليفة من منحهم تلك المناصب الإدارية في الدولة، إذ كان أغلب موظفي الدولة الفاطمية من اهل الذمة دون أن يشترط عليهم اعتناق الإسلام (0)، ولذلك تذكر المصادر أنه عين يعقوب بن كلس (0) على أمر الخراج فضلاً عن مناصب تخص الجانب الاقتصادي ولها أهميتها في جمع الأموال من أهل الذمة وجعلها في خزينة الدولة، ومن ثم نال نصيباً كبيراً من الثقة والمحبة وتقريبه من الخليفة الفاطمي المعز لدين الله (0). فضلاً عن ما ذكرته المصادر بتولي ابن كلس أمور الوزارة خلال حكم المعز لدين الله (0). إلا أن المصادر أختلفت في تحديد السنة التي تسلم بها الوزارة (0). مما يعني أنه من الشخصيات التي نالت ثقة الخليفة الفاطمي بتوليه هذه المناصب المهمة في الدولة الفاطمية، فضلاً عن سياسته وحنكته في تسلم أكثر من منصب في الدولة.
ولم يقتصر الأمر على تولي ابن كلس هذه المناصب في عهد الخليفة الفاطمي فحسب، بل هناك العديد من الشخصيات المهمة من أهل الذمة نالت مكانة لدى الحكام الفاطميين وأشغلوهم في مناصب مهمة في الدولة الفاطمية (0).
من الجدير بالذكر أن تولي أهل الذمة المناصب المهمة في الدولة الفاطمية له دلالة واضحة على سياسة الخلفاء الفاطميين في استقطاب أهل الذمة للاستفادة من خبراتهم المتراكمة في إدارة أمور الدولة خصوصاً وأنها حديثة التأسيس، الأمر الذي يتطلب أعتماد الخلفاء الفاطميين على ذوي الخبرة منهم لإدارة الدولة، وذلك للحفاظ على النظام الإداري من الأنهيار، إذ أن تولي أشخاص لا تمتلك من الخبرة الإدارية في مناصب الدولة بمنعى زوال النظام الإداري للدولة خصوصاً وأنها حديثة العهد، لذا استخدم الخلفاء سياسة تقريب أهل الذمة منهم وإعطائهم الثقة الكبيرة لتسيير أمور الدولة بكل انسيابية ومن دون تلكؤ.
ومن ضمن سياسة الخلفاء الفاطميين وتعاملهم مع أهل الذمة أنهم عملوا على تقريبهم باستخدام شتى الوسائل والأساليب والتي تدلل على طبيعة التعامل الجيد مع أهل الذمة من غير المسلمين، إذ توضح لنا المصادر التاريخية بأن الخلفاء الفاطميين عملوا على مصاهرة أهل الذمة، وهذا الأمر له أثر بارز في تقريبهم من جهة وتعزيز قوة الدولة الفاطمية بالعناصر المسيحية من جهة أخرى، فقد كانت زوجة العزيز بالله الفاطمي رومية الأصل (0). في حين كانت أم الخليفة المستنصر جارية لأبي سعيد التستري (0) أهداها للخليفة الظاهر (0).
أن أهم خطوة للتقارب (الإسلامي المسيحي) هي عملية المصاهرة بين الطرفين ؛ لما لها من دلالة واضحة على حسن المعاملة وزيادة أواصر الألفة والمحبة بينهم، فالمصاهرة هي التقارب الروحي والنفسي الذي يجعل النفس الانسانية في حالة من الراحة والطمأنينة. الأمر الذي يعكس لنا سياسة الحكام بضرورة التقارب بينهم وبين أهل الذمة من خلال تلك المصاهرة، إذ يتوضح لنا أن تقريبهم من هذا الجانب له دلالة على حنكة الحكام الفاطميين والذي يعكس لنا دواعي هذا التقارب وانعكاساته الإيجابية للدولة الفتية التي جاءت لتمثل شرع الله في الأرض بغض النظر عن سياسة الحكام وتفاوتها في التعامل.
والقرآن الكريم يؤكد لنا طبيعة الزواج من أهل الكتاب وشرعيته، قال تعالى:(وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) [المائدة: 5].
إنّ هذه الآية بغض النظر من رأي المفسرين فيها واختلافاتهم التفسيرية لها تؤكد لنا شرعية النكاح من أهل الكتاب. لذا فالحكام الفاطميين ومصاهرتهم من أهل الذمة مستند على حقيقة قرآنية والتي من شأنها تبعد الشكوك في صحة تعاملهم خصوصاً الزواج منهم. فضلاً عن انعكاساته الإيجابية التي انعكست بشكل كبير في احتواء أهل الذمة وكسبهم لصالح تسيير أمور الدولة الفاطمية.
من الأمور المهمة التي توضح لنا آلية تعامل الحكام الفاطميين مع النصارى من اهل الكتاب هو مشاركتهم أفراحهم ومناسباتهم الدينية بشكل ينسجم مع الواقع المعاش وطبيعة السياسة التي اعتمدوا عليها في تقريبهم من السلطة.
يشير القلقشندي بأن للنصارى أربعة عشر عيداً دينياً منها سبعة تسمى بالأعياد الكبار ومنها ما يسمى بالأعياد الصغار (0).
لذا كان الحكام الفاطميين قد سمحوا لأهل الذمة بممارسة طقوسهم وأعيادهم الدينية والاحتفال بها، فعلى سبيل المثال كان الخليفة المعز لدين الله (341 هـ– 365 هـ/ 952 م – 976 م) قد سمح لهم بالاحتفال في عيد النوروز (0)، وقد شاركهم فيه ومن معه من الدولة الفاطمية والذي استمر لمدة ثلاثة وكان من مظاهره هو اللعب بالماء وإيقاد النيران(0).
ولم يكن المعز لدين الله وحده من الخلفاء الفاطميين من شارك النصارى بهذا العيد فحسب، بل يوضح لنا المقريزي دور الحاكم الفاطمي الآمر بأحكام الله (495 هـ– 525 هـ/ 1101م – 1129م) بمشاركة أهل الذمة بعيد النوروز أيضاً فضلاً عن مشاركة كبار رجال الدولة الفاطمية هذه المناسبة معهم(0).
ولم يقتصر الأمر على عيد النوروز فحسب، بل هناك بعض الأعياد المهمة التي لها أثر كبير في نفوس أهل الذمة وما يتعلق بحياتهم الدينية، والتي من شأنها أن تأخذ حيز كبير من ممارساتهم وتقاليدهم حسب الاعراف التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم، ومنها عيد الغطاس (0)، الذي شارك به الخلفاء الفاطميين أهل الذمة ومارسوا معهم هذه المناسبة بشكل يتلائم مع طبيعة تلك الممارسات، فقد روي أنَّ الخليفة الظاهر (544 هـ- 549 هـ/ 1149 م – 1154 م) قد شارك أهل الذمة مع رجالات دولته بهذا العيد (0).
مما يعني أن الخلفاء الفاطميين لم يضيّقوا الخناق على أهل الذمة بغض النظر عن ممارساتهم ومخالفتها للدين الإسلامي، والدليل على ذلك أن عيد الغطاس كان يمارس به شرب الخمر والغناء (0) وهي ممارسات لا تمت للدين الإسلامي بأية صلة، إلا أن الخلفاء الفاطميين سمحوا لهم بممارسة تلك الأعياد والمناسبات دون الضغط عليهم والتشدد وفرض تعاليم الإسلام عليهم. إلا بعض الحالات التي تشدد بها بعض الحكام الفاطميين (0) وانعكست على تعاملهم مع النصارى والتضييق عليهم في ممارسة حقوقهم المشروعة والمتفق عليها، (حسب الوثائق والمعاهدات التي عقدها المسلمون الأوائل معهم)(0).
في حين سمح الفاطميين لأهل الذمة من الاحتفال بعيد الفصح (0)، وهو من الاعياد المهمة عندهم والذي يسمى بعيد القيامة وهو العيد الكبير عند النصارى الذي يعتقد المسيحيون من خلاله أن السيد المسيح (عليه السلام) قام بعد صلبه ودخل على تلاميذه وسلم عليهم وأوصاهم ببعض الأمور المهمة ثم صعد إلى السماء(0.
ولم تنتهِ ممارسات وأعياد النصارى بما ذكرناه آنفاً، بل هناك الكثير من الأعياد والمناسبات الدينية التي مارسوها خلال الحكم الفاطمي والتي لها أثر واضح وجلي في نفوسهم (0).
إنّ هذه المناسبات بما تحمله من صفات ودلائل وأهمية على الرغم من مشاركة بعض الخلفاء فيها، إلا أنه هناك آلية تدلل على طبيعة التعامل الفاطمي مع النصارى والتي كانت تسير بشكل متفاوت من خليفة لآخر، إذ لم تكن تعاملاتهم بنفس الكيفية خصوصاً بعض التعاملات مع المناسبات والطقوس التي كان النصارى يبالغون فيها عند الاحتفال بها، فلم يكن التسامح في التعامل ومشاركة النصارى أفراحهم ومناسباتهم الدينية بشكل مستمر، بل تبين لنا بعض المصادر بأن بعض الخلفاء الفاطميين قد منعوا النصارى من ممارسة بعض احتفالاتهم نتيجة لما يصحبها من مخالفات دينية كبيرة وما تظهره من أعمال تسيء للدين الإسلامي وهذا الأمر ما نلاحظه حينما قام الخليفة العزيز بالله (365 هـ- 386 هـ/ 975 م – 996 م) بمنع النصارى من احتفالهم بعيد الصليب (0) ومنعهم من ممارسة اللهو والإفراط به (0). كذلك شدد الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله تعامله مع النصارى في احتفالهم بعيد الصليب وممارسة طقوسهم فيه (0). فضلاً عن تشدد الخليفة الفاطمي العزيز بالله مع النصارى ومنعهم من ممارسة الاحتفال بعيد الغطاس (0) لما فيه من سلوكيات مخالفة للشرع والعرف الاجتماعي المعروف لدى المجتمعات التي تتصف بالخلق الرفيع والتعامل السمح الذي يدلل على سمو مكانة وعرف الدين الإسلامي والتي ربما تنعكس سلباً على العادات المعروفة عند المسلمين.
يمكن القول أن هذه التعاملات التي صدرت عن الخلفاء الفاطميين مع النصارى واهل الذمة كانت متفاوتة من خليفة لآخر وحسب المعطيات التي تصاحب الظرف الذي يعيشه الخليفة الفاطمي فضلاً عن طبيعته ومزاجه في التعامل، لا سيما أن الإطار العام لهذه التعاملات كانت إيجابية، وهو الأساس الذي عرف عن المسلمين والإسلام الحقيقي، مصداقاً لقوله تعالى: (قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ) [آل عمران: 64]، وقال تعالى: (وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ) [العنكبوت: 46].
هذه الآيات بمجملها تحاول أن تكسب أهل الكتاب واحتوائهم وكسبهم للدخول إلى الدين الحق الذي جاء به الله تعالى، لذا كانت تعاملات الرسل والأنبياء بمجملها إيجابية مع المخالفين للرسالة السماوية، الأمر الذي سار عليه الغالبية العظمى ممن سار على نهج الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) لكسب أهل الذمة وعدم معاملتهم بما يخالف الشرع الإلهي.
ومن ثم نجد أن الخلفاء الفاطميين كانت معاملاتهم في أغلبها إيجابية فقد قربوا النصارى منهم وكسبوهم إلى جانبهم فأعطوهم المناصب العليا في الدولة وأطلقوا عليهم الألقاب الكبيرة وصاهروهم فضلاً عن مشاركتهم في كل شيء من مناسبات وطقوس وأعياد دينية.
وختاماً يمكن القول إن تعامل الفاطميين قد أتسم بالتسامح والمحبة بحسب ما جاء من تعاليم الدين الإسلامي المتمثلة بالسماحة والمحبة والألفة بين المجتمعات كافة دون التمييز والتفريق بينها(0).
ويمكن أن نعزو سبب هذا التعامل الطيب إلى جملة من الأسباب التي من أهمها:
-
إنّ تعاملهم السمح هذا ربما جاء تطبيقاً لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) حينما قال في عهده لمالك الأشتر بأن الناس صنفان إما أخ لك في الدين وإما نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل(0). بمعنى انه (عليه السلام) كان يوعز لمالك الأشتر بضرورة التسامح في التعامل مع كل الناس بغض النظر عن المعتقد والقومية، مؤكداً على كونه انسان وينبغي معاملته برفق ولطف دون استعمال العنف والقسوة معه.
-
يبدو أنّ نتاج هذا التعامل يشكل نوعاً من الاستغلال الفكري من الفاطميين، فكما هو معروف أن الدولة الفاطمية قد أسست حديثاً وبُنيت على أسس ربما تحتاج إلى خبرات وشخصيات لها أثرها في الدولة من حيث قيادة الدولة وتسيير أمورها، لا سيما وما كان يعرف عن النصارى بأنهم ذوي خبرة في أغلب مفاصل الدولة، فضلاً عن غالبية سكان مصر الذين هم من أهل الذمة وهو الأمر الذي يدعونا بالقول إلى ضرورة احتواء الفاطميين لأهل الكتاب بحسب الحاجة الفعلية لهم.
-
أو أنها قد بُنيت على أساس هذا التعامل بما أخذوه من تعاليم دين إنساني متسامح يأخذ على عاتقه صفة التراحم وزرع الود بين المجتمعات ليكونوا في النهاية ذا نظرة إسلامية سمحت بتطبيق تعاليم الدين الإسلامي ليعكس أثره على باقي الدول الإسلامية ليحذو حذوهم في التعامل.
-
أو ربما هو أمان وهمي وهبه الفاطميون لأهل الكتاب تحت غطاء أقنعة لها غايات وجدت في نفوسهم والتي لها إشارات مستقبلية أنما الغاية منها الاستفادة منهم بشكل مجمل بكل مفاصل الدولة، أي ان المصلحة العامة للدولة كانت تقتضي منهم التعامل بهذه الطريقة الطيبة.
المبحث الثاني: آلية التعامل الفاطمي مع الآثار الدينية غير الإسلامية
إنَّ أهم الآثار التي يمكن أن نشير لها في هذا البحث هي تلك الآثار التي أتسمت بالجانب العبادي والديني للأمم غير الإسلامية والمخالفة للدين الإسلامي في تعاملاتها وعباداتها، ومنها الكنائس والبيع والأديرة والتي لها اثرها المعنوي على نفوس المجتمعات غير الاسلامية، وأن طبيعة التعامل معها له انعكاسات مستقبلية على الدين الإسلامي، لذا ينبغي أن يكون التعامل معها ضمن طابع الدين الإسلامي الحقيقي ومستمد حقيقة تعامله من القرآن الكريم والسنة النبوية، لا ان يكون التعامل معها خاضع لاجتهادات شخصية من هذا الحاكم أو ذاك كما جاء في تعامل الدولة الأموية مع آثار العمران الدينية لغير المسلمين والتي كانت تعاملات سلبية انعكست بشكل سلبي على الاسلام والمسلمين (0).
من خلال مطالعة تاريخ الدولة الفاطمية وطبيعة تعاملهم مع الآثار الدينية لغير المسلمين نجد أنها كانت تتسم بالتفاوت في التعامل بين الإيجابي والسلبي، والذي نقصده بالإيجابي هو إبقاء آثارهم الدينية دون التعرض لها أو هدمها حسب ما ورد في القرآن الكريم من تعامل مع آثار الأمم القديمة التي عذبها الله وأبقى آثارهم دون أن يمسسها سوء أو أذىً، قال تعالى: (وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ) [ العنكبوت: 38 ]، فضلاً عن قوله تعالى: (وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الأَمْثَالَ) [إبراهيم: 45] (0).
أن هذه الآية ما هي إلا دليل واضح على التفريق بين القوم الظالمين وبين مساكنهم التي لم يصيبها أي شيء من عذاب الله تعالى. في حين أشارت آيات أخرى وبشكل واضح على بقاء الآثار العمرانية للأمم المكذبة والمشركة دون التعرض لها لا سيما بعد عذابهم من الله تعالى، وهذا ما يمكن ان نستدل عليه من خلال قوله تعالى: (تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ) [الأحقاف: 25]. فالآية توضح لنا كيف دمّر الله تعالى قوم عاد وكل ما فيها من البشر والدواب والأموال ولم يبقَ إلاّ مساكنهم فهي سالمة لم يمسها شيء من العذاب (0). وهذا يعني أنَّ الله تعالى قد فرّق بينهم وبين منشآتهم العمرانية التي لم يصيبها شيء. فالأثر العمراني لم يكن له ذنب في مسألة تعذيب تلك الأمم، والأهم من ذلك أن الله تعالى أبقى تلك الآثار لتكون عبرة وموعظة للبشرية، لذلك ابقاها الله للأمم اللاحقة دون أن يشملها الله بالزوال والتدمير.
هناك العديد من الآيات القرآنية التي تدلل على هذا المعنى لا نريد الإسهاب بها بقدر ما نريد أن نركز على الهدف الأساسي منها، وهو أن مصدر التشريع الإلهي قد أشار بضرورة بقاء الآثار العمرانية خصوصاً الدينية منها وعدم المساس بها، بل وضرورة حمايتها ولو تطلب الأمر بالقتال وهذا ما أشار له القرآن الكريم قال تعالى: (وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ)[الحج: 40].(0).
فإذا كان الله تعالى قد أبقى مساكن وآثار الأمم السالفة دون التعرض لها أو هدمها، لذا ينبغي أن يكون التعامل مع الآثار الدينية إيجابياً دون المساس بها او هدمها لأنها معالم عبادية الغاية منها هو العبادة بحسب معتقدات الأمم وبمختلف دياناتها.
تميزت سياسة خلفاء الدولة الفاطمية في التعامل مع الآثار الدينية بالإيجابية، إذ تشير المصادر التاريخية بأنهم عملوا على بناء الكنائس التي تم هدمها بل وحتى الكنائس القديمة التي كانت بحاجة إلى ترميم، فعلى سبيل المثال لا الحصر طلب بطريك النصارى من الخليفة الفاطمي المعز لدين الله بتجديد وبناء كنيسة القديس مرقوريوس التي تسمى بأبي سيفين (0)، وكذلك الكنيسة المعلقة (0)، ومن ثم اعطى المعز أموالاً للبطريك لبناء تلك الكنائس وترميمها (0). وحينما أعترض بعض المسلمين من قيام النصارى ببناء تلك الكنائس وترميمها أثار غضب الخليفة الفاطمي المعز لدين الله، الأمر الذي أسهم منه بمتابعة عملية البناء وحماية النصارى والبنائين أثناء قيامهم ببناء الكنائس (0). مما يعني سماحة الخليفة المعز في هذا الجانب دون التعرض لهم او اعتراضهم في عملية البناء. وهو الحال في خلافة العزيز لدين الله الذي سمح للنصارى بترميم كنائسهم وبنائها دون التعرض لهم أو مضايقتهم من قبل المسلمين، وهذا الأمر يدلل على سلمية الفاطميين وإيجابية التعامل مع أهل الذمة.
لم يقتصر الأمر على عملية البناء والسماح لهم بترميم كنائسهم، بل بعض المرويات تشير بأن كنيسة النسطورية قد تعرضت إلى النهب خلال قيام الخليفة العزيز لدين الله بجهاد الروم، الأمر الذي أدى بالخليفة بأنزال العقوبة بحق المسلمين الذين نهبوا تلك الكنيسة، وأمر برد ما تم نهبه منها (0). مما يعني محاولته الإبقاء على سلمية التعامل معهم دون الخوض بتفاصيل سلبية تنعكس على واقع الدين الاسلامي الحنيف الذي عُرف عنه بتعامله السمح مع المجتمعات كافة.
أن موقف الخليفة العزيز لدين الله هذا له دلالة وإيحاءً بالتعامل الإيجابي مع كنائس النصارى وعدم التعرض لها، وهو الأمر الذي يدعونا إلى القول بسلمية التعامل حتى مع الأثر العمراني ذات الصبغة الدينية خلافاً لما عرفناه من تشدد من قبل المسلمين في تعاملهم مع كنائس النصارى خلال الحكم الأموي والعباسي اللذان تعاملا بسلبية مع تلك الآثار.
أما في خلافة الحاكم بأمر الله فقد اختلفت سياسته مع النصارى ومع كنائسهم فكان تعامله بشكل سلبي من خلال ما ورد منه من سلوكيات لها دلالة واضحة بالهدم الكلي لكنائسهم وبيعهم وعدم السماح لهم ببنائها، إذ اشارت بعض المرويات بأنه قد أمر بهدم الكنائس والبيع ومصادرة كل ما يتعلق بها من أموال وجعلها ملكاً للدولة (0). في حين أشارت بعض المرويات أن الحاكم بأمر الله قد تشدد في سياسته مع النصارى فأمر بهدم العديد من الكنائس والأديرة ومنها كنيسة القيامة (0).
إن تشدد الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله مع أهل الذمة يمكن أن نعزوه إلى جملة من الأسباب ومنها:
-
من أهم الاسباب وراء هذا التشدد هو ما يعلله لنا المقريزي بقوله: "كثير منهم كان قد تمكن من أعمال الدولة حتى صاروا وزراء وتعاظموا لاتساع أحوالهم وكثرة أموالهم، فأشتد بأسهم، وتزايد ضررهم، ومكابدتهم للمسلمين فأغضب الحاكم ذلك، وكان لا يملك نفسه إذا غضب " (0).
-
ولربما كان سبب نفوره منهم وسوء معاملته السيئة معهم التي لا تشبه سابقيه من الحكام الفاطميين إلى رؤيته الشاملة حول ماهية القوة التي تمتلكها الدولة الفاطمية والتي اراد لها العزة وعدم الخضوع لهذه الفئة من النصارى، لذا تشدد عليهم وفرض سيطرته ليعلمهم بقوة وقدر هذه الدولة.
-
أو هي نتيجة عكسية لما رآه من عادات وتقاليد قام بها أهل الذمة، ورآها لا تمت للإسلام بأية صلة، الأمر الذي اسهم منه بأبعاد هذه السلوكيات عن مجتمعه الاسلامي وحرصه الشديد من المضي بالدين الإسلامي الحنيف نحو تحقيق الهدف الذي فرض من أجله.
-
ولا نستبعد سياسته المتشددة ومخالفته لمن سبقه من الحكام للمضي بها قدماً حتى يجعل من تاريخ تسلمه للخلافة الفاطمية فترة مميزة تختلف عن باقي فترات حكم السابقين له.
ومن الجدير بالذكر أن سياسة الحاكم بأمر الله المتشددة في معاملة النصارى لم تستمر، فقد غيّر من سياسته اتجاههم دون معرفة الاسباب الرئيسة لذلك التعامل، إذ تشير المرويات بأنه أمر بإعادة بناء الكنائس التي تم هدمها وأعاد إليها أوقافها (0). في حين سمح للنصارى بإعادة بناء كنيسة القيامة أيضاً، مما يعني أنه سمح لهم بممارسة حياتهم الدينية دون ان يتعرض لهم. وهو الحال حينما سمح لبطريك النصارى من بناء وتعمير كنائسهم وأعاد كل ما يتعلق بها من اوقاف (0). فضلاً عن قيامه بإعادة ما تم أخذه من الذهب والفضة من هذه الكنائس (0)، وكذلك أمره بإعفاء كثير من املاك كنائس النصارى واوقافها من دفع الضرائب والرسوم المفروضة عليها من غرامات (0).
أن هذه السياسة وطبيعة تغيرها لم تُشر لها المصادر، ولكننا يمكن أن نعزوها إلى جملة من الاسباب نشير إلى أهمها:
أن أولى قرارات الدين الاسلامي المتبعة أنه دعا إلى عدم المساس بالديانات المخالفة للإسلام وينبغي احترامها واحترام اصحابها على اعتبارها ديانات جاءت على يد أنبياء لتمثل شرع الله في الارض، وعلى الرغم من أن الدين الإسلامي جاء آخر الأديان السماوية وهو من أتمت فروضه على باقي الديانات، إلا أنه بقيت تلك الديانات مستمرة وباقية إلى يومنا هذا لا يمكن تغييرها أو الفرض عليها، مصداقاً لقوله تعالى: (لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ...) [البقرة: 256]، خصوصاً الديانة المسيحية فهي باقية إلى هذه اللحظة.
وانطلاقاً من هذه النقطة وسماحة الدين الإسلامي نرى تأثر بعض الحكام الفاطميين بهذه الخاصية وعدول أغلبهم عن معاملته السيئة لأصحاب هذه الديانات، قد تميزت تلك المعاملة عن غيرهم من الحكام السابقين في التسامح مع أهل الذمة وممارسة كل طقوسهم وعبادتهم بشكل طبيعي دون الفرض عليهم أو محاولةً منهم لتغيير سياستهم في ممارسة تلك السلوكيات الدينية الخاصة بهم.
ولربما جاءت سياسة الحاكم بأمر الله الطيبة وتغيير تلك السياسة المتشددة بعد أو وجد عدم تأثير تلك الديانات على الدين الإسلامي وأنها لا يمكن أن تؤثر تأثير سلبي على المجتمع الإسلامي، لذا أحسن معاملتهم بشكل يتناغم مع سياسة الدين الإسلامي السمحة.
فضلاً عن محاولة كسبهم إليه وعدم نفور اهل الذمة من دولته لأنهم يشكلون رابطاً قوياً في الدولة خصوصاً الجهاز الإداري للدولة الفاطمية، إذا ما علمنا سياسة خلفاء الدولة الفاطمية في الاعتماد عليهم كجزء أساسي من سياستهم لتسيير أمور الدولة، مما أدى بالخليفة الحاكم بأمر الله أن يغيّر من سياسته المتشددة التي ربما قد تنقلب عليه وعلى دولته سلباً فيما إذا أستمر بتلك المعاملة السيئة مع أهل الذمة.
أما الخليفة الفاطمي الظاهر فأنه قد سمح للنصارى أيضاً ببناء وترميم كنائسهم (0). فقد أعاد بناء كنائس عدّة، منها كنيسة القيامة ببيت المقدس، فضلاً عن السماح للنصارى ببناء اغلب الكنائس وترميمها بشكل مستمر دون التضييق عليهم أو منعهم (0).
في حين كان عهد الخليفة الفاطمي المستنصر بالله (427 هـ- 487 هـ/ 1034 م – 1093 م) هو الآخر قد اتسم بالتسامح مع أهل الذمة والسماح لهم بممارسة حياتهم الدينية دون تعرض، إذ انه سمح لهم ببناء كنائسهم ومنها كنيسة القيامة التي دُمرت بعهد الحاكم بأمر الله (0). في حين اشارت مصادر أخرى بأنه سمح للنصارى ببناء كنيسة مرقورة فضلاً عن كنيسة الست (0) في حارة الروم وكنيسة جرجيس بالحمراء (0).
وفي عهد الخليفة الحافظ لدين الله (495 هـ_ 525 هـ/ 1029 م – 1100 م) فأنه سمح للنصارى ايضاً ببناء كنائس عديدة لها أثرها في نفوسهم واهمية بالغة في حياتهم الدينية (0). مما يعني أنه سار بنفس السياسة التي اتبعها اجداده من خلفاء الدولة الفاطمية والتي اسهمت بكسب ود النصارى وعدم مضايقتهم، بل وتقريبهم من الخلافة الفاطمية.
أما عهد الخليفة الآمر بأحكام الله (524 هـ- 543 هـ/ 1129م – 1148م) فقد شهد هو الآخر سياسة اللين في تعامله مع الكنائس والأديرة لأهل الذمة، إذ تشير المصادر إلى أنه أمر بتجديد الكنائس والأديرة ومنها دير نسطور ودير القديس ماري جرجيس (0)، لذا فقد أتسم عصره ببناء الكنائس وترميمها واصلاحها بشكل واضح دون التعامل بشكل يسيء إلى سياسة اللين التي عُرفت عن الخلفاء الفاطميين (0).
كذلك شهد عصر الخليفة الفاطمي الظافر (544 هـ- 549 هـ/ 1150م – 1154م) بالتعامل الطيب مع أهل الذمة خصوصاً عملية ترميم وبناء الكنائس، فضلاً عن أنفاقه الكثير من الأموال عليها(0).
ومن ثم يمكننا القول بأن طبيعة التعامل الفاطمي مع أهل الذمة كان تعاملاً إيجابياً خصوصاً في عملية ترميم وبناء الكناس ولم يعتمدوا سياسة الهدم الكلي لكنائسهم ومراكزهم العبادية، إلا بعض الحالات التي وردت من قبل بعض الحكام نتيجة لردة فعل من قبل تصرفات أهل الذمة المخالفة لسياسة الدين الإسلامي.
فنتيجة التعامل مع الآثار العمرانية لغير المسلمين كان مطابقاً تماماً لما جاء به القرآن الكريم في ضرورة الحفاظ على المعالم العمرانية للأمم المخالفة للشرع الإلهي، ومن الطبيعي سياسة الفاطميين كانت تختلف عن سياسة السابقين لهم من حكام الدولة الإسلامية التي اتسمت بالتعامل السيء مع اهل الذمة ومع معالمهم العبادية – خصوصاً تعامل الدولة الاموية والعباسية - فسياسة الخلفاء الفاطميين في التعامل مع المراكز العبادية للنصارى كانت سياسة طيبة لم تكن مخالفة للشرع الإلهي وما جاءت به السنة النبوية من تعاليم.
المبحث الثالث: موقف أهل الكتاب من تعامل الدولة الإسلامية مع آثارهم الدينية
كانت سياسة حكام الدولة الفاطمية في أغلبها إيجابية خصوصاً تلك التي مارسوها أتجاه النصارى وما صدر منهم من تعامل مع كنائسهم وبيّعهم، والتي تعد من المراكز المهمة التي لها أثر واقعي في حياتهم الدينية. لذا كان تعامل الفاطميين معها بشكل ايجابي إلا بعض المواقف التي ظهر فيها تشدد في هدم الكنائس وعدم السماح للنصارى في ترميمها وهذا ما توضح في سياسة الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله الذي غيّر سياسته مع النصارى وقام بهدم كنائسهم وبيعهم دون الخضوع لهم، الأمر الذي أسهم أن تكون لهذه المعاملة منه ومن غيره من الحكام ردة فعل من قبل النصارى وموقف اتجاه تلك المعاملة السيئة وهذا أمر بديهي لأنه اختص بمعتقداتهم الدينية ومراكزهم العبادية.
يمكن القول إن تعامل المسلمين السلبي مع كنائس النصارى من خلال هدمها وتحطيمها وعدم تعميرها قد انعكس بشكل يؤثر على سلمية الاسلام الحقيقي، الأمر الذي له أثر مهم على الحياة الدينية والاجتماعية. وهذا الأمر يمكن أن نلمسه من خلال تعامل النصارى مع المراكز العبادية للمسلمين وما أحدثوه فيها من فعل يسيء إلى رمزية تلك المساجد، نتيجة لتعامل من يمثل الإسلام مع كنائسهم ومراكزهم العبادية تارةً أو لتعاملهم السيء مع أهل الكتاب تارةً أخرى.
أشارت المصادر إلى موقف النصارى من المساجد وردّة فعلهم من تصرف المسلمين، إذ كانت ردة فعل انتقامية فعلى سبيل المثال لا الحصر ما فعله ملك الروم بجامع طرسوس، حيث جعله إصطبلاً وأحرق المنبر (0). وهذا العمل من دون شك له أثر في نفوس المجتمع الإسلامي لما له من تأثير واقعي على حياتهم الدينية والعقدية، إذ أن حرق المسجد له دلالة سلبية تؤثر على سلمية التعامل بين الطرفين (المسيحي والإسلامي) وهو الأمر الذي ينتفع منه المغرضين الذين ترجموا هذا الفعل وغيره إلى زرع الفتنة بين الفريقين وهي الشرارة التي يمكن أن يستخدمونها متى شاءوا.
ومصداق ذلك ما حصل في الحروب الصليبية على المشرق وكيفية استخدام هذه السياسة في تأليب المجتمع المسيحي للثورة على المسلمين وزرع التناحر بينهم علماً أن الدولة الفاطمية لم يظهر منها سلوكيات قد خالفت التعامل الصحيح مع المعالم العبادية إلا بعض التعاملات البسيطة التي أشرنا لها من قبل الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر معهم، إذا ما علمنا بأنه لم يستمر بتلك السياسة المتشددة.
ومن ضمن ردّة فعل النصارى جراء تهديم كنائسهم أو التشدد عليهم في ممارسة سلوكياتهم العبادية هو ما أشار له عماد الدين بقوله: " وأما الصخرة فقد كان الفرنج قد بنوا عليها كنيسة ومذبحا، ولم يتركوا فيها للأيدي المتبركة ولا للعيون المدركة ملمسا ولا مطمحا. وقد زينوها بالصور والتماثيل، وعينوا بها مواضع الرهبان ومحط الإنجيل، وكملوا بها أسباب التعظيم والتبجيل. وأفردوا فيها لموضع القدم قبة صغيرة مذهبة، بأعمدة الرخام منصبة. وقالوا محل قدم المسيح، وهو مقدم التقديس والتسبيح وكانت فيها صور الأنعام مثبتة في الرخام. ورأيت في تلك التصاوير أشباه الخنازير. والصخرة المقصودة المزورة" (0).
ومن ضمن مواقف النصارى ضد حرق وتهديم الكنائس خصوصاً كنيسة القيامة قيام المسيحيين المتشددين بتأليب المجتمع المسيحي ضد المسلمين وجرهم لقيام الحروب الصليبية إذ أدّى هدم كنيسة القيامة إلى حالة من الغضب في العالم المسيحي، وكان السبب الرسمي المعلن للحملات الصليبية، من خلال الصعوبات التي تعرض لها الحجاج المسيحيين في الوصول إلى الأماكن المسيحيّة المقدسة وهدم كنيسة القيامة، غير أنه كانت أيضًا دوافع الحملات الصليبية متعددة منها دوافع دينية، واقتصادية، وتوسعيّة، واجتماعية.
من الجدير بالذكر أنّ سياسة التشدد في هدم الكنائس كانت نتيجتها سلبية وحالة مؤثرة في نشر منهج الاسلام الحقيقي، فمن الطبيعي ان تكون ردة فعل النصارى قوية اتجاه هدم معالمهم العبادية خصوصاً إذا كان الهدم غير مبرر. ولكن على الرغم من ذلك وما يخص بحثنا أن الدولة الفاطمية كانت ذو مواقف طيبة اتجاه هدم كنائس النصارى بشكل كبير مما أدى إلى عدم ظهور ردود فعل قوية ضد المسلمين خلال الحكم الفاطمي في مصر، إلا بعض الحالات التي استثمرها قادة الغرب في تأليب النصارى للثورة على المشرق واحتلال بيت المقدس بحجة هدم كنائسهم والتشدد عليهم من قبل المسلمين. سواء في العصر الفاطمي أم في عهود سابقة وما أحدثه المسلمين من سلوكيات سلبية ضد المراكز العبادية لغير المسلمين. والتي اصبحت السبب الرئيسي لكل تصرف سيء من قبل النصارى ضد المسلمين.
الخاتمة:
من خلال دراستنا لهذا الموضوع توصلنا إلى مجموعة من النتائج يمكن أن نوجزها بالآتي:
-
كان تعامل الدولة الفاطمية مع المراكز العبادية لغير المسلمين من كنائس وأديرة وغيرها، قد اتسم بالتسامح وعدم المساس بها متمثلة بسياسة السابقين ممن مثلوا الدين الإسلامي الحنيف.
-
تمثلت سياسة الحكام الفاطميين مع اهل الذمة بالسياسة اللّينة والمتسامحة مما أدى ذلك إلى تقريبهم إليهم من خلال توظيفهم في مناصب حساسة في الدولة الفاطمية، فضلاً عن مصاهرتهم وتقريبهم بشكل يفوق سياسة السابقين.
-
يمكن أن نصف العصر الفاطمي بالنسبة لأهل الذمة بالعصر الذهبي لما لاقوه من تعامل إيجابي من قبل الحكام الفاطميين.
-
على الرغم من السياسة الطيبة مع أهل الذمة إلا أنه وردت هناك سياسة تشدد في بعض المواقف وخلال عهد الخليفة الحاكم بأمر الله، نتيجة لما ورد منهم من تعامل سلبي خصوصاً في احتفالاتهم الدينية التي خالفوا فيها ضوابط المجتمع الإسلامي.
-
ان التعامل السلبي وحرق الكنائس وتهديمها انعكس بشكل سلبي على سلمية الإسلام الحقيقي وهو الأمر الذي استخدمه المتشددين لتحقيق مكاسبهم الشخصية.
قائمة المصادر والمراجع:أولاً: المصادر الأولية
القرآن الكريم
الارمني، ابو صالح (605 هـ/ 1209م): اديرة وكنائس مصر، تحقيق ايفت اكسفورد 1312 هـ/ 1894 م.
الأنطاكي، يحيى بن سعيد بن يحيى الانطاكي (458 هـ/ 1067 م): تاريخ الانطاكي المعروف بتاريخ اوتيخا، تحقيق، عمر عبد السلام تدمري، طرابلس، 1410 هـ/ 1990 م.
البيهقي، ابو بكر أحمد بن الحسين بن علي (458هـ / 1065 م): السنن الكبرى، دار الفكر، بيروت ـ لبنان (د. ت).
ابن الجوزي، ابو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد (597 هـ/ 1200 م): تلبيس ابليس، دار العلم، بيروت – لبنان، 1403 هـ/ 1983 م.
الحنبلي، القاضي مجير الدين أبو اليمن (927 هـ/1520 م): الانس الجليل بتاريخ القدس والخليل، قدمه محمد بحر العلوم، منشورات المطبعة الحيدرية في النجف الأشرف، 1388 هـ/ 968 م.
ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد الحضرمي المغربي (ت: 808هـ / 1405م): تاريخ أبن خلدون المسمى بـ كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، نشر مؤسسة الأعلمي، بيروت ـ 1971م.
ابن خلكان، أحمد بن محمد بن إبراهيم، (ت: 681ه/1282م): وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تح: إحسان عباس، دار الثقافة، بغداد، د.ت.
بو داود السجستاني، سليمان بن الأشعث بن بشير بن شداد (275 هـ/ 888 م): سنن أبي داود، ط 1، تحقيق وتعليق سعيد محمد اللحام، دار الفكر، 1410 - 1990م.
الشهرستاني، ابو الفتح محمد بن عبد الكريم بن ابي بكر (548 هـ/ 1153 م): الملل والنحل، تحقيق، محمد سيد ميلاني، دار المعرفة، بيروت – لبنان (د:ت)
الشهيد الأول، الشيخ شمس الدين محمد بن مكّي العاملي (786 هـ/): الدروس الشرعية في فقه الامامية، تحقيق، مؤسسة النشر الاسلامي، ط 2، قم المشرفة، 1417 ه.
الطبرسي، الشيخ ابو علي الفضل بن الحسن (ت 548 هـ/ 1153 م).: تفسير مجمع البيان، تحقيق، لجنة من العلماء والمحققين الأخصائيين، ط 1، الناشر، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت / لبنان1415 هـ/ 1994 م.
ابن عبد البر، ابو عمر يوسف، (ت: 463ه/1070م): الاستيعاب في معرفة الاصحاب، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، 1992م.
ابو الفدا، عماد الدين إسماعيل (732 هـ/ 1331 م): المختصر في اخبار البشر تاريخ ابي الفدا، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت – لبنان (د: ت).
القلقشندي، احمد بن علي (821 هـ/ 1418 م): صبح الاعشى في صناعة الانشا، تحقيق محمد حسين شمس الدين، ط 2، دار الكتب العلمية، بيروت، 1433 هـ/ 2012 م.
المتقي الهندي، علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين (ت975 هـ/1567م): كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للعلامة، ضبط تصحيح بكري حياني، صفوة السفا، مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان، 1409 هـ/ 1989 م.
المجلسي، العلامة محمد باقر (ت 1111 هـ/ 1699م): بحار الأنوار الجامعة لدرر اخبار الأئمة الأطهار (عليهم السلام) ط 2، الناشر: مؤسسة الوفاء، بيروت – لبنان 1403 هـ/ 1982م.
المقدسي، ابو عبد الله شمس الدين محمد بي ابي بكر (ت 381 هـ/ 1203 م): احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم، ط 3، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1411 هـ/ 1991 م.
المقريزي، تقي الدين احمد بن علي (845 هـ/ 1441 م): اتعاظ الحنفاء بأخبار الائمة الفاطميين الخلفاء، تحقيق محمد عبد القادر و أحمد عطا، ط 1، بيروت 1422 هـ/ 201 م.
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، تحقيق خليل منصور، دار الكتب العلمية، بيروت، 1418 م.
تاريخ الاقباط، تحقيق عبد المجيد ذياب، دار الفضيلة(د: ت).
ابن المقفع، ساويوس اسقف الاشمونين: تاريخ مصر من بداية القرن الاول الميلادي الى نهاية القرن العشرين من خلال مخطوط تاريخ البطاركة، تحقيق، عبد العزيز جمال الدين، مكتبة مدبولي، مج 3، 1426 هـ/ 2006 م.
ابن ميسر، تاج الدين محمد (677 هـ/ 1278 م): اخبار مصر، تحقيق هنري ماسية، مطبعة المعهد العلمي، القاهرة، 1338 هـ/ 1919 م.
النويري، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (732هـ /1331 م): نهاية الأرب في فنون الأدب (القاهرة، د.ت)
الهمداني، محمد بن عبد الملك (531 هـ/ 1136 م): تكملة تاريخ الطبري، ط 1، قدم له وحققه ووضع فهارسه عن المخطوطة الوحيدة المحفوظة في مكتبة باريس الأهلية ألبرت يوسف كنعان خريج معهد الآداب الشرقية بجامعة القديس يوسف المطبعة الكاثوليكية – بيروت – لبنان، 1958 م
المراجع الثانوية
الاصفهاني، عماد الدين الكاتب: كتاب الفتح القسي في الفتح القدسي حروب صلاح الدين وفتح بيت المقدس، دار المنار، 2004
اوغلو، تامر باجن: قوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي، (د: م / د: ت).
البيلي، محمد بركات: صفحات من تاريخ الدولة الفاطمية، 2007.
شافعي، سلام محمود: أهل الذمة في العصر الفاطمي الاول، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1416 هـ/ 1995 م.
الشيرازي، الشيخ ناصر مكارم: الامثل في تفسير كتاب الله المنزل، تحقيق: الشيخ مهدي الأنصاري، الناشر: قسم الترجمة والنشر لمدرسة الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام)، (د: ت).
طقوش، محمد سهيل: تاريخ الفاطميين في شمال افريقيا ومصر وبلاد الشام، دار النفائس، بيروت – لبنان، 1427 هـ/ 2007 م.
عامر، فاطمة مصطفى: تاريخ أهل الذمة في مصر من الفتح العربي إلى إلى نهاية العصر الفاطمي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، (د: ت).
عبدة، محمد: نهج البلاغة، وهو مجموع ما اختاره الشريف الرضي من خطب ووصايا وكتب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ط 2، مؤسسة الاندلس للمطبوعات، بيروت – لبنان، 1433 هـ/ 2012 م.
مغنية، محمد جواد (ت 1400 هـ/ 1979 م): الشيعة في الميزان، دار التعارف للمطبوعات، بيروت – لبنان 1399 هـ/ 1978 م.
المناوي، محمد حمدي: الوزارة والوزراء في الدولة الفاطمية، دار المعارف، القاهرة، 1390 هـ/ 1970 م.
الدوريات:
البهادلي، خلود عبد غركان: التسامح في ظل الحكم الفاطمي في مصر، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة البصرة ـ كلية الآداب. 1438 هـ/ 2016.
الزهيري شاكر عويد، الملامح الدينية لآثار البلدان غير الإسلامية وآليات التعامل: قراءة في آلية التعامل الأموي، بحث منشور في مجلة كلية التربية للعلوم الإنسانية، جامعة ذي قار، 2022م.
شدود، منى حسن: اهل الذمة ودورهم في تقلد الوظائف الادارية في مصر خلال الدولة الفاطمية، الجزء الثاني، 2020م.
0- تامر باجن توغلو، حقوق اهل الذمة في الفقه الإسلامي: 8
0 - الاقباط: وهي تسمية اطلقها المؤرخون على اهل مصر القدماء الذين اعتنقوا الديانة المسيحية وشكلوا الغالبية العظمى من سكان مصر. للمزيد ينظر: المقريزي، تاريخ الاقباط: 42.
0 - احسن التقاسيم في معرفة الأقاليم: 203.
0 - النسطورية: تنتسب هذه الكلمة غلى نسطور بطريك القسطنطينية الذي استخدم مصطلح والد المسيح. ينظر الأنطاكي، تاريخ الأنطاكي: 2 / 253.
0 - الملكانية: وهي تسمية اطلقت على اتباع الملك من المسيحيين الروم الأرثوذكس والكاثوليك وهم المسيحيون الأوائل: ينظر الشهرستاني، الملل والنحل: 244- 247 ؛ الأنطاكي، تاريخ الأنطاكي: 2 / 253.
0 - اليعقوبية: تنتسب هذه الكلمة الى يعقوب باراديوس الذي يقول مذهبهم أنّ المسيح هو الله. للمزيد ينظر ابن الجوزي، تلبيس أبليس: 71.
0 - الدروس الشرعية في فقه الإمامية: 1 / 50 .
0 - سليمان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داود: 3 / 45 ؛ البيهقي، السنن الكبرى: 9 / 205 ؛ المتقي الهندي، كنز العمال: 4 / 364.
0 - محمد جواد مغنية، الشيعة في الميزان: 153
0 - محمد طقوش، تاريخ الفاطميين في شمالي أفريقية ومصر وبلاد الشام: 220
0 - سلام شافعي، أهل الذمة في مصر في العصر الفاطمي الأول: 214
0 - يعقوب بن كلس: هو يعقوب بن يوسف بن ابراهيم بن هارون بن كلس، بغدادي الأصل يهودي الهوية، انتقل من الشام إلى مصر وكان عاملاً لدى كافور الاخشيدي، ثم استقر في مصر وبخدمة الخليفة الفاطمي المعز بالله تولى المناصب في الدولة الفاطمية منها الوزارة في عهد الخليفة العزيز بالله ولقب بالوزير الاجل، توفي في سنة 380 هـ. للمزيد عن حياة يعقوب بن كلس وسيرته ينظر ابن خلكان، وفيات الاعيان: 1 / 27 – 35
0 - المقريزي، اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء: 1 / 144- 145 ؛ القلقشندي، صبح الأعشى في صناعة الانشاء: 3 / 462.
0 - ابن خلدون، كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر: 4 / 55 ؛ القلقشندي، صبح الاعشا في صناعة الانشاء: 3 / 357.
0 - المقريزي، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار:1 / 397 ؛ ابن خلكان، وفيات الاعيان: 5 / 394
0 - ينظر الأنطاكي، تاريخ الانطاكي: 169 ؛ 194 ؛ 228 ؛ 238 ؛ المقريزي، الخطط: 1 /340 ؛ 377 ؛ البيلي، صفحات من تاريخ الدولة الفاطمية: 199 ؛ المناوي، الوزارة والوزراء في الدولة الفاطمية: 50.
هناك الكثير من المناصب التي تسلمها أهل الذمة في عصر الدولة الفاطمية حسب حاجة الخلفاء لها وللخبرة التي يتمتع بها أهل الذمة المر الذي سهل من تسلمهم هذه المناصب، يطول ذكر تلك المعلومات التي نحن ليس بصدد الحديث عنها بقدر ما نريد أن نوضحه على طبيعة تعامل الدولة الفاطمية مع أهل الذمة والتي توضحت لنا بسياسة الخلفاء الفاطميين التي تدلل على التسامح وتقريب أهل الذمة منهم لأسباب مختلفة منها حاجة الخلفاء لأهل الذمة وللخبرة الكبيرة التي يتمتع بها هؤلاء وطبيعة حنكتهم في ادارة الأمور، لذا تركزت المناصب المهمة في شخوص أهل الذمة. وللمزيد عن الوظائف التي تسلمها أهل الذمة في عهد الدولة الفاطمية ينظر منى حسن شدود، اهل الذمة ودورهم في تقلد الوظائف الادارية في مصر خلال الدولة الفاطمية: 270 – 291.
0 - طقوش، تاريخ الفاطميين: 237.
0 - ابو سعيد التستري: يهودي الاصل، كان يتولَّى ديوان والدة المستنصر الفاطمي. وذلك أنها كانت جاريته، فأخذها منه الظَّاهر وأستولدها فولدت المستنصر باللَّه. فلمّا أفضت الخلافة إلى ولدها فوّضت إليه أمر ديوانها، فعظم أمره وانبسطت كلمته بعد وفاة الجرجرائى الوزير حتّى لم يبق للوزير الفلاحي معه إلا اسم الوزارة، فدبّر الفلاحى في قتله فقتله في سنة 439 هـ. ينظر: النويري، نهاية الارب في فنون الادب: 28 / 216.
0 - ابن ميسر، اخبار مصر: 2 / 1 – 3 ؛ وينظر المقريزي، الخطط: 158.
0 - صبح الأعشى: 2 / 415
0 - عيد النوروز: هو عيد رأس السنة القبطية والذي يبدأ في الاول من توت، ومن أهم ممارسات اهل الذمة فيه هو اشعال النار ورش الماء. للمزيد: ينظر المقريزي، الخطط: 2 / 441.
0 - المقريزي، الخطط: 2 / 441
0 - الخطط: 2 / 441 - 442
0- عيد الغطاس: وهو من الأعياد المهمة في مصر لدى اهل الذمة والذي يحتفلون به في الحادي عشر من طوبه، من شهور القبط. يقولون إن يحيى بن زكريّا عليه السلام وينعتونه بالمعمدان، غسل عيسى (عليه السلام) ببحيرة الأردنّ، وأن عيسى لما خرج من الماء اتصل به روح القدس على هيئة حمامة، والنصارى يغمسون أولادهم فيه في الماء على أنه يقع في شدّة البرد. للمزيد ينظر القلقشندي، صبح الأعشى: 2 / 455.
0- المقريزي، الخطط: 2 / 30.
0 - المقريزي، اتعاظ: 1 / 334
0- وردت بعض التعاملات من قبل الخليفة الفاطمي العزيز بالله والحاكم بأمر الله وطبيعة التضييق على أهل الذمة نتيجة لما صدر منهم من سلوكيات وكيفية احتفالهم ببعض الاعياد ومغالاتهم فيها واظهار سلوكيات مخالفة للعرف الاجتماعي، والتي اشرنا لها في صفحات لاحقة.
0 - جاء في معاهدة الصلح التي عقدها عمرو بن العاص مع الروم بعد نجاحه في فتح الإسكندرية أن لأهل الذمة في مصر حرية ممارسة شعائرهم الدينية مقابل دفع دينارين كل سنة. وأعفى من الجزية النساء والأطفال والشيوخ ورجال الدين. للمزيد ينظر: تامر باجن أوغلو، حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي: 10 ؛ 17 ؛ 18 ؛ 20 – 21 وغيرها من المعاهدات التي أشار لها أوغلو في كتابه هذا.
0 - المقريزي، اتعاظ: 1 / 334
0 - ينظر القلقشندي، صبح الأعشى: 2 / 454 ؛ وينظر النويري، نهاية الإرب: 1 / 181.
0 - هناك الكثير من الأعياد والمناسبات التي ذكرتها كتب التاريخ والتي يطول ذكرها أخذنا منها محل الشاهد على طبيعة تعامل الدولة الفاطمية مع أهل الذمة والتي كانت عبارة عن تعاملات طيبة تتمثل بما يريده القرآن الكريم وما يريده الله تعالى من عباده خصوصاً ما جاء به الدين الإسلامي من احتواء الناس ومعاملتهم بشكل يتناسب ويتناغم مع الهدف السامي للإسلام والدين الحق الذي جاء به نبينا الكريم محمد ص. للمزيد عن المناسبات وأعياد النصارى ينظر المقريزي، الخطط: 1 / 129 ؛
0 - عيد الصليب: وهو العيد الذي يتم الاحتفال به في السابع عشر من توت من شهور القبط، والنصارى يقولون إن قسطنطين بن هيلاني انتقل عن اعتقاد اليونان إلى اعتقاد النصرانية، وبنى كنيسة قسطنطينية العظمى وسائر كنائس الشام. للمزيد ينظر: القلقشندي، صبح الأعشى: 2 / 457.
0 - المقريزي، الخطط: 2 / 33
0 - المقريزي، اتعاظ: 1 / 380.
0 - المقريزي، الخطط: 2 / 30.
0 - للمزيد عن طبيعة تعامل الخلفاء الفاطميين مع أهل الذمة حسب المنهم القرآني وما جاء به الدين الإسلامي من المحبة والألفة والتسامح مع الناس كافة. ينظر البهادلي خلود، التسامح في ظل الحكم الفاطمي في مصر، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة البصرة، كلية الآداب. 1438 هـ/ 2016.
0 - خطب الإمام علي (عليه السلام)، نهج البلاغة: 3 / 84 ؛ العلامة المجلسي، بحار الأنوار: 33 / 600 ؛ مغنية، في ظلال نهج البلاغة: 4 / 48.
0 - للمزيد عن تعامل الدولة الاموية مع آثار العمران الدينية لغير المسلمين ينظر: شاكر عويد، الملامح الدينية لآثار البلدان غير الإسلامية وآليات التعامل: قراءة في آلية التعامل الأموي، بحث منشور في مجلة كلية التربية للعلوم الإنسانية، جامعة ذي قار، 2022.
0 - أن مفهوم هذه الآية ينطوي تحت معنى السكن الفعلي في مساكن ودور الأقوام التي أهلكها الله تعالى من عاد وثمود، فنتيجة لتكذيبهم الرسل والأنبياء أهلكهم الله تعالى وأبقى مساكنهم مهيأة للسكن والحياة فيها. للمزيد ينظر الشيخ الطبرسي، تفسير مجمع البيان: 6 / 89.
0 - الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: 16 / 286
0 - شُرّعت هذه الآية لتستعرض واحداً من جوانب فلسفة تشريع الجهاد في سبيل الله تعالى ومجابهة الظلم والطغيان فتقول: " وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ". أي إنَّ الله إنْ لم يدافع عن المؤمنين، ويدفع بعض الناس ببعضهم عن طريق الإذن بالجهاد، لَهُدِّمَتْ أديرة وصوامع ومعابد اليهود والنصارى والمساجد التي يُذكَر فيها اسم الله كثيراً. ولو تكاسل المؤمنون وغضوا الطرف عن فساد الطواغيت والمستكبرين ومنحوهم الطاعة، لما أبقى هؤلاء أثراً لمراكز عبادة الله، لأنهم سيجدون الساحة خالية من العوائق، فيعملون على تخريب المعابد، لأنها تبث الوعي في الناس، وتعبئ طاقتهم في مجابهة الظلم والكفر. وكل دعوة لعبادة الله وتوحيده مضادة للجبابرة الذين يريدون أن يعبدهم الناس تشبها منهم بالله تعالى، لهذا يهدمون أماكن توحيد الله وعبادته، وهذا من أهداف تشريع الجهاد والإذن بمقاتلة الأعداء. ينظر الشيخ مكارم ناصر الشيرازي، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: 10 / 358.
0 - كنيسة القديس مرقريوس: سميت بهذا الاسم نسبة الى القديس مرقريوس، احد الرهبان النصارى المشهورين، وفي هذه الكنيسة يتم دفن الموتى. للمزيد: المقريزي، الخطط: 4 / 438.
0 - الكنيسة المعلقة: احدى كنائس النصارى ولها قدر كبير عندهم، وهي تقع في خط قصر الشمع: المقريزي، الخطط: 2 / 511
0 - طقوش، تاريخ الفاطميين: 221
0 - طقوش، تاريخ الفاطميين: 221
0 - الأنطاكي، تاريخ أوتيخا: 197 ؛ المقريزي، الخطط: 3 / 342.
0 - المقريزي، الخطط: 4 / 413
0 - الحنبلي، الانس الجليل: 1 / 306
0 - تاريخ الاقباط: 46 ؛ الخطط: 2 / 495.
0 - المقريزي، الخطط: 3 / 40.
0 - الانطاكي، تاريخ أوتيخا: 228.
0 - عامر، تاريخ أهل الذمة: 211.
0 - الانطاكي، تاريخ أوتيخا: 229 - 237 .
0 - الانطاكي، تاريخ اوتيخا: 238 .
0 - الانطاكي، تاريخ اوتيخا: 243 .
0 - الحنبلي، الانس الجليل: 1 / 303 .
0 - كنيسة الست: وهي الكنيسة الوحيدة لليعاقبة وكانت تعرف بكنيسة المغيثة، وموقعها خارج مدينة القاهرة. ينظر: المقريزي، الخطط: 3 / 810.
0 - ابن المقفع، تاريخ مصر من بداية القرن الاول الميلادي الى نهاية القرن العشرين من خلال مخطوط تاريخ البطاركة: 2 / 1148.
0 - طقوش، تاريخ الفاطميين: 408.
0 - عامر، تاريخ أهل الذمة: 2 / 321.
0 - ابو صالح الأرمني، أديرة وكنائس مصر: 78
0 - عامر، تاريخ أهل الذمة: 1: 452 .
0 - محمد بن عبد الملك الهمداني، تكملة تاريخ الطبري: 1 / 190 ؛ ابي الفدا، المختصر في اخبار البشر (تاريخ ابي الفدا): 3 / 105 ؛ ابن عبد البر، الاستيعاب: 2 / 777.
0 - عماد الدين الكاتب، كتاب الفتح القسي في الفتح القدسي حروب صلاح الدين وفتح بيت المقدس: 79
Shakir Awaid Nafawa || Non-Islamic religious urban monuments and coping mechanisms: A reading of the Fatimid state's handling || Ibn Khaldoun Journal for Studies and Researches || Volume 2 || Issue 7 || Pages 146 - 171.
0
| Id | Article Title | Authors | Vol Info | Year |
| Id | Article Title | Authors | Vol Info | Year |