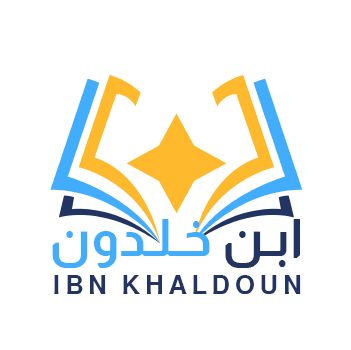2
6
2022
1682060055167_2347
https://drive.google.com/file/d/1jVoYTCSclvJUjnkuDjHd5hEM52cr5hmd/view?usp=sharing
The amazing wonder and the sacred event in the Quranic stories
د. جوهرة القدس عكية: أستاذة وباحثة من المملكة المغربية.
Abstract:
The study aimed to shed light on examples of Qur'anic stories, as stories that achieved lofty goals within the framework of the depicted situations and events, and the meaning they contained, and that was a high example in presenting the facts of history. To achieve the objectives of the study, the researcher used an analytical approach that seeks to disassemble the phenomena and study them in a detailed study. The study reached a set of results, the most important of which is that the Qur'anic stories recall the historical event from the depths of time, and collect it from the faces of the earth, to present it to life again, in the form of sermons and lessons. And that he resurrects the historical event, and makes it alive after it was dead, in an interesting style and superior content. The study recommended a set of recommendations, the most important of which are: that the Qur'anic text is overflowing with the amazing wonder that God Almighty has stopped His messengers and prophets, this wonder that strikes in the closing, and transcends the limits of reason and reasonable, is nothing but a review of the manifestations of divine power supernatural for familiar human beings.
Keywords: Quranic stories, the wondrous, historical event, sacred event.
المقدمة:
ورد في المعجم قصصت الأثر، واقتصصته، وتقصصته، وخرجت في أثر فلان قصصا، فكلمة "قص" تعني الاتباع، والقصة تسمى كذلك لأن كل كلمة تتبع كلمة، ومأخوذة من قص الأثر، وهو تتبع أثر السائر على الأرض حتى يعرف الإنسان مسار من يتبعه، فلا ينحرف ولا يحيد عن الاتجاه الذي سار فيه من يبحث عنه، قال تعالى: "وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب، وهم لا يشعرون" [القصص: 28]، وقصيه في هذه الآية الكريمة بمعنى "تتبعي أثره"، والقص هنا ليس هو الكلمة التي تتبع كلمة، بل إنما القص هو تتبع ما حدث بالفعل. ويورد الله سبحانه وتعالى مثلا من قصة موسى عليه السلام مع فتاه في طريقهما للقاء "الخضر" عليه السلام، "قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا " [الكهف: 18].
ووفق هذا التحديد، فالقصص الديني كان عملا من رسالات الأنبياء، له غاياته السامية العظيمة. قال تعالى: "إنما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي"[الأعراف: 35]، وقوله سبحانه: "فاقصص القصص لعلهم يتفكرون"[الأعراف: 176]. ومن خلال معاينة هاته الآيات الكريمة، نتبين ارتباط القص بغايات عدة من ذلك؛ الحديث، والنبأ، والخبر. ومن الحديث قوله عز وجل: "وهل آتاك حديث موسى"[طه: 9]، وأيضا قوله سبحانه: "نحن نقص عليك نبأهم بالحق"[الكهف: 12]، ومن الخبر ما ورد في سورة محمد "ونبلو أخباركم"[محمد: 31]. وهكذا نقف على معنى القصص القرآني المرتبط بغايات سامية، والمستند إلى مادة غزيرة عمرها يطال الأقوام البائدة والعصور المتلاحقة، وأن الحدث والحديث، والخبر، والنبأ، المتصل بها لمما يعجز عن استيعابه راو أو قاص من بني البشر، خاصة وأن توظيفها جاء في سياق تبليغ الرسالة، وتأدية الأمانة، أمانة النبي الذي اشتق لقبه من جذر "ن.ب.أ"، وهو من صميم القصص، من ذلك؛ "أنباء القرى" [هود: 100]، و"أنباء الغيب" [هود: 49]، و"نبأ موسى" [القصص: 3]، ونبأ الكهف [الكهف: 12]، "نحن نقص عليك نبأهم بالحق". ووفق هذا التحديد، فالقصص القرآني يختلف اختلافا كليا عن القصص الأدبي في سرده وسارده، إذ ليس الهدف منه تقديم العبر والتذكير، بل إنما هو شكل مختلف يسعى إلى عرض قدرات السارد، حتى إن تسميته بالقصص هي تسمية إلهية لا دخل فيها للبشر.
مشكلة الدراسة:
إن النص القرآني يحضن العديد من الأحداث التي اكتست قداستها وتعاليها من تعالي القرآن الكريم. وأن القصص القرآني نماذج عليا للقدوة في السلوك والاحتذاء حذوها؛ نماذج مجردة من الزمان والمكان، تساهم في أسطرة التاريخ العادي للبشر.
المنهج:
حرصت الباحثة في هذه الدراسة على تبني مقاربة تحليلية تنهض على تفكيك الظواهر المختلفة إلى مكوناتها الأولية، ودراستها دراسة تفصيلية، وفهم أنماط التفاعلات الموجودة فيما بينها، مع استنباط القوانين العامة التي تحكمها.
توطئة:
إن القصص القرآني لم يوجد في القرآن الكريم من باب التسلية والترويح عن النفس، وإنما كانت جزءا أصيلا من كتاب الله العزيز، ودليلا يهتدي به الناس في الحياة. وهذا يعني أن القصد من القصص القرآني ليس السرد والرواية، وإنما ما تحمل تلك القصص والأخبار من مواعظ وعبر، ترشد قارئها إلى اتباع سبل الفلاح والرشاد، وتجنب طرق الشرك والضلال. ولما كان القصص القرآني يمتاز بمزايا ينفرد بها عن القصص الإنساني، من ذلك؛ سمو الغاية، وشرف المقصد، وتحري الحقيقة، بحيث لا يشوبه شائبة من الوهم أو الخيال أو مخالفة الواقع، ناهيك عن أنه أصدق القصص، مصداقا لقوله تعالى: "ومن أصدق من الله حديثا" [النساء: 87]، وأيضا قوله عز وجل: "إن هذا لهو القصص الحق" [آل عمران: 62]. فإن لهذا المنحى القصصي فضل الكشف عما طمسته الأيام، وقبرته السنون ومحاه النسيان والتقادم. قال تعالى: "ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، ورسلا لم نقصصهم عليك"[النساء: 164]. ولم يكن ذلك الاستدعاء التاريخي لبعض مظاهر القديم في جوانب منه ضربا من التذكير العارض، أو التشويق السطحي، بل كان مثار توجيه ونصح وإرشاد، وتذكير لأولي الألباب، وتقوية للعزائم والهمم، وإيناسا للرسول للكريم، وتسلية له، قال تعالى: " لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، ولكن كان تصديق الذي بين يديه، وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون" [يوسف: 12].
وتماشيا مع هذا الأفق، فإن القصص القرآني يشير إلى بعض الحقائق الكونية الجارية حتى قيام الساعة، ذلك أن العناصر التي يستعملها القرآن الكريم، باعتباره كتابا كونيا، هي عناصر غير مختصة بزمن معلوم، أو مكان معلوم، أو شخص معلوم. فالأحداث التي ذكرها القرآن تتكرر على مر الزمان وفق صور مختلفة، لكن بالماهية نفسها. وفي هذا الإطار، نجد أن النص القرآني يحضن العديد من الأحداث التي اكتست قداستها وتعاليها من تعالي القرآن الكريم. فالقصص القرآني نماذج عليا للقدوة في السلوك، والاحتذاء حذوها، وهي نماذج مجردة من الزمان والمكان، ذلك "أن التاريخ المروي من قبل الله، كمحل لتظاهرات النماذج الكينونية المحركة من التاريخ والوجود، أو بمثابة نماذج عليا ينبغي أن يقتدي بها الوجود البشري. إنه يساهم في أسطرة التاريخ العادي للبشر"(0).
وهو ما مكن من تلقي الصور المثالية والتحديدات والأوامر والنواهي الموجهة من قبل الله عز وجل، ووفق هذا السياق، نورد بعضا من هذه النماذج العليا على سبيل المثال لا الحصر، وفيما يلي نماذج من العجيب المدهش في القصص القرآني:
1- قصة الذبيح إسماعيل عليه السلام:
قال الله تعالى: " وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ، رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ " [الصافات: 99-108].
جاء في سياق هذه الآيات الكريمة أن خليل الله إبراهيم عليه السلام حين هاجر من بلاد قومه، سأل ربه أن يهب له ولدا صالحا، فبشره الله بإسماعيل عليه السلام، الذي جاءه على الكبر بعد أن طعن في السن. فلما شب إسماعيل وصار يسعى في مصالح أبيه، ويرتحل ويطيق ما يفعله الكبار من السعي والعمل، رأى إبراهيم عليه السلام في المنام أنه يؤمر بذبح ولده الوحيد، ذلك أن رؤيا الأنبياء في المنام وحي، والرؤيا الصادقة ضرب من أضرب النبوة.
ومن الواضح والجلي، أن ما رآه إبراهيم عليه السلام في منامه اعتبره أمرا إلهيا، أي وحيا تلقاه من رب العالمين، فامتثل بموجبه إلى ما اقتضته الإرادة الإلهية والحكمة الربانية. ولعل هذا الأمر اختبار آخر من الله عز وجل لخليله إبراهيم عليه السلام، فقد أمره قبل ذلك بأن يهاجر، وأن يسكن زوجته هجر وابنه اسماعيل في واد قفر بلا أنيس، ولا مأكل ولا مشرب. كما جاء في قوله تعالى: "رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ " [إبراهيم: 37]. فحدث أن امتثل للأمر الإلهي، وترك ذريته هناك ثقة بالله تعالى وتوكلا عليه، فأسبغ الله عليهما نعمه، ورزقهما من حيث لا يحتسبان.
وفي هذا الصدد، يذكر الطبري أن إبراهيم وابنه عليهما السلام، استسلما لأمر الله عز وجل، فهم إبراهيم لذبح ولده، ثم "إن إسماعيل قال له عند ذلك، يا أبت إن أردت ذبحي، فاشدد رباطي لا يصبك مني شيء فينقص أجري، فإن الموت شديد وإني لا آمن أن اضطرب عنده إذا وجدت مسه، واشحذ شفرتك حتى تجهز علي فتريحني وإذا أنت أضجعتني لتذبحني فكبني لوجهي على جبيني ولا تضجعني لشقي فإني أخشى إن أنت نظرت في وجهي أن تدركك رقة تحول بينك وبين أمر الله، وإن رأيت أن ترد قميصي على أمي فإنه عسى أن يكون هذا أسلى لها عني، فقال له إبراهيم نعم العون أنت يا بني على أمر الله، فربطه كما أمره إسماعيل، فأوثقه، ثم شحذ شفرته، ثم تله للجبين، واتقى النظر في وجهه، ثم أدخل الشفرة لحلقه فقلبها الله لقفاها في يده، ثم اجتذبها إليه ليفرغ منه، فنودي أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. هذه ذبيحتك فداء لابنك، فاذبحها دونه"(0). وفي رواية أخرى أوردها ابن كثير عن السدي، "بل أضجعه كما تضجع الذبائح، وبقي طرف جبينه لاصقا بالأرض، وسمى إبراهيم وكبر، وتشهد الولد للموت. وأمر السكين على حلقه فلم تقطع شيئا، ويقال: جعل بينها وبين حلقه صفيحة من نحاس"(0). عنذئذ، نودي على إبراهيم عليه السلام "قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين"، أي حصل المقصود من اختبارك وطاعتك ومبادرتك إلى أمر ربك. فكان أن فداه الله من سبع سماوات بكبش مليح، "وفديناه بذبح عظيم". إنه كبش أبيض أعين أقرن، عظيم سواد العينين، وكبير القرنين، "كبش قد رعى في الجنة أربعين خريفا، وقال سعيد بن جبي: كان يرتع في الجنة حتى تشقق عنه ثبير، وكان عليه عهن أحمر، وعن ابن عباس هبط عليه من ثبير كبش أعين أقرن له ثغاء فذبحه، وهو الكبش الذي قربه ابن آدم فتقبل منه"(0).
وعليه، يكون إبراهيم عليه السلام باضطجاعه ولده إسماعيل ليذبحه، وتمرير السكين على حلقه، وبقوة، دون أن تنال منه، قد صدق الرؤيا التي رآها في منامه، ونفذ ما أمره الله تعالى به. فرؤيا الأنبياء وحي، فقد كان يأتيهم الوحي من الله تعالى أيقاظا ورقودا، ذلك أن الأنبياء تنام عيونهم، ولا تنام قلوبهم. فبرهن إبراهيم عليه السلام من خلال هذا الحدث المتعالي عن كل ما هو دنيوي، أنه خليل الله وصفيه، وأن حب الله يقدم على حب الولد - حتى وإن كان هذا الولد بكره ووحيده وقرة عينه، الذي وهبه الله إياه على الكبر، وبعد طول انتظار - إنه الحب الإلهي في أسمى تجلياته.
ومهما يكن من أمر، فإننا نستنتج أن ما يمارسه المسلمون اليوم من طقوس احتفالية في عيد الأضحى، إنما هو إحياء لسنة إبراهيم عليه السلام، وما نحر أضحية العيد إلا تجسيد لقصة سيدنا إبراهيم مع ابنه إسماعيل. لا سيما، وأن هذه الأضحية القربانية؛ الكبش العظيم، كبش الفداء، كانت البديل الإلهي عن الأضحية الآدمية المتمثلة في إسماعيل. ومن ثم، فإن في تكرار هذه السنة غير المؤكدة كل عيد أضحى، هو تذكير دائم بهذا الحدث المقدس، وبما حدث في الأزل، وما كان سيحدث لولا حلول العناية الإلهية، ولطائفه سبحانه وتعالى. وحتى لا نرى، مجددا، أي دم آدمي، كان لا بد من دم أضحوي قرباني - على حد تعبير عبد الفتاح كليطو - يعيدنا إلى الزمن الأول زمن البدايات.
2- قصة يونس بن متى عليه السلام:
قال تعالى: وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ، وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ." [الصافات: 139-147]. القول في تأويل هذه الآيات الكريمة، أن الله عز وجل بعث رسوله يونس بن متى عليه السلام إلى أهل قريته "نينوى" من أرض الموصل، فدعا قومه إلى الله، فكذبوه وتمردوا، بل زادوا في كفرهم وعنادهم، فلما يئس من أمرهم، خرج من بين أظهرهم، وتوعدهم حلول العذاب بهم. فلما فقدوا نبيهم، وتيقنوا أن العذاب سيحل بهم، تابوا عن الكفر وآمنوا بالله تعالى، فقبل الله توبتهم حين أخلصوا الإيمان، ورفع عنهم العذاب، " فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ"[يونس: 98]. وفي هذا الصدد، يذكر الطبري عن ابن عباس أن يونس عليه السلام حينما بعثه الله إلى أهل قريته، "ردوا عليه ما جاءهم به وامتنعوا منه، فلما فعلوا ذلك أوحى الله إليه: إني مرسل عليهم العذاب في يوم كذا وكذا، فاخرج من بين أظهرهم، فأعلم قومه الذي وعده الله من عذابه إياهم، فقالوا: ارمقوه، فإن خرج من بين أظهركم فهو والله كائن ما وعدكم، فلما كانت الليلة التي وعدوا بالعذاب في صبحها أدلج، ورآه القوم، فخرجوا من القرية إلى براز من أرضهم، وفرقوا بين كل دابة وولدها، ثم عجوا إلى الله، فاستقالوه، فأقالهم، وتنظر يونس الخبر عن القرية وأهلها، حتى مر به مار، فقال: ما فعل أهل القرية؟ فقال: فعلوا أن نبيهم خرج من بين أظهرهم، عرفوا أنه صدقهم ما وعدهم من العذاب، فخرجوا من قريتهم إلى براز من الأرض، ثم فرقوا بين كل ذات ولد وولدها، وعجوا إلى الله وتابوا إليه، فقبل منهم، وأخَّر عنهم العذاب، قال: فقال يونس عند ذلك وغضب: والله لا أرجع إليهم كذابا أبدا، وعدتهم العذاب في يوم ثم رد عنهم، ومضى على وجهه مغاضبا"(0).
ومما تجدر الإشارة إليه، أن يونس عليه السلام خرج من قريته مغاضبا لقومه، وقد كان عبدا صالحا، كثير الصلاة والتسبيح، وكان في خلقه ضيق، فلم يقو على حمل أعباء النبوة، فتركها وخرج إلى البحر بغير إذن من ربه. فمغاضبته لقومه كانت غضبا لله، وأنفة لدينه، " وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ." [الأنبياء: 87-88]. ثم إن يونس ركب الفلك المشحون مع الراكبين، فاضطرب بهم، وكادوا يغرقون، فاشتوروا على أن يقترعوا، ومن تقع عليه القرعة يلقى من السفينة حتى يتخففوا منه، فلما وقعت القرعة على نبي الله يونس لم يسمحوا به، فأعادوها ثانية فوقعت عليه، ثم أعادوا القرعة مرة ثالثة، فوقعت عليه أيضا لما يريده به الله من أمر عظيم. "فاحتبست السفينة، فعلم القوم أنما احتبست من حدث أحدثوه، فتساهموا، فقرع يونس، فرمى بنفسه، فالتقمه الحوت"(0).
وهكذا، بإلقاء يونس عليه السلام في البحر يطلعنا النص القرآني على عجيب هذا الحدث، إذ بعث الله سبحانه له حوتا كبيرا "ذو النون" ابتلعه، "فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ"، أي لولا أن كان يونس من المسبحين والذاكرين الله كثيرا، لمكث في بطن الحوت إلى يوم القيامة، وبعث من جوفه، خاصة، وأنه اختلف في مدة مكوث يونس عليه السلام في بطن الحوت، "فقال مجاهد عن الشعبي: التقمه ضحى ولفظه عشية، وقال قتادة: فمكث فيه ثلاث، وقال جعفر الصادق: سبعة أيام، وقال سعيد بن أبي الحسن وأبو مالك: مكث في جوفه أربعين يوما"(0). وبما أن نبي الله يونس عليه السلام كان من الذاكرين الله قبل البلاء، الذي ابتلي به من العقوبة بالحبس في بطن الحوت، فقد ذكره الله تعالى في حال بلائه، ذلك أن العمل الصالح يرفع صاحبه ويزكيه.
ومهما يكن من أمر، فإن يونس عليه السلام لما استقر في جوف الحوت حسب أنه قد مات، فحرك جوارحه فتحركت، حينئذ أيقن أنه حي، فخر لله ساجدا، وقال: يا رب اتخذت لك مسجدا في موضع لم يعبدك أحد في مثله. وفي هذا الأمر، يروي الطبري حديثا عن محمد بن إسحاق يتصل سنده برسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لما أراد الله حبس يونس في بطن الحوت أوحى الله إلى الحوت؛ أن خذه ولا تخدش له لحما ولا تكسر له عظما. فلما انتهى به إلى أسفل البحر سمع يونس حسا، فقال في نفسه: ما هذا؟ فأوحى الله إليه وهو في بطن الحوت؛ إن هذا تسبيح دواب البحر. قال: فسبح وهو في بطن الحوت، فسمعت الملائكة تسبيحه، فقالوا: يا ربنا، إنا نسمع صوتا ضعيفا بأرض غريبة! قال: ذلك عبدي يونس عصاني فحبسته في بطن الحوت في البحر. قالوا: العبد الصالح الذي كان يصعد إليك منه في كل يوم وليلة عمل صالح؟ قال: نعم. قال: فشفعوا له عند ذلك، فأمر الحوت فقذفه في الساحل"(0). وفي رواية أخرى عن أنس بن مالك يرفع فيها هذا الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أن يونس النبي حين بدا له أن يدعو الله بالكلمات حين ناداه وهو في بطن الحوت، فقال: اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فأقبلت الدعوة تحت العرش، فقالت الملائكة: يا رب هذا صوت ضعيف معروف في بلاد غريبة، قال: أما تعرفون ذلك؟ قالوا يا رب ومن هو؟ قال: ذلك عبدي يونس، قالوا: عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة مستجابة، قالوا: يا رب أَوَ لا يرحم بما كان يصنع في الرخاء فتنجيه من البلاء؟ قال. بلى، فأمر الحوت فطرحه بالعراء"(0).
ومن ثم، فرحمة الله الواسعة تداركت عبده ونبيه يونس عليه السلام، فبمجرد ما التقمه الحوت، أمره الله عز وجل بأن لا يأكل له لحم، ولا يهشم له عظما، فذاك ليس له برزق. ويونس في جوف الظلمات مستغرق في التسبيح، والتهليل، والاستغفار، " فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ "، وفي لفظ الظلمات إشارة من الله إلى ظلمة بطن الحوت، وظلمة البحر، وظلمة الليل. ثم يتلقى الحوت مرة ثانية الأمر الإلهي، فيلفظ يونس عليه السلام إلى اليابس، " فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ "، وبقدرة الله يطرح الحوت يونس بن متى ويرميه بالعراء، أي بمكان قفر ليس فيه أشجار، وهو ضعيف البدن، فتشمله العناية الربانية فينبت الله تعالى عليه شجرة يقطين أي ما يعرف بالقرع. ولعل في إنبات القرع على يونس عليه السلام حكم جمة؛ فورقه في غاية النعومة، وكثير وضليل، ولا يقربه الذباب، ويؤكل ثمره من أول طلوعه إلى آخره، نيئا ومطبوخا، وبقشره، وفيه منافع كثيرة. كذلك، من لطف الله بنبيه يونس عليه السلام، أن سخر له أروية البرية ترضعه لبنها، إذ كانت تأتيه بكرة وعشية، وهذا من رحمة الله تعالى به ونعمته عليه، وإحسانه إليه.
والحالة هذه، فإننا إذ نعاين عجيب هذا الحدث المتعالي، نقف على تجليات صنيع الخالق الوهاب لكل من دعاه واستجار به. فقصة يونس عليه السلام مع قومه سلوى للذين تضيق صدورهم بالمعرضين عن دين الله والمتخاذلين عن التمسك به، والمفرطين في حدود الحق جل علاه.
3- قصة ميلاد عيسى بن مريم عليهما السلام:
قال الله تعالى: " وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا، قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا." [مريم: 16-30].
من خلال هذه الآيات البينات من سورة مريم، نقف على قدرة الله تعالى على الإتيان بأشياء تخالف ما اعتاد الناس عليه، إذ كان حمل مريم عليها السلام دون أن يمسسها رجل خرق للعادة ولما ألفه بنو البشر، ومعجزة إلهية موجهة إلى المشركين المكذبين لآيات الله عز وجل. ولما كان هذا الحدث من أعجب الأحداث التي تغذي العديد من النصوص الإسلامية، لما يحتويه من عجيب يحتفي بالخلق؛ خلق عيسى بن مريم عليه السلام من غير أب، "فقد قدمت له سورة مريم بقصة زكرياء الطاعن في السن، الذي ولد له مولود من امرأته وهي عاقر. وهذا شيء غريب، ولكنه مع ذلك قابل للتصديق بوصفه حالة استثنائية. وعليه، فلما كان هذا ممكنا، ولو كحالة استثنائية، فسيكون من الممكن أيضا كحالة استثنائية أن تلد المرأة من غير أن يمسسها بشر. وفي هذا تأكيد لعقيدة الخلق"(0).
ومن ثم، فإذا كان الحق سبحانه قادرا أن يهب مولودا لزكرياء عليه السلام رغم كبر سنه وعقم زوجته، فإن هذه القدرة الإلهية عينها تجعل مريم عليها السلام تحبل بولدها عيسى عليه السلام دون أن يكون لها زوج. ولعل هذا الأمر أثار استغراب كل من كان يعرف مريم العفيفة الطاهرة، حتى إن قريبها يوسف النجار، الذي كان يرابط معها في خدمة بيت المقدس، ينكر حملها "فكان أول من أنكر حمل مريم صاحبها يوسف، فلما رأى الذي بها استفظعه، وعظم عليه، وفظع به، فلم يدر
على ماذا يضع أمرها، فإذا أراد يوسف أن يتهمها، ذكر صلاحها وبراءتها، وأنها لم تغب عنه ساعة قط، وإذا أراد أن يبرئها، رأى الذي ظهر عليها، فلما اشتد عليه ذلك كلمها، فكان أول كلامه إياها أن قال لها: إنه قد حدث في نفسي من أمرك أمر قد خشيته، وقد حرصت على أن أميته وأكتمه في نفسي، فغلبني ذلك، فرأيت الكلام فيه أشفى لصدري، قالت: فقل قولا جميلا، قال: ما كنت لأقول لك إلا ذلك، فحدثيني، هل ينبت زرع بغير بذر؟ قالت: نعم، قال: فهل تنبت شجرة من غير غيث يصيبها؟ قالت: نعم، قال: فهل يكون ولد من غير ذكر؟ قالت: نعم، ألم تعلم أن الله تبارك وتعالى أنبت الزرع يوم خلقه من غير بذر، والبذر يومئذ إنما صار من الزرع الذي أنبته الله من غير بذر، أو لم تعلم أن الله بقدرته أنبت الشجر بغير غيث، وأنه جعل بتلك القدرة الغيث حياة للشجر بعد ما خلق كل واحد منهما وحده، أم تقول: لن يقدر الله على أن ينبت الشجر حتى استعان عليه بالماء، ولولا ذلك لم يقدر على إنباته ؟ قال يوسف لها: لا أقول هذا، ولكني أعلم أن الله تبارك وتعالى بقدرته على ما يشاء يقول لذلك كن فيكون، قالت مريم: أو لم تعلم أن الله تبارك وتعالى خلق آدم وامرأته من غير أنثى ولا ذكر؟ قال: بلى، فلما قالت له ذلك، وقع في نفسه أن الذي بها شيء من الله تبارك وتعالى، وأنه لا يسعه أن يسألها عنه، وذلك لما رأى من كتمانها لذلك، ثم تولى يوسف خدمة المسجد، وكفاها كل عمل كانت تعمل فيه"(0). ومن خلال هذا السجال نستشف إيمان مريم الراسخ، وصدق يقينها في الله تعالى وحوله وقوته، وصبرها الجميل على ابتلائها ومصابها، وتسليمها لأمره عز وجل. كيف لا، وهي الناسكة، والقانتة، والمتعبدة الملازمة للمحراب؛ تلك مريم الباتول التي جعلتها أمها محررة لخدمة بيت المقدس.
ومما تجدر الإشارة إليه، أننا نقف كثيرا في النص القرآني على فعل الخلق من قبيل؛ " إنا خلقناكم"، و"خلقتك"، وعلى حدث الخلق؛ كخلق الله تعالى آدم عليه السلام من تراب، فضلا عن خلق عيسى عليه السلام من دون أن يكون له والد، كما جاء في قوله تعالى: " وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا "[مريم: 9]. إن الله وحده القادر على الخلق من عدم، فلقد خلق آدم من تراب ونفخ فيه من روحه، وقال له كن فيكون، فكان آدم بين كافه ونونه، وخلق عيسى عليه السلام من أمه مريم، بأن أرسل إليها الملك جبريل عليه السلام، فتمثل لها بشرا سويا، فنفخ في جلبابها نفخة من روح الله، حتى وصلت النفخة إلى الرحم. "فأخذ جبريل بكميها، فنفخ في جيب درعها، وكان مشقوقا من قدامها، فدخلت النفخة صدرها، فحملت"(0). ونشير هنا، إلى أن آدم وعيسى عليهما السلام خلقا من غير نكاح بين أب وأم على خلاف حال سائر البشر، وفي هذا اطراد للقاعدة وخرق لمألوف الناس ومعهودهم. قال تعالى: " إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ " [آل عمران: 59]. وبناء على هذا التحديد لمفهوم الخلق، فإننا نتبين كمال قدرة الله تعالى على أنواع الخلق، فلقد خلق سبحانه آدم من غير ذكر ولا أنثى، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر. وبالمقابل خلق سائر الخلق من ذكر وأنثى.
ولما كان الأمر كذلك، فإن الله تعالى اصطفى مريم عليها السلام، وفضلها على نساء العالمين، " وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ " [التحريم: 12]. وبشرها بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، " إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ " [آل عمران: 45-46]. لذلك، ألفينا مريم تسائل الملك جبريل الذي زف إليها البشارة، "من أي وجه يكون لي غلام؟ أ من قبل زوج أتزوج، فأرزقه منه، أم يبتدئ الله في خلقه ابتداء ولم يمسسني بشر من ولد آدم بنكاح حلال، ولم أك إذ لم يمسسني منهم أحد على وجه الحلال بغيا، بغيت ففعلت ذلك من الوجه الحرام، فحملته من زنا (...) قال لها جبريل، ولكن ربك قال: هو علي هين: أي خلق الغلام الذي قلت أن أهبه لك علي هين، لا يتعذر علي خلقه، وهبته لك من غير فحل يفتحلك. وكي نجعل الغلام الذي نهبه لك علامة وحجة على خلقي أهبه لك. رحمة منا لك، ولمن آمن به وصدقه أخلقه منك. وكان خلقه منك أمرا قد قضاه الله ومضى في حكمه وسابق علمه أنه كائن منك"(0).
وفي هذا الإطار، نجد أن النصوص الإسلامية تضفي على حمل مريم العذراء، وولادة ابنها عيسى عليهما السلام هالة من القداسة والتعالي، ذلك أن طقوس الولادة – في هذه النصوص– عادة ما تكون مصحوبة بمجموعة من الأحداث المتعالية، مثل التنكيس الذي لحق الأصنام يوم ولادة عيسى عليه السلام، والفزع الذي أصاب الشياطين، "فلما ولد عليه السلام أصبحت الأصنام كلها بكل أرض منكوسة على رؤوسها، ففزعت الشياطين ولم يدروا لما ذلك، فساروا مسرعين حتى جاءوا إلى إبليس لعنه الله وهو على عرش له في لجة خضراء يتمثل بالعرش يوم كان على الماء، فأتوه وقد خلت ست ساعات من النهار، فلما رأى إبليس اجتماعهم فزع من ذلك، ولم يرهم جميعا منذ فرقهم قبل تلك الساعة، وإنما كان يراهم أشتاتا فسألهم فأخبروه أنه حدث في الأرض حدث فأصبحت الأصنام كلها منكوسة على رؤوسها، ولم يكن شيء أعون على هلاك بني آدم منها، لأنهم كانوا يدخلون في أجوافها فتكلمهم وتدبر أمرهم فيظنون أنها هي التي تكلمهم، فلما أصابها هذا الحدث صغرها في أعين الناس وأذلها، وقد خشينا أن لا يعبدوها بعد هذا. واعلم أنا لم نكن نأتيك حتى أحصينا الأرض، وقلبنا البحار وكل شيء فلم نزدد بما أردنا إلا جهلا، فقال لهم إبليس فما يكون إلا أمر عظيم، فكونوا مكانكم فطار إبليس عند ذلك، ولبث عنهم ثلاث ساعات فمر فيهن بالمكان الذي ولد فيه عيسى، فلما رأى الملائكة محدقين بذلك المكان علم أن ذلك الحدث فيه، فأراد إبليس لعنه الله أن يأتيه من فوقه، قال فإذا رؤوس الملائكة ومناكبهم إلى السماء، ثم أراد أن يأتيه من تحت الأرض فإذا أقدام الملائكة راسية، فأراد أن يدخل من بينهم فمنعوه عند ذلك"(0). ويفيد هذا، أن مريم عليها السلام حينما جاءها المخاض، تنحت بحملها إلى مكان بعيد، "فاشتد على مريم المخاض، فلما وجدت منه شدة، التجأت إلى النخلة فاحتضنتها، واحتشوتها الملائكة، وقاموا صفوفا محدقين بها"(0). إن جذع النخلة كان جذعا يابسا، وأمرها الله تعالى أن تهزه عملا بالأسباب، فتساقط عليها الرطب من السماء، " كان جذع النخلة نخرا فلما هزت نظرت إلى الطلع قد خرج من بين السعف، ثم اخضر فصار بلحا، ثم احمر فصار زهوا، ثم رطبا، كل ذلك في طرفة عين، فجعل الرطب يقع بين يديها لا ينشدخ منه شيء"(0). والواقع، إن النخلة لم تكن مثمرة ساعة ولادة عيسى عليه السلام، ثم إن ميلاده كان شتاء، وليس ذاك وقت تمر أو بلح، فهزت مريم بجذع النخلة، "وكان جذعا منها مقطوعا فهزته، فإذا هو نخلة، وأجري لها في المحراب نهر، فتساقطت النخلة رطبا جنيا"(0)، فكان ذلك آية أخرى في إحياء موت الجذع.
ومن عجيب هذه النخلة، ننتقل إلى عجيب النهر المبارك "السري"، وهو اسم النهر الذي كان تحت مريم حين ولدت المسيح، وكان ماؤه قد نضب فأجراه الله تعالى لمريم عليها السلام، وسمي "سريا" لأن الماء يسري فيه، إذ كان هذا النهر يجري من ماء عذب فيكون باردا إن أرادته مريم للشرب، وفاترا إذا أرادته للاستعمال اليومي.
ومهما يكن من أمر، فإن الهالة التي أحاطت بحدث ولادة المسيح عيسى بن مريم عليهما السلام، ساهمت في نقل هذا الحدث من الدنيوي والتاريخي إلى الإلهي، ومن ثمة، جعله حدثا مقدسا متعاليا؛ على نحو أن هذه الهالة التي صاحبت حدث ميلاد المسيح عليه السلام، " تظل شاهدا على تفجر القدسي في الزمان والمكان، وعلى تحول الزمان من زمان حسي/ تاريخي، إلى زمان ميثي/قدسي ودائري"(0).
4- قصة أصحاب الفيل:
قال الله تعالى: " أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ "[الفيل: 1-5]. يخبر الله تعالى في هده الآيات الكريمة رسوله بما حدث لأصحاب الفيل أي الجيش الذي سار لهدم الكعبة، ومعهم الفيل وما كان من انهزامهم بما سلطه الله عليهم من جماعات الطير ترمي العدو بحجارة من سجيل، وتفسير السجيل، طين يابس أو متحجر. وورد ذكر السجيل أيضا في القرآن في سورة الحج، قال تعالى: "وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مّن سِجّيلٍ" [الحجر: 74]، أي على قوم لوط، وقوله سبحانه: "وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مّن سِجّيلٍ مَّنْضُودٍ" [هود: 82]. وقد فتكت هذه الأحجار الصغيرة بالجيش الهاجم فعاد مهزوما من غير أن يبلغ مأربه. وجعلهم كعصف مأكول أي كورق زرع تأكله الدواب، فلما أصيبوا بهذه الحجارة تساقطت لحومهم، قطعا صغيرة تلو الأخرى. وعن هذا الحدث يروي "الطبري" أن الحبشة ملكوا اليمن بعد حمير، فلما صار المُلك إلى أبرهة بن الصباح الأشرم، بنى كنيسة عظيمة بصنعاء يقال لها "القليس"، وقصد أن يصرف حج العرب إليها ويبطل الكعبة، فلما تحدث العرب بذلك غضب رجل من النّساءة من بني فقيم بن عدي بن عامر بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر، فخرج هذا الكناني حتى أتى "القليس" وأحدث فيها، ثم خرج فلحق بأرضه، فلما أُخبر بذلك أبرهة غضب وحلف ليسيرن إلى البيت حتى يهدمه، فجهز جيشا جرارا، ووضع في مقدمته فيلا مشهورا عندهم يقال أن اسمه "محمود". فعزمت العرب على قتال أبرهة، وكان أول من خرج للقائه، رجل من أشراف اليمن يقال له ذو نفر، دعى قومه فأجابوه، والتحموا بجيش أبرهة، لكنه هُزِم وسيق أسيرا إلى أبرهة(0). ثم خرج نفيل بن حبيب الخثعمي، وحارب أبرهة، فهزمهم أبرهة وأخذ نفيل أسيرا، وصار دليلا لجيش أبرهة، حتى وصلوا للطائف، فخرج رجال من ثقيف، وقالوا لأبرهة أن الكعبة موجودة في مكة حتى لا يهدم بيت اللات الذي بنوه في الطائف، وأرسلوا مع الجيش رجلا منهم ليدلهم على الكعبة، ويقال إن اسمه "أبو رغال" توفي في الطريق، فصار قبره مرجما عند العرب، لقول الشاعر:
وأرجم قبره في كل عام *** كرجم الناس قبر أبي رغال
ويشير "الطبري" إلى أن أبرهة - حين وصوله إلى الطائف - بعث رجلا من الحبشة، وهو الأسود بن مقصود، إلى مكة فساق أموال أهلها وأصاب فيها مائتي بعير لعبد المطلب بن هاشم وأحضرها إلى أبرهة، وأرسل أبرهة حناطة الحميري إلى مكة، وقال له: سل عن سيد أهل هذا البلد وشريفهم، فسأل فقيل له عبد المطلب، فقال له: إن الملك يقول إني لم آت لحربكم إنما جئت لهدم هذا البيت، فقال له عبد المطلب: والله ما نريد حربه ولا لنا بذلك طاقة، هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم، فإن لم يمنعه منه فهو بيته وحرمه وإن يخل بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع عنه. ثم انطلق عبد المطلب مع رسول أبرهة إليه فلما استؤذن لعبد المطلب قالوا لأبرهة: هذا سيد قريش فأذن له فلما رآه أبرهة أجله وأكرمه عن أن يجلسه تحته، وكره أن تراه الحبشة معه على سرير ملكه فنزل أبرهة عن سريره فجلس على بساطه وأجلسه معه عليه إلى جنبه، ثم قال له: ما حاجتك؟ فذكر عبد المطلب بعيره التي أخذت له، فقال أبرهة: قد كنت أعجبتني حين رأيتك، ثم زهدت فيك حتى كلمتك، أتكلمني عن مائة بعير أصبتها لك، وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جئت لهدمه لا تكلمني فيه؟ قال له عبد المطلب: أنا رب الإبل وإن للبيت ربا سيمنعه، فرد أبرهة على عبد المطلب الإبل، وانصرف عبد المطلب إلى قريش فأخبرهم الخبر، وأمرهم بالخروج من مكة والتحرز بالجبال(0). وتهيأ أبرهة وجيشه لدخول مكة، ومعهم فيل يدعى "محمود"، فكانوا كلما وجهوه إلى مكة برك ولم يبرح مكانه، وإذا وجهوه يمينا أو شمالا قام يهرول. فسلط الله تعالى عليهم جنوده جماعات من الطير تقذفهم بالحجارة، لا تصيب منهم أحدا إلا وأهلكته، فجعلهم الله كعصف مأكول، أي "كورق الشجر الذي عصفت به الريح، وأكلته الدواب ثم راثته"(0).
إن لهذا الحدث دلالات جمة، نقف من خلالها على عظيم صنيع الخالق جل علاه، وعلى قداسة الكعبة المكرمة، فلم يكل الحق سبحانه حماية بيته إلى المشركين من قريش، رغم اعتزازهم بهذا البيت وحمايته واحتمائهم به، فلما أعلن الله غيرته على بيته الحرام، ترك المشركين يهزمون أمام القوة المعتدية أبرهة وجيوشه، حتى لا يكون للمشركين فضل في الذود عن بيته، بحميتهم الجاهلية وعصبيتهم العنصرية. وبانهزام أبرهة الحبشي، كما أسلفنا، حفظ الله بيته الحرام من أن يهدم، وصار فيما بعد قبلة للمسلمين على وجه الأرض. فكان هذا الأمر، من تدبير الله لبيته ولدينه، وإرهاصا بنبوة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وعمره عند بعض المفسرين لم يتجاوز الخمسين ليلة بعد.
وتأسيسا على ما تقدم، تكون الرؤية التي وردت في سياق الآية الكريمة، "ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل"، رؤية علمية، بموجب الخطاب الإلهي، فالنبي الكريم لم ير أصحاب الفيل، ولا الفيل، ولا الطير الأبابيل. لقد أضحى حدث الفيل معروفا ومتواترا لدى العرب، حتى إنهم جعلوه مبدأ تاريخ يحددون به زمن الأحداث والوقائع. ومما تقوله العرب؛ ولد عام الفيل، وحدث كذا لخمس أو سبع سنوات من بعد عام الفيل، ... وما نحو ذلك. ولأهمية هذا الحدث صارت العرب تؤرخ به، وقد كانت قبله تؤرخ السنين بموت قصي بن كلاب لعلو شأنه وشرف مكانته.
ومهما يكن من أمر، نتبين أن ما حدث في عام الفيل لم يكن إلا مقياسا لحقيقة القوة الإلهية الجبارة، والباطشة، والمهلكة، والمدمرة لمن أراد بحرمات الله ضرا وأذى. وبموجب هذا التدخل من القدرة الإلهية لحماية البيت الحرام، بادرت قريش إلى الدخول في دين الله حين جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيقنت أن الذي أنقذها ليس أصنامها بل التدخل الإلهي، وأن اعتزازها بالبيت وسدانته، وما صاغوا حوله من وثنية، لم يكن مانعا لها من الدخول في دين الإسلام.
الخاتمة:
إن ما تجدر الإشارة إليه مؤداه أن "محمد بن جرير الطبري" الذي اعتمدنا تفسيره للقرآن الكريم - في محاولة منا للإمساك بالحدث المقدس واستكناه عجيب هذا الحدث - يعتبر حجة ثقة فيما يروي، غير أنه كثيرا ما يذكر روايات ضعيفة أو باطلة، مكتفيا بإسنادها إلى رواتها الذين كان أمرهم معروفا في عصره، فقد ألف كتابه "جامع البيان عن تأويل آي القرآن" على طريقة المحدثين، ناهيك عن كتاب "تاريخ الأمم والملوك"؛ فالكتاب الأول المعروف ب "تفسير الطبري" نجد فيه الكثير من الشروحات المسهبة والمستفيضة التي كرسها "الطبري" لتغذي تأملات المسلمين وخيالهم عبر قرون عديدة. فالكتاب من حيث قيمته الكبرى غير قابل للمضاهاة مع تفاسير غيره من المفسرين؛ كتفسير "فخر الدين الرازي"، وتفسير "الزمخشري"، وتفسير "القرطبي"، فهو وثيقة من الدرجة الأولى بالنسبة لعلم التاريخ، ومعتمد لدى المسلمين، أو غيرهم من علماء الإسلاميات الغربيين.
ومن خلال هذه الشروحات المتسمة بالإطناب، التي تفرد بها "الطبري" دون غيره من المفسرين للقصص القرآني، يمكن الوقوف على بعض السمات المميزة والملامح الأساسية للتفسير الإسلامي التقليدي، وفي هذا الصدد نسوق ما أورده "محمد أركون" حين تطرقه إلى الحديث عن التفسير الإسلامي التقليدي، الذي خصه بمجموعة من السمات نستشفها من هذا المقول "لن نقترف مغالطة تاريخية إذا ما وصفنا التفسير الإسلامي التقليدي بأنه تاريخوي، علموي، بل وحتى مادي، بمعنى أن كل كلمة من كلمات الخطاب القرآني تمتلك بالضرورة عائدا موضوعيا، أو مرجعية موضوعية موجودة في الخارج أو في الواقع الخارجي، إنه لصحيح القول بأنهم يلجأون إلى الحكايات الأسطورية من أجل البرهنة على صحة كل كلمة، أو كل آية من آيات القرآن، أو من أجل إثبات حقها، وهم يعتبرون الحكايات الأسطورية بمثابة معطيات تاريخية، أو جغرافية، أو كوزمولوجية، أي متعلقة بعلم الكونيات. فالأبطال الحقيقيون من أمثال "غلغاميش" ينظر إليهم وكأنهم شخصيات واقعية، حقيقية"(0)، ذلك أن المفسرين في الغالب ما يلجأون إلى الحكايات الأسطورية وإلى أبطالها الملحميين، على أساس أنهم شخصيات واقعية، أو تاريخية، فحتى إذا أخذنا الكائنات غير المرئية كالملائكة والجن والشياطين، نجد أنها قد خلعت عنها صفة اللامادية، وارتدت لباس المادية والواقعية، فصارت لا تختلف عن البشر في شيء، إن سلوكا أو تصرفا أو قولا. لذلك، فلا ضير إن رأينا "الطبري" يستشهد بالحكايات الأسطورية للبرهنة على صحة ما ورد في القرآن الكريم من قصص، بل وأحيانا، يذهب أبعد من ذلك إلى سرد أشياء ونسبتها إلى أشياء أخرى، لا علاقة لها بالحقيقة التاريخية.
وأما الكتاب الثاني المعروف ب "تاريخ الطبري" يعد من أهم المصادر في مجال التاريخ، إذ بلغت فيه الرواية مبلغها من الثقة والأمانة، فقد أكمل ما قام به المؤرخون قبله، على سبيل المثال؛ "اليعقوبي"، و"البلاذري"، ومهد لمن جاء بعده؛ "المسعودي"، و"السيوطي"، و"ابن مسكويه"، و"ابن خلدون"، ولم يقتصر على تاريخ الإسلام، بل أرخ لما قبل الهجرة، إذ ابتدأ من القول في ابتداء الخلق بذكر الأدلة على حدوث الزمان، وأول ما خلق بعد ذلك القلم، ثم ذكر آدم عليه السلام، وما كان بعده من أخبار الأنبياء والرسل على ترتيب ذكرهم في التوراة، معترضا للأحداث التي وقعت في زمانهم، مفسرا ما ورد في القرآن الكريم في شأنهم، معرجا على أخبار الملوك الذين عاصروهم، وملوك الفرس، مع ذكر الأمم التي جاءت بعد الأنبياء حتى بعثة الرسول.
وفيما يخص الشق الإسلامي من الكتاب، فقد رتبه على الأحداث من عام الهجرة حتى سنة ثلاثمائة واثنين، حيث ذكر في كل سنة ما وقع فيها من الأحداث المذكورة، والأيام المشهورة. وترجع قيمة هذا الكتاب إلى المواد والمتون التي أودعها "الطبري" بين ثناياه، مستقيا إياها من كتب الحديث، والتفسير، واللغة، والأدب، والسير، والمغازي، والشعر، والخطب، منسقا بينها تنسيقا مناسبا، وعارضا إياها عرضا ينسب من خلاله كل رواية إلى صاحبها، وكل رأي إلى قائله. كما أورد في "تاريخه" عدة فصول متنوعة من مختلف الكتب التي أتت عليها عوادي الدهر، وضمنه أقوال العلماء ما لا نجده إلا في هذا الكتاب.
ومن ثم، فإن مصادر "الطبري" المعتمدة في كتابيه "جامع البيان عن تأويل آي القرآن"، و"تاريخ الأمم والملوك"، هي كل ما سبقه من المواد التي عرفها العرب من قبله، فقد أخذ من كل متخصص في فنه؛ أخذ التفسير عن "مجاهد" و"عكرمة"، وغيرهما ممن نقل عن "ابن عباس". ونقل السيرة عن "عروة بن الزبير"، و"شرحبيل بن سعد"، و"موسى بن عقبة"، و"ابن إسحاق". وروى أخبار الردة، والفتوحات عن "سيف بن عمر الأسدي"، وأخذ أخبار العرب قبل الإسلام من "عبيد بن شرية الجرهمي"، و"محمد بن كعب القرطي"، و"وهب بن منبه"، وأخبار الفرس عن الترجمات العربية لكتب الفرس، ولا سيما "ابن المقفع"، و"ابن الكلبي". هذا فضلا عن اتباعه طريقة المحدثين بذكر الأحداث المروية، ملحقا إياها بالسند حتى يتصل بصاحبه، وفيما عدا ذلك ينقل من الكتب، فيصرح باسم الكتاب، أو ينقل عن المؤلفين من غير تعيين الكتاب الذي نقل عنه.
النتائج:
يحملنا الوقوف على عجيب هذه الأحداث المقدسة إلى استخلاص ما يلي:
-
أولا: إن القصص القرآني ليس مجرد قصص يسرد أخبارا عن الأولين، وممن هلكوا من الأمم البائدة، "بل هو بيان وبرهان؛ وسيلة في الإقناع تدعو للاحتكام إلى العقل بعيدا عن أساليب اللاعقل"(0)، فضلا عن إيضاح أسس الدعوة إلى الله، وبيان أصول الشرائع التي بعث بها كل نبي، وتثبيت قلب رسول الله وقلوب الأمة المحمدية على دين الله وتقوية ثقة المؤمنين بنصرة الحق وجنده وخذلان الباطل وأهله، وتصديق الأنبياء السابقين وإحياء ذكراهم وتخليد آثارهم، وإظهار صدق محمد صلى عليه وسلم في دعوته بما أخبر به عن أحوال الماضين عبر القرون والأجيال، ومقارعته أهل الكتاب بالحجة في ما كتموه من البينات والهدى، وتحديه لهم بما كان في كتبهم قبل التحريف والتبديل.
-
ثانيا: إن الاهتمام بالقصص القرآني ليس القصد منه، فقط، تمكين عبره في النفوس، بل استعراض قدرات السارد، خاصة، وأن " سرد قصة بشكل حقيقي يعني بالضرورة إدراجها أو دمجها داخل الفضاء الأنطولوجي للحق، بمعنى أن شخصيات القصة، وتصرفاتهم، والأماكن الوارد ذكرها، والأقوال المتبادلة، كلها أشياء صحيحة بحرفيتها. فالله لا يمكنه أن يستخدم الخرافات أو القصص الخيالية لكي يكشف عن أسراره ويبلغ أوامره وإرادته للبشر"(0). فالقصص القرآني أو النماذج العليا للقدوة في السلوك، ميزها القرآن الكريم عن الخرافات، والحكايات، أو ما كان يسميه المكيون ب"أساطير الأولين".
-
ثالثا: إن القرآن يؤكد على صحة القصص والأمثال الواردة فيه، ونموذجيتها. ومن ثمة، فالأحداث المقدسة المضمنة في القصص القرآني تغدو كاشفة عن التعالي، وعن أثر الله في تاريخ النجاة والخلاص، وعن الوظيفة المحركة للوجود التي يطلع بها الخطاب السردي، "وهذا ما يدعى بالوظيفة الوجودية المحركة للخطاب القرآني، ولا ينبغي علينا أن نحذف هذه الوظيفة أو نقلصها عندما يتركز اهتمامنا على الخطاب السردي بشكل خاص"(0).
-
رابعا: إن من خصائص بلاغة القرآن إبراز المعنى الواحد في صور مختلفة، وأن القصة المتكررة ترد في كل موضع بأسلوب يتمايز عن الآخر، بحيث لا يمل القارئ من تكرارها، بل وإنما تتجدد في نفسه معان لا تحصل له بقراءتها في المواضع الأخرى. وهنا تكمن قوة الإعجاز في إيراد المعنى الواحد في صور متعددة، مع اختلاف الغاية التي تساق من أجلها القصة، إذ تذكر بعض معانيها الموفية بالغرض في مقام، وتبرز أخرى في غيرها من المقامات حسب اختلاف مقتضيات الحال.
-
خامسا: إن القصص القرآني سجل يرسم حركة سير التاريخ من خلال اكتشاف العبر التي تستبطنها الأحداث المقدسة وتاريخها المتعالي، أي تلك القوانين المتحكمة في خط سير التاريخ، على أساس، أن لفظ "العبر" المتداول في القرآن الكريم يشير إلى السنن التي تعبر السنين من قوم إلى آخرين، ومن أمة إلى أخرى، ناهيك عن رصد البنيات المشكلة لوعي الإنسان عبر التاريخ، وفهم العلاقة بين وعيه بذاته وبالآخر وبالمقدس، وبين قدرته على إدراك دور الوحي في تصحيح هذا الوعي، قصد إعادة تشكيل الوعي الجمعي الإنساني، والقبض على النماذج التشريعية التي جاءت بها الرسالات السماوية بما يلابسها من أحداث مقدسة سجلها القصص القرآني.
المصادر والمراجع:
- القرآن الكريم برواية ورش عن نافع.
- ابن كثير القرشي الدمشقي: قصص الأنبياء، تحقيق السيد الجميلي، المكتب الثقافي، الأزهر، القاهرة، (د.ت).
- تركي علي الربيعو: العنف والمقدس والجنس في الميثولوجيا الإسلامية، المركز الثقافي العربي، ط 1، بيروت، 1994.
- محمد بن جرير أبو جعفر الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الجزء الثامن عشر، والجزء الواحد والعشرون، والجزء الرابع والعشرون، تحقيق أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط1، 2000.
- محمد بن جرير أبو جعفر الطبري: تاريخ الأمم والملوك، الجزء الأول، دار الكتب العلمية، ط1، بيروت، 1407 هجرية.
- محمد أركون: الفكر الإسلامي قراءة علمية، ترجمة هاشم صالح، مركز الإنماء القومي، بيروت، 1987.
- محمد أركون: القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، ترجمة وتعليق: هاشم صالح، دار الطليعة، ط1، بيروت، 2001.
- محمد عابد الجابري: مدخل إلى القرآن الكريم؛ في التعريف بالقرآن الكريم، الجزء الأول، دار النشر المغربية، ط 1، الدار البيضاء، 2006.
- محمد علي الصابوني: صفوة التفاسير، المجلد الثالث، دار الفكر، بيروت، 2001.
0- محمد أركون: الفكر الإسلامي قراءة علمية، ترجمة هاشم صالح، مركز الإنماء القومي، بيروت،1987، ص131.
0- محمد بن جرير أبو جعفر الطبري: تاريخ الأمم والملوك، الجزء الأول، دار الكتب العلمية، ط1، بيروت، 1407هـ، ص165.
0- ابن كثير القرشي الدمشقي: قصص الأنبياء، تحقيق السيد الجميلي، المكتب الثقافي، الأزهر، القاهرة، (د.ت)، ص156.
0- ابن كثير القرشي الدمشقي: المرجع نفسه، ص157.
0- محمد بن جرير أبو جعفر الطبري: جامع البيان في تفسير آي القرآن، الجزء الثامن عشر، ص511.
0- محمد بن جرير أبو جعفر الطبري: جامع البيان في تفسير آي القرآن، الجزء الواحد والعشرون، ص106.
0- ابن كثير القرشي الدمشقي: قصص الأنبياء، ص275.
0- محمد بن جرير أبو جعفر الطبري: جامع البيان في تفسير آي القرآن، الجزء الثامن عشر، ص517.
0- محمد بن جرير أبو جعفر الطبري: المرجع نفسه، الجزء الواحد والعشرين، ص108.
0- محمد عابد الجابري: مدخل إلى القرآن الكريم؛ في التعريف بالقرآن، الجزء الأول، دار النشر المغربية، ط1، الدار البيضاء، 2006، ص337.
0- محمد بن جرير أبو جعفر الطبري: جامع البيان في تفسير آي القرآن، الجزء الثامن عشر، ص168.
0- محمد بن جرير أبو جعفر الطبري: المرجع نفسه، الجزء الثامن عشر، ص165.
0- محمد بن جرير أبو جعفر الطبري: جامع البيان في تفسير آي القرآن، الجزء الثامن عشر، ص169.
0- المرجع السابق، ص169.
0- المرجع نفسه، ص169.
0- ابن كثير القرشي الدمشقي: قصص الأنبياء، ص533.
0- محمد بن جرير أبو جعفر الطبري: المرجع نفسه، الجزء الثامن عشر، ص177.
0- تركي علي الربيعو: العنف والمقدس والجنس في الميثولوجيا الإسلامية، المركز الثقافي العربي، ط1، بيروت، 1994، ص533.
0- محمد بن جرير أبو جعفر الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الجزء الرابع والعشرون، ص608-609.
0- المصدر السابق، ص611.
0- محمد علي الصابوني: صفوة التفاسير، المجلد الثالث، دار الفكر، بيروت، 2001، ص279.
0- محمد أركون: القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، ص163.
0- محمد عابد الجابري: مدخل إلى القرآن الكريم؛ في التعريف بالقرآن الكريم، الجزء الأول، ص394.
0- محمد أركون: القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، ص: 162.
0- المرجع نفسه، ص154.
| Article Title | Authors | Vol Info | Year |
| Article Title | Authors | Vol Info | Year |