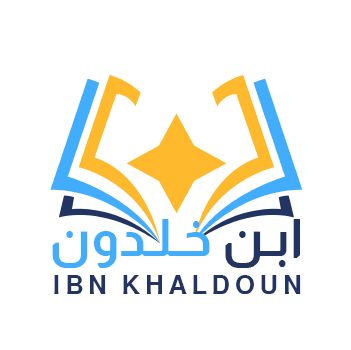2
6
2022
1682060055167_2355
https://drive.google.com/file/d/1hyjRJI6eXw7ka7_g5ERuKOYVomsE1wce/view?usp=drivesdk
نحو نهضة عربية إسلامية معاصرة
Towards a contemporary Arab Islamic renaissance
د. يونس العزوزي: باحث بالمركز المغربي للدراسات والأبحاث التربوية بالرباط المغرب، وأستاذ زائر بالمدرسة العليا للأساتذة بتطوان المغرب.
Abstract:
This study seeks to identify the historical definition of the Arab-Islamic Renaissance, its contexts and the reasons for its occurrence, whether political, religious, reformist or other, and to identify the most prominent pioneers, discuss their ideas, and follow their methods, with careful consideration of the reform projects that they led in critical historical stages, aimed at reviving the Arab and Islamic nation from its slumber. The study relied on combining an integrated synthesis of research curricula, especially the descriptive analytical approach, the inductive approach, and the comparative approach. The study concluded that the Arab and Islamic nation is still in a renaissance. and awakening, as long as it seeks to achieve the same goals that the previous Arab renaissance sought, and It has not yet been achieved, and it finally recommended a set of recommendations, foremost of which is the importance of gathering the efforts of the political actor, the thinker, the educational actor, the religious reformer, the world of technology and other pioneers, and their working with a clear scientific method, based on bringing up the outcomes of the previous reforms without relying on them, and looking ahead to the future with its challenges and prospects.
Keywords: Renaissance, Arab Renaissance, contemporary Renaissance, reform.
المقدمة:
عاش المجتمع العربي في ظل الحضارة الإسلامية في أوج ازدهارها وتقدمها، ومنذ حوالي قرنين من الزمن وهو يخلد مرحلة تاريخية من تاريخ العرب والمسلمين للنهوض من التخلف والفقر والركود والتشتت الذي انتشر منذ قرون، حتى أضحى مفهوم النهضة العربية يحتل موقعا بارزا ضمن اهتمامات مفكري وسياسيي الأمة العربية والإسلامية في الوقت الراهن، وما صاحبه من قلق وحزن عميق على ما آلت إليه أوضاع بلاد العروبة والإسلام خلال قرون مضت، وحيرة للناظر إلى الأزمة الثقافية والفكرية التي تعيشها الأمة العربية والإسلامية، هل هي نتاج تفريطنا في تراثنا العربي والإسلامي، وتخلينا عن روح التجديد والاستنارة، أم راجعة إلى غياب الرؤية الموضوعية الصائبة نحو هذا التراث واستثماره على الوجه الأمثل.
أما عن مناهج البحث العلمي المعتمدة في إنجاز هذه الدراسة، فقد تنوعت بتنوع مباحثه وفقراته، وجمعت بين المنهج الوصفي التَّحليلي، عند الحديث عن النهضة العربية والإسلامية، ويتجلَّى استخدامه في وصف وتحليل أهم مضامين ومُرتكزات هذه النهضة، من حيث أعلامها وأفكارها ومدارسها ومناهجها وآفاقها، وعلاقتها بتطور الأمة الإسلامية وببناء الحضارة الإنسانية، والمنهج المقارن، من خلال الحديث عن آثار النهضة العربية الإسلامية في بناء الحضارة الإسلامية والإسلامية، ومن خلال الحديث عن أعْلام هذا التأثير والمقارنة بينهم، كما حضر المنهج الاستقرائي، خصوصا في استقراء آراء مجموعة من المفكرين والرواد العرب والمسلمين بشأن الصحوة المنشودة، ورصد أبرز مُبادراتهم وأفكارهم ومشاريعهم في الواقع، والوصول منها إلى نتائج وخلاصات عامة عن واقع النهضة العربية الإسلامية وآفاقها وتحدِّياتها.
وتظهر أهمية الكتابة في هذا الموضوع في محاولة تجديد منهج التطور والنهوض لإحياء الماضي العظيم ومنحه الحيوية والحياة، يكون منطلقا لوضع مرتكزات علمية لمسايرة التحولات والتطورات التي يعيشها العالم اليوم، بل والإسهام فيها والتأثير فيها في مختلف المجالات، خاصة أن ديننا علمنا وأرشدنا إلى الإرتكان إلى العلم والعمل، ورسولنا العظيم محمد صلى الله عليه وسلم سلم للأجيال المتلاحقة من بعده بأنهم أعلم بأمور دنياهم، داعيا إياهم إلى الاستناد إلى العلم في حالة إذا لم يجدوا في القرآن الكريم أو السنة المشرفة أو أقوال وأفعال السلف الصالح، خاصة إذا استحضرنا أن الأمة الإسلامية لا تموت، وأن العقل الإسلامي ينبض بالحيوية، وأن الله عز وجل سخر لهذه الأمة عقولا ظلت حية عبر الأجيال، من أمثال أبي حامد الغزالي (ت: 1111م) وبن رشد (ت: 1126م) والعز بن عبد السلام (ت: 1262م) وشيخ الإسلام بن تيمية (ت: 1328م) وبن خلدون (ت: 1401م) وغيرهم كثير، الذين سلكوا مسلك السلف الصالح اعتمادا على العقل لإرساء العدل ومحاربة الظلم بالعلم، ومن بزغ نجمه في العصر الحديث، وبعثه الله لينقذ الأمة من هاوية محزنة كانت تعيش في ظلماتها، ومنهم الشيوخ الأجلاء رفاعة الطهطاوي (ت: 1873م) وخير الدين التونسي (ت: 1890م) وعلي مبارك (ت: 1893م) وعبد الرحمن الكواكبي (ت: 1902م) ومحمد عبده (ت: 1905م) وعبد الحميد بن باديس (ت: 1940م) وعلال الفاسي (ت: 1974م) وغيرهم كثير، دون أن نغفل ما تزخر به الامة المعاصرة في الوقت الراهن من طاقات علمية وقامات فكرية، طبعت مختلف مجالات الفكر بآرائها الرائدة، والتي تشكل في حد ذاتها مدرسة لتعليم مبادئ وأسس الصحوة الإنسانية بمختلف أبعادها.
وسعيا منا إلى استنهاض الأمة من كبوتها الحضارية، وإزاحة بعض من موجات الجهالة وأستار الظلام عن بصرها، وتحفيزها لصياغة مشاريع خلاقة ومبدعة وجديدة لنهضة معاصرة، تأخذ بأسباب العصر وتنطلق من روح تراثنا العربي والإسلامي العريق، جاعلة من ديننا الحنيف هاديا ومرشدا لهذه المشاريع النهضوية، سنحاول مقاربة هذا الموضوع انطلاقا من تدقيق إشكاليته عبر طرح مجموعة من الأسئلة الفرعية، والتي ستشكل الإجابات عنها موجهات للصحوة العربية والإسلامية القائمة، وهي:
-
ما النهضة العربية والإسلامية؟
-
وما هو سياقها التاريخي؟
-
وما هي أسباب حدوثها في الوطن العربي والإسلامي؟
-
ومن هم أهم روادها وصانعو أمجادها؟
-
وما هي الدروس المستفادة منها لقيام نهضة عربية إسلامية معاصرة، تهم مختلف مناحي الحياة؟
المبحث الأول: سياقات النهضة العربية والإسلامية وأسبابها: -
مفهوم النهضة:
النهضة في اللغة من نهض ينهض نهوضا، والنهوض البراح من الموضع والقيام منه، ونهض نهضا ونهوضا، وانتهض أي قام، والنهضة الطاقة والقوة(0)، وفي الاصطلاح هي نظرية الصعود إلى الأعلى أو هي اتصال مجتمع إلى مستوى الحضارة الكونية(0)، والخلاصة أن النهضة هي نتيجة لعملية النهوض، وهي الحالة التي يستطيع فيها مجتمع ما التخلص من المعوقات والقيود التي تعيقه من الانطلاق(0).
يوصف عصر النهضة بعدة مسميات، فتارة يسميه المهتمون بالنهضة وتارة باليقظة(0)، وتارة بالإصلاح، وعبر عنها الشيخ يوسف القرضاوي بالصحوة، من صحا من نومه أو من سكره، بمعنى أنه استعاد وعيه بعد أن غاب عنه، فهي عنده تعني عودة الوعي والانتباه، وعبر عنها أيضا باليقظة في مقابل الرقود أو النوم الذي أصاب الأمة الإسلامية في عصر التخلف والركود، كما عبر عنها أيضا بالبعث، وهو أيضا يكون بعد النوم(0)، فهي ظاهرة واقعة حقيقة ليست غريبة على طبيعة الإسلام وأمته، بل الغريب حقا حسب تعبيره ألا تكون، ومن خصائصها أنها نهضة عقل وعلم، و قلوب ومشاعر، والتزام وعمل(0).
-
سياقها التاريخي:
النهضة العربية ليست وليدة المفاجأة، بل وليدة عمل متواصل لعدد هائل من العلماء والساسة والمجددين، اختلفوا وتفاوتوا في الزمان والمكان والفكر، عمل جاد فرادى وجماعات في النوادي والجمعيات والمساجد وبين دفاف الكتب والصحف والمجلات، وقد تغذت النهضة العربية والإسلامية من الينبوع الأصلي وهو القرآن الكريم والسنة الشريفة بما يكفي لإيقاظ النفوس لبناء مجتمع على أساس القيم الإسلامية السمحة، بالإضافة إلى ينبوع الأدب العربي والمأثور من كثير نظمه ونثره، وينبوع التاريخ العربي الإسلامي، الذي يترجم أمجاد الأمة وفتوحاتها وحروبها، والحافظ لما أبدعه العرب من الثقافة والحضارة عند تأسيسهم لهذه الامبراطورية المترامية الأطراف، إلى أن بلغت الحضارة الإسلامية أوجها في العصر العباسي الذهبي إبان القرن التاسع الميلادي، إلى أن هاجمتها الوثنية في فرق الباطنية والمانوية والمزدكية المشككة في الأديان لهدمها من داخلها، وفرق التجسيم والحلولية وتأليه البشر، مما فتح المجال لعودة عبادة الأصنام ونشوء فرق الحلول، إلى أن تمزقت رقعة الامبراطورية العباسية الإسلامية، بتدفق جيوش التاتار وهجومهم على بغداد، يهدمون القرى ويخربون المدن والصحاري والأرياف، يحكمها أمراء من الفرس والمغول والترك والمماليك، إلا أن التراث العربي الإسلامي المتمثل في القرآن الكريم والسنة المطهرة َوالأدب والتاريخ ظل خالدا يحرص هذه الثقافة، في انتظار من يأخذ بيدها ويحييها ويجعل منها منطلقا لإقامة حضارة جديدة(0).
يرجع بعض الباحثين ظهور النواة الأولى لليقظة العربية إلى شيخ الإسلام بن تيمية(1263م- 1328م)، الذي ركز في إصلاحاته على الجانب الفكري والعقدي كما على الجانب السياسي، وآخذ علماء عصره على الجمود والتقليد وحثهم على الاستنباط والتشريع الذي يوائم الزمن(0). ويرجع فهمي جدعان في كتابه أسس التقدم عند مفكري الإسلام البدايات الأولى للنهضة العربية الإسلامية إلى عصر ابن خلدون (ت: 1406م) بقوله: " وقد وضع فكر ابن خلدون نهاية وحدا لحالة الانحطاط الفكري والحضاري، وذلك بفضل وعيه لواقعة الانحطاط، وبحثه عن الأسباب الواقعة المشخصة لها، كما مثل بداية اليقظة والنهوض بسبب هذا الوعي ذاته"(0)، لينطلق البحث عن الذات حسب رأيه مع "واقعة الاتصال بالمدنية الغربية التي خلقت حالة التوتر الثقافي والعقلي النامي باطراد"(0) ، في إشارة إلى استعمار الغرب للشرق مع حملة نابليون على مصر، ويؤرخ لهذا العصر زمانيا بشكل دقيق، ويقسمه إلى ثلاثة مراحل، "المرحلة الأولى التي بدأت في أواخر القرن التاسع عشر وامتدت إلى أوائل القرن العشرين(1875-1914)...والمرحلة الثانية تمتد بين الحربين العالميتين، والمرحلة الثالثة تبدأ مع نهاية الحرب العالمية الثانية(0) .
ويرجع آخرون ظهور النهضة العربية مع الامبراطورية العثمانية في عهد السلطان أحمد الثالث (1703م- 1730م) ، والسلطان محمود الأول(1730م- 1754م)، والسلطان سليم الثالث (1789م- 1807م)، حيث عرفت هذه المرحلة دخول فكر ومبادئ الثورة الفرنسية وإدخال إصلاحات على الأسطول العثماني وإنشاء المدارس الحربية، بالإضافة إلى إرسال بعثات علمية إلى فرنسا(0). في حين يرى آخرون أن الانطلاقة الحقيقة للنهضة العربية كانت مع انهيار الامبراطورية العثمانية، ونضج الظروف الموضوعية لقيام الثورات العربية المتعاقبة على الامبراطورية وعلى الفرنسيين معا(0). ويحصر صلاح زكي أحمد في كتابه أعلام النهضة العربية الإسلامية في العصر الحديث بين عهد عبد الرحمن الجبرتي (ت: 1825م) ورفاعة الطهطاوي (ت: 1873م) إلى عهد مالك بن نبي (ت: 1973م) وعلال الفاسي (ت: 1974م) ، واصفا إياهم بأعلام النهضة العربية الإسلامية في العصر الحديث(0).
ومن الناحية التاريخية بدأت النهضة العربية الإسلامية تتضح مع الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليون بونابارت(1798م) ، حيث جلب معه العديد من المختصين والعسكريين والطابعة وغيرها من أدوات النهوض، وقيام محمد علي حاكم مصر (1805م- 1846م) بعد خروجهم منها بإرسال بعثات إلى فرنسا للاستفادة من العلوم والمعارف الغربية الجديدة، وفي عهد السلطان عبد الحميد (1876م- 1909م) الذي قام بشتات الخدم للمسلمين وللدولة العثمانية، وأشاد المكاتب العالية والمدارس الراقية وحسن نظامات الحكومة(0) ، ويعتبر الكثيرون أن بداية النهضة العربية كانت مع هذه الأحداث، وأبرزهم ألبرت حوراني في كتابه الفكر العربي في عصر النهضة، الذي يحصرها بين أوائل القرن التاسع عشر وبداية الحرب العالمية الثانية، إلا أنه يؤرخ لسيرة كتاب ومفكرين لما بعد هذه الحرب(0) ، وعلي المحافظة من خلال كتابه الاتجاهات الفكرية عند العرب، فاعتبروا أن حملة نابليون على مصر كانت صدمة نبهت العرب إلى تخلفهم عن محتليهم(0). وفي الوقت الذي نجد فيه أحمد أمين (ت: 1954م) قد حصر النهضة العربية الإسلامية في كتابه زعماء الإصلاح في العصر الحديث بين محمد بن عبد الوهاب (ت: 1891م) وعبد الرحمن الكواكبي (ت: 1902م)(0)، نجد أن صلاح زكي أحمد يعده من النهضويين العرب والمسلمين، ويصفه بأنه باني صرح الثقافة الإسلامية، بمشروعه الرائد الجامعة الشعبية، وتأسيسه لجنة التأليف والترجمة والنشر(0).
ورغم الاختلاف القائم حول البدايات الحقيقية للنهضة العربية، إلا أن مرحلة بداية النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين كانت حافلة بحركات فكرية وسياسية وإصلاحية قوية، لوجود رواد آنذاك استطاعوا التعرف على أوضاع المجتمع العربي في تلك الفترة، المتسمة بالركود في بنياته الاقتصادية والاجتماعية، وبالجمود في بنياته الفكرية، خاصة مع دخول العالم العربي في مرحلة اصطدام مع أوربا الامبريالية، مما ولد صراعا تاريخيا شمل مختلف أوجه الوجود التاريخي العربي الفكري والوجداني(0).
وعليه، فإن عصر النهضة العربية والإسلامية في نظرنا يشير إلى الفترة الممتدة من هجوم نابليون بونابارت على مصر 1798م، ويمتد إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية بعقد أو عقدين من الزمان.
-
أسباب حدوث النهضة في الوطن العربي والإسلامي:
يرجع الدكتور يوسف القرضاوي أسباب حدوث الصحوة العربية كما يسميها إلى طبيعة الإسلام وطبيعة الأمة الإسلامية التي لا يطول غيابها، بل الإسلام يوقظها من سباتها ويحييها من مواتها بالعلم والعمل، ويرغبها في الفكر والنظر، ويحرضها على الكفاح والجهاد، فاستطاعت الأمة الإسلامية أن تتغلب على عوامل الضعف من الداخل، وعوامل الغزو من الخارج، وأن تحول الهزائم إلى انتصارات، وأن تخلق من الضعف قوة ومن التفرق وحدة(0) .
وأشار الأمير شكيب أرسلان في محاضرة ألقاها سنة 1938م في المجمع العلمي العربي بدمشق إلى أن الأسباب والدوافع التي كانت حافزا على بروز النهضة العربية في بداية القرن العشرين تكمن في الصحافة، والحركات العلمية، والمدارس، والمجمعات العلمية، وظهور بوادر النهضة العربية ببلاد الشام ومصر والمغرب العربي(0)، ويشاطره الرأي الدكتور علي المحافظة في تحديد عوامل النهوض الفكري العربي والإسلامي(0).
ويرجعها آخرون إلى الاصطدام التاريخي بين العرب والمسلمين مع الحضارة الأوربية الامبريالية، ما نتج عنه وعي عربي بين الذات ممثلة في دار الإسلام الممزقة، وبين الآخر ممثلا في أوربا القوية المتقدمة المستعمرة(0)، وقد شكل التفكك الاجتماعي والابتعاد عن الإسلام بالإضافة إلى تأخر العرب عن الغرب سياسيا ومعرفيا واجتماعيا أسبابا أخرى أدت إلى ظهور الفكر النهضوي في البلاد العربية والإسلامية في هذه الفترة بالذات.
كما لعب الاستشراق والمستشرقون دورا هاما في إذكاء روح اليقظة العربية، من خلال فتح أعين الغرب على ذخيرة العرب الوافرة في ميدان الفكر والمعرفة، واندفاعه نحو الاستفادة منها، فدخلوا مدارس الأندلس وتخرجوا منها علماء وملوكا وأمراء، حتى دعتهم الحاجة إلى إنشاء مدارس للترجمة، فترجموا ونشروا، وظهر مستشرقون برعوا في ذلك من الفرنسيين والانجليز والإيطاليين وغيرهم. لقد شكل الاستشراق والمستشرقون طريقة جديدة لإيقاظ شعور العرب والتنبيه على مآثرهم، وأنهم أمة ذات ماضي مجيد، يحق لها أن تنال به السيادة لا أن تكون مسودة(0).
كما لعبت الجمعيات الأدبية دورها في اليقظة الفكرية بالعالم العربي والإسلامي، خاصة منها الجمعية السورية (1847م) التي أنشأت لغرض نشر العلوم وترقية الفنون بين أبناء الأمة العربية، والجمعية العلمية السورية(1857م) التي سارت على نهج الجمعية السورية، وخالفتها في ضمها لمسلمين ومسيحيين، واعترفت بها الدولة العثمانية رسميا، وانتظم فيها عدد كبير من رجال الفكر والسياسة والأستانة، وكانت مظهرا من مظاهر الوعي القومي، تنضاف لها الجمعية الخيرية(1868م) ، أسست لطبع الكتب النافعة في التاريخ والفقه وغيرها، والجمعية الخيرية الإسلامية في الإسكندرية (1878م) التي كانت علمية أدبية، كان الدافع إلى تأسيسها ما رآه المصريون من تأخر حالهم، فكان همها فتح المدارس وتعليم البنين والبنات وتهذيب الأخلاق(0) .
ولا يقل دور الصحافة أهمية في بعث اليقظة العربية والإسلامية، إذ عرفت الصحافة بمصر كباعث من بواعث النهضة مع دخول نابليون، وإنشائه لجريدتين تصدران باللغة الفرنسية هما جريدة Le décade égyptien تنشر أبحاث المجمع العلمي وما يدور من مناقشات بين أعضائه، وتصدر كل 10 أيام، والثانية هي جريدة Le courrier de l'Égypte، وهي اللسان الناطق للحملة الفرنسية، وتصدر كل أربعة أيام. كما أنشأ محمد علي باشا جريدة عربية سميت الوقائع المصرية بعد جلاء الفرنسيين عن مصر، تصدر باللغة العربية والتركية، ثم تلتها عدة جرائد منها جريدة الأحوال (1855م) وجريدة الأخبار (1858م) وجريدة الجوائب (1860م)، واتسعت الحركة الفكرية اتساعا مدهشا استلزم الخوض في شؤون الدولة العامة من حيث الإصلاحات السياسية والاجتماعية والتربوية وغيرها(0).
وصفوة القول، فإن النهضة العربية الإسلامية تأثرت بعوامل داخلية مرتبطة بالأوضاع الدينية والاجتماعية والسياسية التي عاشها المجتمع العربي المسلم، والمتسمة بالجمود والركود والتقليد، وبعوامل خارجية مرتبطة بالآخر كالحملة الفرنسية على مصر والبعثات والطباعة والصحافة والاستشراق وغيرها، كانت كفيلة باستنهاض مجموعة من أجلة العلماء والمصلحين، الذين أيقظوا في كتاباتهم وخطبهم وأحاديثهم كوامن العزة في النفوس، ودفعوا الأمة إلى التفكير والإنتاج الفكري والحرية والاستقلال.
المبحث الثاني: أبرز رواد النهضة العربية الإسلامية وأفاق الاستفادة منها لقيام نهضة معاصرة -
رواد النهضة العربية والإسلامية:
تفطن علماء الأمة إلى تفوق الغرب على المسلمين في ميدان العلم والأدب، وفي ميدان العمران، وسبقوهم في الاختراعات الجديدة والصنائع النفيسة، ووعوا أن رقي الأمة الكريمة رهين بأن تتحدى خطوات هؤلاء الأوربيين، وتسير على المحجة التي ساروا عليها، مختارين من مدنيتهم صالحها ونافعها، مما لا يخالف آداب قرآننا الكريم، تاركين مفاسدهم المنافية لآدابنا وشريعتنا السمحاء(0).
ولما كان المسلمون بإجماع العالم الإسلامي في عصر نهضة جديدة، بهدف رقي أبناء هذا الدين الحنيف، وجب أن يكون التفكير في مدى شمولية هذه النهضة لإصلاح شأن المسلمين من داخليتهم وخارجيتهم، من خلال التبشير بما في القرآن الكريم بنفس الاهتمام الذي يبذله المبشرون بديانات أخرى، حتى يصبح الإسلام الدين الغالب في العالمين. ولما كان الأمر كذلك، فقد عرف عصر النهضة العربية والإسلامية بروز تيارات فكرية مختلفة، منها التيار الديني والتيار القومي والتيار الليبرالي والاشتراكي وغيرها، وزخر بعدد كبير من الرواد النهضويين الذين لم يحصروا دورهم على مجال دون آخر، بل كانت همومهم سياسية واجتماعية ودينية وفكرية، عولجت في كليتها، إضافة إلى قضايا الوحدة العربية والجامعة الإسلامية، والوقوف في وجه الاستبداد والمطالبة بالشورى والديمقراطية(0).
ونظرا لكثرة هؤلاء النهضويين العرب والمسلمين، وتباين تياراتهم الفكرية حسب زمان ومكان بروزهم، فسنقتصر على عينة منهم ستشكل نماذج لما كانت عليه أحوال النهوض والاستنهاض في بلاد العروبة والإسلام، ومنهم:
-
محمد بن عبد الوهاب (1696م- 1791م): تعتبر حركة محمد بن عبد الوهاب أول حادث هز حبل الارتباط بين الدولة العثمانية والبلاد العربية، فبعد رحلة علمية طويلة وشاقة، أخذته إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وصولا إلى البصرة فبغداد ثم كردستان فهمدان فأصفهان، عاد إلى بلدته وانزوى في منزله مدة من الزمن، ليخرج على الناس يدعوهم ويبشرهم، ويستهزئ بالأفعال الوثنية المنتشرة في البلاد الإسلامية، ويدعوهم إلى التوحيد وإلى كلمة لا إله إلا الله، مستدلا بالقرآن الكريم والحديث الشريف، ويشرح أدلته شرحا وافيا يحاول فيه صدق الحجة والإقناع(0). لقد أدرك تمام الإدراك سر انهيار الدولة الإسلامية، ووجد مفتاحها السري في تبديل العقيدة، منطلقا من قوله تعالى: { إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ }[الرعد:11، في زمن أحاطت الأشواك بالتوحيد الذي هو مزية الإسلام الكبرى، بفعل مخلفات المانوية والمزدكية والباطنية والقرامطة وغيرهم، فصدع بقوله تعالى: {وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا}[النساء:36]، ولهذه الدعوة سمي أتباعه بالموحدين والوهابيين نسبة إليه، فهو ليس مذهبا جديدا في الإسلام بقدر ما هو دعوة إلى الرجوع إلى أصوله الصحيحة(0). إن اعتكاف محمد بن عبد الوهاب على كتب بن تيمية دراسة وتحليلا وكتابة، مكنه من امتلاك هذه الروح السامية التي خرج بها على الناس ليسمو بنفوسهم من التعلق بالأرواح والأشباح والأضرحة والشجر والحجر وغيره، سالكا في ذلك نفس مسلك أستاذه بن تيمية في توجيه الناس إلى عقيدة التوحيد وإلى النهوض من حضيض الذلة إلى قوة العزة والإيمان الخالص لله عز وجل(0). إن هذه الحركة رغم ما عانته من ضيق وصعاب، إلا أن قوتها لازالت ضاربة إلى وقتنا الحاضر، بفتحها لأفق جديد لكافة المسلمين في جميع أنحاء المعمور، فلا نكاد نجد حركة من حركات الإصلاح إلا وكان مرجعها ما نادى به محمد بن عبد الوهاب في أواخر القرن 18م وأوائل القرن 19م(0).
-
محمد علي باشا واليقظة الفكرية (1769م- 1849م): لقد نال العالم العربي والإسلامي حظه من موجة اليقظة الفكرية والعلمية التي سادت العالم برمته إبان القرن 19م، وخاصة منه مصر التي كانت تحت سلطة الدولة العثمانية، وبجلاء نابليون عن مصر فتحت لها آفاق نشوء دولة فتية في نهضة شاملة، وقد ساهم في هذه النهضة مختلف أطيافها السياسية والفكرية والعلمية، ومنها والي مصر الذي ساهم في نشر المعرفة بإرسال البعثات العلمية إلى أوربا لتحقيق هذه النهضة، معتمدا من جانب آخر على الأزهر في تكوين الرجال، مع استعارة العلماء من أوربا، كما أنشأ المدارس العليا وكانت موطنا للمختصين الوافدين من الغرب والمتعلمين من أبناء مصر، متمثلة في كلية الطب والصيدلة والهندسة والتمريض، ومن أهم مظاهر هذه اليقظة الاتجاه العام إلى معرفة علوم الغرب وحضارته، والانكباب على دراسة اللغات الحية، والشروع في نقل آثار الغرب إلى اللغتين العربية والتركية معا(0). أسس مدرسة الألسن، وانكب على دراسة اللغة الفرنسية ومنها الحضارة الغربية، فنقل بباريس عن أمهات الكتب الأدبية والفنية ما رآه نافعا، وترجم كتبا في مواضيع شتى، واهتم بالتاريخ وعلم الاجتماع والميثولوجيا وعلم السياسة والمنطق والهندسة، كما وضع كتبا في الأدب واللغة والتربية ومنها: المرشد الأمين في تربية البنات والبنين، وكتاب قواعد النحو وغيرها، كما اشترك في حركة الترجمة إلى جانب المستشرقين الذين انتدبوا للتدريس في المعاهد العلمية المصرية، وقد ازدهرت الترجمة في أواخر القرن 19م، حيث نقل منها إلى العربية آثارا قيمة في الطب والصيدلة وإسعاف المرضى والولادة وأصول العلوم الطبية والتشريح وكتب التشخيص وغيرها(0).
لقد شكلت هذه التراجم والأزهر الشريف وما استحدث من مدارس المعلمين قاعدة لانبعاث عربي بين حين وآخر، ومعينا على مكافحة الاستعمار والاستبداد، كما أن المطابع لا يقل دورها عن عامل الترجمة في الإيقاظ من الركود، مما دفع محمد علي باشا إلى دعم نهضته بالطباعة والنشر، فقام بشراء مطبعة من الفرنسيين، وكانت أول مطبعة عربية، حيث طبعت فيها أمهات الكتب من ذخائر العرب في مختلف العلوم. إلا أن دخول الانجليز إلى مصر 1882م شكل منعطفا خطيرا شغل المصريين عن الطباعة والنشر إلى المقاومة، في انتظار من يبعث روح الازدهار والعلم تارة أخرى(0).
-
رفاعة الطهطاوي (1801م- 1873م): عاش خلال فترة تميزت بالتخلف والتأخر كسمتان واضحتان للمجتمع العربي والإسلامي، درس في الأزهر ودرس فيه (1817م – 1824م)، ثم أرسل ضمن البعثة التي ذهبت إلى فرنسا في عهد محمد علي باشا(1826م- 1831م) لاكتساب العلوم الغربية للاستفادة منها في بناء معالم الدولة الحديثة، قام فيها بدور الشيخ في البعثة بتأييد من شيخه حسن العطار(1766م- 1835م)، الذي كان من شيوخ الازهر المستنيرين، وقد سعى خلال مدة إقامة هذه البعثة بفرنسا إلى الاستفادة من العلوم والمعارف الغربية حتى أصبح أهم شخصية فيها، هناك ألف بعضا من كتبه وترجم أخرى، وبعد عودته إلى بلده تولى عدة مناصب في الحكومة المصرية، فأقام المؤسسات التربوية والفكرية، ثم نفي في عهد الخديوي عباس الأول إلى السودان (1850م – 1854م)، اهتم بعدها بمسائل الفكر والاستفادة من المعارف والعلوم والتنظيمات الأوربية، فاهتم بالسياسة والقضاء والفقه واللغة والتاريخ والقانون والإدارة والتربية، وترك عدة مؤلفات منها: تخليص الإبريز في تاريخ باريز، ومناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب العصرية، ونهاية الإيجاز في سيرة ساكن الحجاز، والمرشد الأمين في تربية البنات والبنين في التربية وغيرها(0) .
-
خير الدين التونسي (1820م- 1890م): ظهر كنجم جديد في شمال افريقيا، يدعو إلى النهضة والعمران، وكانت نظرته نحو التحقيق الفعلي لنظرة الطهطاوي، فكان رجل فكر ودولة، خبيرا بأمور السياسة وجوانب تخلف الدولة العثمانية، وضمن أفكاره في كتابه أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك، بمثابة برنامج عمل لنهضة الأمة الإسلامية قاطبة وليس تونس فقط(0)، حيث تلقى الصدمة الأوربية اسوة بالطهطاوي بروح علمية مستنيرة، بهدف إرساء أسس النهضة في عموم الأمة، فدعا إلى الخروج عن عزلة القرون الوسطى، والتتلمذ على الحضارة الأوربية فيما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية وثوابتها، ولا يرى مانعا من الاختلاط بالأوربيين والتعلم منهم على حد قوله "لا يتهيأ لنا أن نميز ما يليق بنا إلا بمعرفة أحوال ما ليس من حزبنا...فالدنيا بصورة بلدة متحدة، أو بالتعبير الحديث قرية صغيرة تسكنها أمم متعددة حاجة بعضهم لبعض متأكدة"(0) ، كتب كتابه أقوم المسالك بعد اعتزاله السياسة على إثر خلافه مع الباي محمد الصادق(1859م- 1882م)، ضمنه خلاصة آرائه في التمدن والحضارة والعمران والإصلاح كما فعل بن خلدون مع مقدمته في عمر لا يتجاوز 45 سنة. أشرف بعد عودته إلى شؤون الحكم في تونس، حيث أصبح الحاكم الفعلي في البلاد (1873م) على مكتب العلوم الحربية لتعليم الجنود التونسيين علوم الهندسة والمساحة والحساب وغيرها، وعايش الحضارة الأوربية وتأثيراتها، خاصة عندما اشتغل سفيرا للباي لدى عديد من ممالك أوربا كفرنسا والسويد وبلجيكا والدنمارك(0)، كانت هذه التجارب كفيلة ببلورة فكره ومنهجه ورؤيته للتقدم والنهوض، لتحقيق قوة الدولة وتقدم الأمة في التمدن ورفعتها نحو آفاق النهضة، منطلقا في بناء الدولة الإسلامية الحديثة من إرساء مفهوم راسخ للعدل الذي افتتح به كتابه "سبحان من جعل من نتاج العدل العمران" والحرية كدعامة ثانية لذلك، معتبرا أن القوانين بقدر ما تفيد الرعاة فهي تقيد الرعية(0).
وخلاصة أفكاره قوله: " أوربا هي السيل المتدفق، والتيار المتتابع، الذي يوشك أن يغرق كل ما حوله، فكيف النجاة منها؟ لن يكون ذلك إلا بأن تحذو الممالك المجاورة حذوه وتجري مجراه في التنظيمات الدنيوية...أوربا قوية، وللوقوف في وجهها لا بد من اصطناع وسائل قوتها، وفي أصل هذه القوة وتلك الوسائل تقوم نظمها السياسية المؤسسة على دعامتي العدل والحرية(0).
-
جمال الدين الأفغاني (1839م- 1898م): ضم القرن 19م هذه الشخصية المبدعة الباعثة، فقد ملأ جمال الدين آذان الشرق الذي كان ميدانا لتزاحم الغرب على اقتسامه، وكان هذا التزاحم واضحا في ذهنه، فاتخذ من الإسلام مبدأ لدعوته، ومن القرآن الكريم والتراث الإسلامي معينا لمادته، وكان يرمي في هذه الدعوة إلى إيقاظ الشعوب الإسلامية والسمو بمستواها إلى مستوى الأمم الحرة، وكان يهيب بها أن تعود إلى أصول العقيدة وصفائها، والتخلص من شوائب البدع التي آلت بهم إلى هذا الفتور والضعف(0). سافر إلى الهند، فهرع إليه أكابر العلماء للاستفادة من علمه، فأمرته الحكومة بمغادرتها حالا، وهناك قال فيهم خطابا جاء فيه: "يا أهل الهند، لو كنتم وأنتم تعدون بمئات الملايين ذبابا لأصم طنينكم آذان بريطانيا العظمى، ولجعل في أذن كبيرها غلادستون وقرا"(0)، لقد نبه النفوس وأيقظها من سباتها ، فطردته الحكومة وتوجه إلى الاستانة مركز الخلافة الإسلامية، فاستقبله الصدر الأعظم وعينه على إدارة المعارف، إلا أنه اضطر إلى مغادرتها بعد معارضته لآراء شيخ الإسلام بن تيمية، موضحا أن الأمة هي مصدر القوة ومصدر الحكم، وإرادة الشعب الحر هي القانون المتبع للشعب، الذي يجب على كل حاكم أن يكون خادما وأمينا له. وعند رجوعه إلى مصر(1871م) استقبله رياض باشا وأكرمه ونعمه، وشرع يعلم ويرشد طلاب العلم، وعظم قدره حتى ملأت سمعته العالم، وكان لشخصيته وعبقريته أثرا كبيرا في تكوين الشخصيات وتنشيط العقول، رحل إلى لندن بعد ثورة عرابي ومنها إلى باريس(1883م)، هناك التقى بزميله وتلميذه محمد عبده، وأخرجا معا جريدة العروة الوثقى(1884م)، لسان حال جمعية العروة الوثقى التي تألفت من خيار القوم، فكادت الجريدة تفتح آفاقا جديدة في العالم الإسلامي والهند، لولا كيد المستعمرين الذين وقفوا لها بالمرصاد، فمنعت من دخول مصر والهند، فكتب بعد هذا المنع: "نلتمس من أبناء الأمم الشرقية أن يلقوا سلاح التنازع بينهم، ويأخذوا حذرهم وأسلحتهم لدفع الضواري التي فغرت أفواهها لالتهامهم، من رأينا الاشتغال بداخل البيت إنما يكون بعد الأمن من ظروف الناهب"(0).
ظل جمال الدين يبشر وينذر ويحض النفوس ويحرك الهمم، ويشير إلى مواطن الخطر، أينما حل حلت معه فكرة العرب والإسلام، إذا وقف في الهند أشار إلى مواطن الخطر التي تهدد مصر، وإذا ذهب إلى الإستانة ولى وجهه شطر المسجد الحرام، وإذا ذهب إلى لندن دافع عن السودان، وإذا كان في باريس كتب عن مصر وعن بلاد العرب والمسلمين، اتجه فكره نحو إيجاد أمة قوية تحفظ هذا التراث الذي فيه العزة والمنعة(0).
عاش حياة الأسفار والترحال في البلاد العربية والإسلامية وغيرها، والتقى عددا كبيرا من العلماء والفقهاء والسياسيين والشخصيات الهامة، مما أتاح لأفكاره الانتشار في كل أنحاء العالم الإسلامي، حتى اعتبر مفكرا ومصلحا ومثقفا إسلاميا بارعا، دعا إلى نهضة الشرق بالتصدي للاستعمار عن طريق اكتساب الحرية والاستقلال، وهو صاحب الدعوة إلى الجامعة الإسلامية، التي تعتمد على الإسلام في كليتها ووحدتها لمجابهة الاستعمار. رجع في آخر حياته إلى الاستانة بطلب من السلطان عبد الحميد لإبقائه تحت قبضته إلى أن توفي(1898م)، وقيل مات مسموما(0).
-
محمد عبده (1849م- 1905م): ترك جمال الدين مصر، وترك فيها الشيخ محمد عبده، طودا من العلم الراسخ، وعرمرما من الحكمة وعلو الهمم، لقد عمل هذا الهرم على بعث أمة وتكوين أجيال، وأخذ علمه من الأزهر ومن معاهد الدين الأخرى، وكان ثمرة من ثمار جمال الدين، الذي هيأه الله للنضال والإصلاح في الشرق العربي الذي تعاقبت عليه المصائب والشرور، جمع من علوم الأزهر ما وعى، وأخذ الفلسفة والمنطق والحكمة عن شيخه، حفظ القرآن الكريم وضبط علومه، برع في الأدب العربي وتمكن من أدوا ت الفصاحة والبيان(0). عاش جوا من المفاسد الاجتماعية والسياسية، وفوضى في الأمور الدينية، من وهن العقيدة وضعف الإيمان، حيث ساد الشرك وعادت عبادة الأصنام والأوثان وشتى صور الاشتغال بالرقى والنذور، والتعلق بالأرواح والأشباح، ورأى من الشوائب التي أصابت العقيدة وأضاعت الأخلاق.
لقد وعى أن هذا الصنف المنتشر والفساد الشامل يرجعان إلى جهل اناس بأصول دينهم وبالقرآن الكريم والحديث الشريف، ووجد أن التعليم الديني على أساس متين عصمة للأمة وركن ركين في إعادة مجدها، فلجأ إلى القرآن واتخذه عاصما، والحديث وجعله دليلا، ودعا إلى اتباع أثر السلف الصالح، لأن في هذا الاتباع رجوع إلى العقيدة الإسلامية من شوائب البدع في الأصول(0).
كان أفقه أوسع من أفق شيوخه بن عبد الوهاب وجمال الدين، لاطلاعه على الثقافة الغربية والإسلامية معا، فصدع بالحق، ينبذ الشرك ويحطم الأصنام، ورد على الوثنيين والمشبهة والمجسمة والمشركين في سورة الإخلاص من تفسيره لجزء عم ردا واضحا دامغا، وفي دروسه التي جمعها تلميذه محمد رشيد رضا في تفسيره الكبير.
لم يسعف الزمن محمد عبده أن يتم رسالته في نشر أفكاره الإصلاحية، فقد داهمته قوة الاستعمار، فأخذ يوجه الأنفس إلى منابت العزة والقوة وعقيدة التوحيد، ومقاومة المستعمر ودحض دسائسه، متخذا من جريدة العروة الوثقى ميدانا لعمله، شأنه في ذلك شأن شيخه جمال الدين، وخاض في بيان مقصود الشرع بالقضاء والقدر على خلاف ما يعتقده أصحاب الجبر، في خطوات حثيثة لتصحيح خطأ القوم في فهم العقيدة، وبعث أمجاد وذكريات السلف الأولين، الذين فتحوا العالم ونشروا الإخاء والعدالة. إن اتفاق محمد عبده مع شيخه على هذه المبادئ، شكل صيحة مدوية في الشرق العربي الذي أخذت مطامع الأقوياء تمتد إليه وأهله نيام في غفلة عن أعين الدهر اليقظ(0).
هو من أبرز النهضويين والمصلحين العرب والمسلمين، أثر تأثيرا كبيرا في الحياة المصرية في عصره والعصور التي تلتها، عبر تلاميذه محمد رشيد رضا وسعد زغلول وفتحي زغلول وقاسم أمين وطه حسين وغيرهم، اختلف أسلوبه عن أسلوب شيوخ الأزهر في قضية الإصلاح، فسهر على إصلاح بعض التنظيمات والمقررات في الجامع الأزهر، وسعى لإصلاح التحرير في اللغة العربية، من مؤلفاته الرد على هانوتو، الإسلام والنصرانية بين العلم والدين، رسالة إلى التوحيد وغيرها.
-
عبد الرحمن الكواكبي (1849م- 1902م): درج عبد الرحمن الكواكبي في مدينة حلب في بيت من دين وحسب، وهو من أشراف أهل المدينة، درس علوم الدين وتفقه وتعلم التفسير، وحفظ الحديث وبرع في اللغة العربية والفارسية والتركية، عاش صريح القول ثابت الجنان، لا يخشى في الله لومة لائم، أدخل السجن وحوكم وبرئ، ثم هجر مدينته إلى زنجبار فالحبشة ثم الجزيرة العربية وصولا إلى اليمن ثم مصر، كانت هذه الرحلات ميدانا لإحكام التجارب وتقوية الملاحظة، والاطلاع على أحوال المسلمين في الشرق وما هم عليه من انهيار من نواحي الحياة جميعها، فانكب يبحث ويدرس ويعلل ويستنتج ويحكم، مقتفيا أثر زميلاه محمد عبده وجمال الدين الأفغاني، متخذا من القرآن الكريم مصدرا لأفكاره، ومن العزة وحرية الرأي هدفا له، والرجوع إلى آثار الأولين والتخلص من البدع دعوته(0) .
لقد نشر الكواكبي آراءه وأفكاره في كتابه طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد، وكتابه أم القرى الذي أصدره دون أن يظهر عليه اسمه، وعاب على الناس خضوعهم إلى العثمانيين الأتراك باسم الخلافة، وخلودهم إلى السكينة والكسل حتى حل بهم الجهل والفقر والمرض والذلة، وانطلق الكواكبي في نشر مقالاته في مصر يشرح فيها الاستبداد والظلم، وجمعها في كتابه طبائع الاستبداد، ثم في كتابه الثاني أم القرى الذي عرض فيه آراءه الجريئة عن أحوال المسلمين عامة والخاضعين للدولة العثمانية خاصة، مبينا لأسباب فتورهم وانهيار قواهم، وأن الفتور الناشئ في المجتمع ناتج عن أسباب كثيرة ومشتركة، منها ما هو أصول ومنها ما هو فروع لها حكم الأصول، وكلها يرجعها إلى ثلاثة أنواع: أسباب دينية وأسباب سياسية وأسباب أخلاقية(0).
لقد أوضح الهوة بين الغرب والعرب والترك، وجعل النهضة الدينية هدفا وغاية، وظل يستنهض بني قومه، ويذكرهم بأمجادهم ومآثرهم، ويشرح خصائصهم وصفاتهم الكامنة فيهم، وأنها كافية لتعيد للأمة قوتها وترجع لها سلطانها، وأن الأمة العربية فيها من عناصر القوة ما يؤهلها أن تتزعم العالم الإسلامي مرة أخرى(0).
-
عبد الحميد بن باديس (1889م- 1940م): إمام المجاهدين الجزائريين وأبوهم الروحي، أفغاني الثورة الجزائرية المعاصر، نشر العلم بالتعليم ومحاربة الخرافة، كان عاصفة لا تهدأ وتصميما لا يقبل المساومة، لخص تجربة الأفغاني ومحمد عبده والكواكبي في الجهاد بالرغم من أنه لم يلتق بهم، وصاغ منهجا يلائم الشعب الجزائري في رفضه للسياسة الاستعمارية الباطشة، عمل منذ وصول الحملة المسلحة الفرنسية إلى ميناء سيدي فرج في 1830م على إنشاء تيار متصل بالنظام الجزائري، وهو الذي عاشت أسرته على رأس الحركة الوطنية منذ قرون مضت، تعود أصوله إلى المعز بن باديس الصنهاجي مؤسس الدولة الصنهاجية الأولى، تميز أجداده بالعلم وأسرته بالثراء أغنته عن الحاجة إلى وظائف الدولة الفرنسية. درس بالزيتونة 1908م ودرس فيه 1912م، وعمل على إنشاء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في (1913م)، لعبت دورا كبيرا في بث الروح الوطنية وأسباب النضال في وجه الاستعمار الفرنسي، وفي الحفاظ على التراث العربي والثقافي الإسلامي في الجزائر(0).
بدأ بن باديس في تفقد مخططه مستهدفا إعادة إيمان الجزائر بذاتيتها العربية المستقلة، خاصة بعد الهزيمة والتمزق أمام الحملة الفرنسية، واهتدى بفطرته وإخلاصه إلى السلاح الناجع لتحطيم أسطورة الجزائر الفرنسية، بمعارضته لمشروع ليون بلوم وفيوليت في 1936م، والقائم على فكرة دمج الجزائر بفرنسا نهائيا، والتي حاولت فرنسا أن تفرضها على الجزائر، فدعا إلى مؤتمر إسلامي عماده حركة جمعية العلماء المسلمين، معتمدا خطة أساسها محاصرة فرنسا في رفق وعزم صارم في الوقت الذي تظن نفسها أنها تحاصر الجزائر، فنجح في إحداث انقلابه القائم على إعداد جيل صالح ينهض نهضة إسلامية عربية، بحيث يأخذ عظمة الماضي ويقظة الحاضر ويسير في طريق المستقبل، فشرع في مهاجمة مظاهر التخلف والإساءة إلى الدين مبتدئا بالطرق الصوفية والطرقية وأصحابها، منبها إلى الخطر الذي تجده حركات التصوف الخادع من الوجهتين الدينية والاجتماعية(0).
اعتمد جريدة المعتمد كلسان حاله، ثم أسرع إلى إصدار جريدة الشهاب لفضح الطرق الصوفية وبيان مخالفاتها للدين بنوع من المرونة السياسية تجنبا لمضايقة السلطات الاستعمارية. ولم يتوان هذا القائد الإسلامي العظيم عن رفض المساومة، أو رفض الحلول الوسط، ولم يكن منهجه أوضح من أمل الشعب الجزائري في التحرير والاستقلال، فقد صاغ بعلمه الكبير أمل الشعب، وصدقت نبوءته عندما أشار إلى جبال الأوراس بقوله "إنهم سيهبطون من الجبل ذات يوم ليحرروا الجزائر"(0).
-
علال الفاسي (1910م- 1974م): هو الإسلامي السياسي الذي جعل من حركة الإسلام السياسي مشروعا للنهضة والحرية، استطاع إلى حد كبير نقل أفكاره من عالم الخيال والفكر والأحلام إلى عالم التصورات العملية والسياسية(0).
درس القرآن الكريم في الكتاب بفاس، ثم حصل على العالمية من القرويين، ودرس فيه وبالمدرسة الناصرية وكان أول مؤسسيها، اعتقل عند صدور الظهير البربري، وانتقل إلى اسبانيا ثم فرنسا ثم سويسرا هربا من اعتقال الإدارة الفرنسية للمرة الثانية، التقى بأهم المناضلين العرب في أوربا من أمثال شكيب أرسلان، ثم عاد إلى المغرب في 1934م، واشتغل مدرسا بجامعة القرويين بعد رفضه تولي وزارة العدل من طرف الفرنسيين، ثم منع من التدريس لما كثر طلابه، اعتقل من جديد ونفي إلى الغابون لمدة تسع سنوات، وعاد صيف 1946م إلى المغرب ليستأنف نشاطه في حزب الاستقلال، شرح قضية الشعب المغربي أمام مجلس الجامعة العربية عند تأسيسها(0).
لم يتوقف علال الفاسي عن البحث في قضايا الأمة العربية والإسلامية، فألف كتبا عديدة منها: النقد الذاتي، والحركات الاستقلالية في المغرب العربي، وحديث المغرب في المشرق، ودفاع عن الشريعة، وعقيدة وجهاد، ومقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها...الخ. والمتتبع لفكره يجده يتميز بنوع من المرونة والقدرة على التكيف مع العصر الحديث، دون أن يخرج عن روح الإسلام وقيمه الجوهرية، اعتقادا منه بأن الخروج من حالة الضعف التي تعيشها الأمة الإسلامية لا يمكن أن يتحقق إلا بقوة الروح وقوة المادة معا.
احتل التحليل السوسيولوجي مكانة هامة في فكره، والقارئ لكتابه النقد الذاتي يلحظ هذا الأمر بجلاء، فقد أوضح أن الغرض الأساسي لفكره هو توجيه الأنانية والفكر والشعور توجيها اجتماعيا انسانيا، باعتباره واحدا من أسباب النهضة والتقدم، واضعا صوب تفكيره المغرب كما باقي البلاد العربية والإسلامية(0).
لقد نبه علال الفاسي على ما أسماه الفكر العام المتحرك، والذي يستند إلى التأييد الشعبي، فلكي يكون الفكر سليما، ينبغي أن يكون أيضا مصحوبا بالعمل الجدي الهادف إلى تنوير الرأي العام وإصلاح ما فسد منه وتحريره من الجمود والخرافة والتقاليد الفاسدة، ومن شروط تحقيق هذا الفكر عنده توجيه الفرد والرأي العام ودفعهما إلى الأمام، إضافة إلى الاستجابة لحاجات الأمة ورغباتها، على أن تكون الفكرة شاملة ومراعية ما يصلح كل جوانب الحياة في البلاد ويساعدها على التقدم(0) .
-
-
آفاق استشرافية لنهضة عربية إسلامية معاصرة:
لقد تمكنت النهضة العربية والإسلامية من لعب دور مهم في الإحساس باللحظة التاريخية الزمانية، بالرغم من عدم تحقيقها لمطالبها الأساسية، فهي على الأقل ساهمت في إنتاج نخب من العلماء والمفكرين والمصلحين والمختصين، وكما لا يخفى على متتبعي أوضاع العالم العربي والإسلامي، فإنه على الرغم من وجود حركة نهضوية سابقة في تاريخ الأمم الإسلامية المعاصر، إلا أنها لم تنهض بعد، ومن هنا يحق لنا أن نضع السؤال الجوهري التالي: هل لا نزال في حركة نهضة؟ حيث يستمد هذا السؤال مشروعيته وأهميته، على اعتبار أن معظم المطالب التي نادى بها رواد النهضة العربية والإسلامية منذ أكثر من مئة وخمسين سنة لا تزال قائمة إلى يومنا هذا، هذا على الرغم من الاختلاف الحاصل لدى بعض المثقفين حول هذا الأمر، وهنا يذهب أحد المفكرين إلى أن "فكر النهضة في عالمنا لم يظهر بعد، وذلك لسبب بسيط، وهو أن النهضة كمقومات تاريخية واجتماعية لم تبدأ عندنا بعد، فشروط التقدم تاريخية وليست ايديولوجية، وهذا الاختلاف بين المستويين لم تدركه نخبنا في عالمنا العربي والإسلامي"(0). في حين يرى آخر غير ذلك، معتبرا أن ما حدث هو مجرد إرهاصات لنهضة لا نهضة متكاملة بقوله: "نسأل أنفسنا أولا: هل شهد الوطن العربي والإسلامي في العصر الحديث نهضة إنسانية على غرار النهضة الأوربية؟ والجواب هو أن الوطن العربي شهد إرهاصات لنهضة في نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، لكنها لم تتحول إلى نهضة جارفة تغلغلت في صميم الوجدان الثقافي العربي"(0). وبالتالي فإن السؤال الذي لا ينفك يتردد على أفواه جل المهتمين والمفكرين، والذي هو: كيف يكون النهوض والتقدم؟ وما سبله؟ وكيف ننهض ونتقدم ونحافظ على هويتنا في آن واحد؟(0) لا زال مطروحا، وهو الذي تتطلب ملامسته الانطلاق من الموروث الثقافي لبناء مشروع مستقبلي لإصلاح وتطوير العلوم الإسلامية، يكون كفيلا بالجواب عن تلك الأسئلة، بهدف الإسهام في تحقيق النهوض الكامل للحاق بالأمم المتقدمة، انطلاقا من خيار الوسطية والاعتدال، التي تفتح الباب مشرعا لكل تقدم علمي، دون التنكر لهويتنا وتراثنا العربي والإسلامي. فلأجل تجديد رؤية استشرافية لمعالم نهضة عربية إسلامية معاصرة، من المهم جدا الاشتغال على ترميم مختلف مرجعيات وأسس مشاريع الإصلاح السابقة، سواء تلك التي تبناها رواد إصلاحيون انطلاقا من أفكار تجديد الفكر الديني، أو التي قادها مجموعة من الساسة والقائمة أساسا على مبادئ الديمقراطية، أو تلك القائمة على مبادئ دعاة ومناصري التقنية، والتي تنظر إلى أوروبا كمهد للقوة المادية والتقنية المتطورة، وهو ما ركز عليه عبد الله العوري في كتابه "الايديولوجيا العربية المعاصرة"، وذهب إليه محمد عابد الجابري من خلال مشروعه الفكري الاصلاحي نقد العقل العربي، والذي يطرح أهم معالمه وأسسه في كتابه "نحن والتراث".
ان محاولتنا للجمع والتوليف بين أفكار المصلح الديني والمنظر السياسي والباحث في العلوم الحقة، وما آلت إليه أفكار ورؤى ومنظرين معاصرين بشأن إمكانية النهوض والاندماج في صحوة عربية اسلامية حقيقية، قادنا إلى ترتيب مجموعة من الأسس والمرتكزات، نعتقد أهميتها ونجاعتها في حدوث النهوض الحقيقي، وتحقيق آمال الأمة جمعاء، يتمحور الأساس الأول منها في نظرنا حول أهمية بل ضرورة إعادة النظر في الموروث العربي والإسلامي، بعين ناقدة فاحصة مدققة، متجردة من كافة الضغوطات الفكرية والسياسية والأيديولوجية، بمنهج جديد متطور، فيما تجمع باقي الأسس والمرتكزات بين استحضار أفكار مجموعة من الحداثيين وانتقاء ما يناسب منها لخصوصيات وطبيعة المجتمع العربي الإسلامي، وبين محاولة تبيئة مفاهيمها الحداثية مع التربية الإسلامية على حد تعبير عابد الجابري في كتابه "الخطاب العربي المعاصر"، ومحاوله قراءة ما أهملته مشاريع الإصلاح أو سكتت عنه أو تسترت عليه، سواء من داخلها أو من هيكلها العام.
كما تجدر الإشارة في هذا المقام إلى ضرورة الاهتمام بالمشاريع الإصلاحية النابعة من الوعي بالهوة الكبيرة والبون العظيم بين الشرق والغرب، القائم أساسا على الوعي بالذات وفهم الواقع المعاش بعيوبه وتناقضاته وإيجابياته كذلك، وهنا ينفي عابد الجابري عدم حدوث النهضة، بل يؤكد أن هناك غيابا لفهم واضح لواقع الحال ولمعالم النهوض وشروطه، وإلى أهمية التخلص من أمراض العقل العربي، المتشبت بعلامات التخلف والركود التي ورثها عن الماضي، وهو العقل الذي يحمل علامات العقل الذي أنتجه(0)، إلى فكه وتحريره من قيود هذا الأمر، من خلال الوقوف على حقيقة الذات وإدراكها والوعي بها، كخطوة أساسية تسبق أي اندماج في أي مشروع نهضوي، وهو ما يذهب فيه الجابري إلى القول بمعرفة الذات لفكها من قبضة النموذج السالف، إلى التعامل مع كل النماذج تعاملا نقديا(0) استشرافيا، دون تنكر للماضي ولمشاريعه التحررية وأسئلته النهضوية، ودون الوقوع في القراءة التراثية الاستنساخية للتراث فقط، والقائمة على الاجترار ومحاولة إعادة ما كان، إلى تدشين مرحلة جديدة، وبنظرة وأفق متطور، بما يحقق التنمية المجتمعية المستدامة.
قد لا ينكر مهتم أو ناقد أن قضية المنهج في التعاطي مع الرؤى الإصلاحية المبدعة تبقى إشكالا قائما منذ الماضي، وأن قدرتنا على التخلص من الآراء المسبقة والاستنتاجات القديمة لا زال أمرا صعبا، مما يسقطنا في معضلة القراءة الإسقاطية للتراث، والتعامل معه كحقيقة لا تحتمل النقاش، وهو ما طعن فيه محمد عابد الجابري بقوله: "إننا نرفض المنهج الإسقاطي، إسقاط المفاهيم التي استخلصت من تحليل واقع معين على معطيات واقع آخر لم يسبق تشريحه وتحليله"(0)، بما يتيح لنا إمكانيات تحرير الفكر النهضوي وتنقيته من العوائق، التي يعود أغلبها إلى سوء استخدام المنهج.
بالإضافة إلى ما سبق، فمن المهم جدا توحيد مسارات الاشتغال على المستويين العربي والإسلامي على عدة مستويات، تربوية وثقافية وفنية وسياسية واقتصادية وغيرها، تكون مفتاحا لتصور وبناء مشاريع إصلاحيه حداثية، تتخلص من ضبابية المشاريع السابقة، وتنفتح على آفاق حداثية متطورة، تجمع بين الرؤية العلمية الثاقبة والقابلية للتطبيق في بيئة عربية إسلامية، يمكن تلخيص أهم أسسها في التقاط التالية:
-
إرساء وتطوير مشاريع لإصلاح الجامعات الإسلامية، وتوحيدها في جامعة إسلامية موحدة.
-
تبادل الخبرات والتجارب في مجال البحث العلمي وتطوير مناهج التعليم.
-
توقيع الاتفاقيات والبروتوكولات في مجال التعليم والبحث العلمي لتدليل الصعوبات المرتبطة به.
-
اضطلاع الفن والفنانين بالأدوار الروحية الهامة في الجمع بين الشعوب وتوحيد كلمتهم.
-
التعاون والتكافل في المجالات الاقتصادية والطاقية والبيئية وغيرها.
ومهما يكن من أمر، وبالنظر إلى الحركة الفكرية والإصلاحية النهضوية القوية التي عرفتها الساحة العربية والإسلامية عند نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، فإنها تشكل المرحلة التاريخية الرئيسية للنهضة العربية والإسلامية، سواء من ناحية الإصلاحات التربوية التي عرفتها أهم الجامعات الإسلامية في حوض المتوسط (القرويين، الزيتونة، الأزهر)، أو من ناحية رواد الإصلاح النهضويين الذين شكلوا مدارس إصلاحية على صعيد هذه المنطقة.
الخاتمة:خلاصة القول، يمكن اعتبار الحركة النهضوية بدأت ولم تستطع تحقيق النهضة المأمولة بكل مكوناتها وأبعادها، وذلك لمجموعة من الأسباب، وعليه، فاستعمال عبارة فشل أو قصور أو إخفاق في الحركة النهضوية، والتي صادفناها في عدة كتابات في نظرنا تبقى مجانبة للصواب، يعني هذا أن البحث عن النهضة لا يزال قائما، وبالتالي فالأمة العربية والإسلامية لا زالت في نهضة، ولا أدل على ذلك أكثر من السعي إلى تحقيق أهداف رواد النهضة العربية والإسلامية التي طالبوا بها منذ حوالي قرنين من الزمن، وفي ذلك إلى تجديد رؤية وخطاب الفاعل السياسي والمصلح الديني والخبير في مجال التقنية والفاعل التربوي، من أجل التخلي عن الأنانية العرقية أو الطائفية أو القبلية إلى رؤية عربية إسلامية موحدة، تجعل من أطراف الوطن العربي والإسلامي وطنا واحدا موحدا، وإن اختلفت قياداته وشعوبه وخصوصياته، ويبقى المجال التعليمي الفضاء الخاص لزرع مثل هذه الأفكار والمرتكزات، في أفق بناء الصحوة المأمولة، وتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة المنشودة، التي لا تذر فقيرا إلا كفته، ولا محتاجا إلا وقضت حاجته، ولا تائها إلا أرشدته، ولا أميا إلا علمته، ولا خائفا إلا طمأنته، ولا سائلا إلا أعطته، ولا حاجه من حوائج الدنيا التي فيها خير للعروبة والإسلام إلا قضتها، حتى يصبح الناظر إلى أحوال الشرق والمتبصر بمصير الإسلام، وقد انفتح صدره وخيل الفرح على قلبه انشراحا، حين يرى أهل الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها ناهضين متقدمين في المعارف والآداب والفنون والعلوم، متوحدين مع بعضهم توحدا تلم شتات جامعتهم، ويعيدهم إلى العزة والجاه بعد الركود والانحطاط.
قائمة المصادر والمراجع: -
-
ابن منظور، 1990، لسان العرب، د.ط، بيروت، دار مصادر للطباعة والنشر ج7.
-
أحمد أمين، 2012، زعماء الإصلاح في العصر الحديث، د.ط، القاهرة، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة.
-
أرسلان شكيب، 2088، النهضة العربية في العصر الحديث، ط1، إشراف وتحرير د. سوسن النجار نصر، لبنان، الدار المتقدمة.
-
اسماعيل صبري عبد الله، 1992، نحو نهضة عربية ثانية، مجلة المستقبل العربي، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية عدد161.
-
أنطاكي بك عبد المسيح، 1946، النهضة الشرقية، د.ط، مصر، مطبعة الهلال بالفجالة.
-
الجابري محمد عابد، 1982، الخطاب العربي المعاصر، د.ط، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربي.
-
الجابري محمد عابد، 1996، المشروع النهضوي العربي مراجعة نقدية، ط1، بيروت، مركز دراسات الوحدة.
-
الجابري محمد عابد، د.ت، إشكاليات الفكر العربي المعاصر، د.ط.
-
جدعان فهمي، 1988، أسس التقدم عند مفكري الإسلام، ط3، بيروت، دار الشروق.
-
جماعة من المؤلفين، د.ت، دراسات تاريخية في عصر النهضة العربية الحديثة، د.ط، مصر، مكتبة الأنجلو المصرية.
-
حوراني ألبرت، د.ت، الفكر العربي في عصر النهضة (1978-1939)، د.ط، ترجمة كريم زعقول، بيروت، دار النهار للنشر.
-
د. برهانغلبون، 1992، اغتيال عقل، ط6، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر.
-
زكي أحمد صلاح، 2001، أعلام النهضة العربية الإسلامية في العصر الحديث، ط1، القاهرة، مركز الحضارة العربية.
-
السماوي أحمد، 1989، الاستبداد والحرية في فكر النهضة، ط2، اللاذقية، دار الحوار للنشر.
-
شرابي هشام، 1978، المثقفون العرب والغرب، ط2، بيروت، دار النهار للنشر.
-
شكري غالي، 1994، دكتاتورية التخلف العربي، د.ط، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب.
-
غصيب هشام، 1992، جدل الوعي العلمي، ط1، عمان، المؤسسة العربية للدراسات والنشر.
-
القرضاوي يوسف، 1988، الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي والإسلامي، ط1، بيروت، مؤسسة الرسالة.
-
كمال عبد اللطيف، 1992، مفاهيم ملتبسة في الفكر العربي المعاصر، ط1، بيروت، دار الطليعة.
-
المحافظة علي، 1987، الاتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضة 1798-1914، ط5، بيروت، الأهلية للنشر والتوزيع.
-
نويهض وليد، 1994، النخبة ضد الأهل، ط1، بيروت، دار بن حزم.
0) ابن منظور، لسان العرب، دار مصادر للطباعة والنشر بيروت، 1990، ج7، ص245.
0) اغتيال عقل، د. برهانغلبون، المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت، ط6، 1992، ص192.
0) مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية بيروت، عدد161، 1992، نحو نهضة عربية ثانية، اسماعيل صبري عبد الله، ص4.
0) هشام شرابي، المثقفون العرب والغرب، دار النهار للنشر بيروت، ط2،1978، ص8.
0) يوسف القرضاوي، الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي والإسلامي، مؤسسة الرسالة بيروت، ط1، 1988، ص 11 12 بتصرف.
0) المرجع نفسه، ص18.
0) جماعة من المؤلفين، دراسات تاريخية في عصر النهضة العربية الحديثة، مكتبة الأنجلو المصرية، بدون تاريخ ولا طبعة، رقم: 2157، ص5-6-7 بتصرف.
0) المرجع نفسه، ص11.
0- فهمي جدعان، أسس التقدم عند مفكري الإسلام، دار الشروق بيروت، ط3، 1988، ص13. ()
0) المرجع نفسه، ص13
0) هشام شرابي، المثقفون العرب والغرب، مرجع سابق، ص8.
0) أحمد السماوي، الاستبداد والحرية في فكر النهضة، دار الحوار اللاذقية، ط2، 1989، ص15.
0) غالي شكري، دكتاتورية التخلف العربي، الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة، 1994، ص130.
0) صلاح زكي أحمد، أعلام النهضة العربية الإسلامية في العصر الحديث، مرجع سابق، ص223.
0) المرجع نفسه، ص10.
0) ألبرت حوراني، الفكر العربي في عصر النهضة (1978-1939)، دار النهار للنشر بيروت، ترجمة كريم زعقول، د.ت.ط، ص5.
0) مجلة الواحة، السنة السادسة عشرة، العدد60، عام2010، ص 13.
0) أحمد أمين، زعماء الإصلاح في العصر الحديث، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، 2012، د.ط، ص6.
0) صلاح زكي أحمد، أعلام النهضة العربية الإسلامية في العصر الحديث، مرجع سابق، ص119.
0) كمال عبد اللطيف، مفاهيم ملتبسة في الفكر العربي المعاصر، دار الطليعة بيروت، ط1، 1992، ص18.
0) يوسف القرضاوي، الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي والإسلامي، مرجع سابق، ص26.
0) شكيب أرسلان، النهضة العربية في العصر الحديث، إشراف وتحرير د. سوسن النجار نصر، الدار المتقدمة لبنان، ط1، 2008، ص12.
0) علي المحافظة، الاتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضة 1798-1914، الأهلية للنشر والتوزيع بيروت، ط5، 1987، ص23-24.
0) كمال عبد اللطيف، مفاهيم ملتبسة في الفكر العربي المعاصر، دار الطليعة بيروت، ط1،1992، ص18.
0) جماعة من المؤلفين، دراسات تاريخية في عصر النهضة العربية الحديثة، ص67.
0) المرجع نفسه، ص80.
0) جماعة من المؤلفين، دراسات تاريخية في عصر النهضة العربية الحديثة، مرجع سابق، ص82.
0) عبد المسيح أنطاكي بك، النهضة الشرقية، مطبعة الهلال بالفجالة بمصر، مرجع سابق، ص20.
0) محمد عابد الجابري، المشروع النهضوي العربي مراجعة نقدية، مركز دراسات الوحدة بيروت، ط1، 1996، ص59.
0) جماعة من المؤلفين، دراسات تاريخية في عصر النهضة العربية الحديثة، مرجع سابق ص18.
0) المرجع نفسه، ص19.
0) المرجع نفسه، ص20.
0) المرجع نفسه، ص21.
0) المرجع نفسه، ص30.
0) المرجع نفسه، ص31.
0) جماعة من المؤلفين، دراسات تاريخية في عصر النهضة العربية الحديثة، مرجع سابق، ص32.
0) مجلة الواحة، العدد 60، 2010، ص 18
0) صلاح زكي أحمد، أعلام النهضة العربية الإسلامية في العصر الحديث، مرجع سابق، ص29.
0) المرجع نفسه، ص30.
0) صلاح زكي أحمد، أعلام النهضة العربية الإسلامية في العصر الحديث، مرجع سابق، ص31.
0) المرجع نفسه، ص35.
0) المرجع نفسه ص44.
0) جماعة من المؤلفين، تاريخية في عصر النهضة العربية الحديثة، مرجع سابق، ص47.
0) المرجع نفسه، ص49.
0) جماعة من المؤلفين، دراسات تاريخية في عصر النهضة العربية الحديثة، مرجع سابق، ص50.
0() المرجع نفسه، ص51.
0) مجلة الواحة، العدد 60، 2010، ص32
0- () جماعة من المؤلفين، دراسات تاريخية في عصر النهضة العربية الحديثة، مرجع سابق، ص51 .
0) المرجع نفسه، ص52.
0) جماعة من المؤلفين، دراسات تاريخية في عصر النهضة العربية الحديثة، مرجع سابق، ص54.
0) جماعة من المؤلفين، دراسات تاريخية في عصر النهضة العربية الحديثة، مرجع سابق، ص56.
0) المرجع نفسه، ص60.
0) جماعة من المؤلفين، دراسات تاريخية في عصر النهضة العربية الحديثة، مرجع سابق، ص65.
0) صلاح زكي أحمد، أعلام النهضة العربية الإسلامية في العصر الحديث، مرجع سابق، ص111.
0) المرجع نفسه، ص113-114 بتصرف.
0) المرجع نفسه، ص 116.
0) المرجع نفسه، ص213.
0) صلاح زكي أحمد، أعلام النهضة العربية الإسلامية في العصر الحديث، مرجع سابق، ص216.
0) المرجع نفسه، ص216.
0) المرجع نفسه، ص217.
0) وليد نويهض، النخبة ضد الأهل، دار بن حزم بيروت، ط1، 1994، ص52.
0) هشام غصيب، جدل الوعي العلمي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر عمان، ط1، 1992، ص108.
0() شكيب أرسلان، النهضة العربية في العصر الحديث، مرجع سابق، ص18.
0() محمد عابد الجابري، الخطاب العربي المعاصر، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 1982، ص 10.
0() المرجع نفسه، ص 57
0() عابد الجابري، إشكاليات الفكر العربي المعاصر، ص31.
| Article Title | Authors | Vol Info | Year |
| Article Title | Authors | Vol Info | Year |