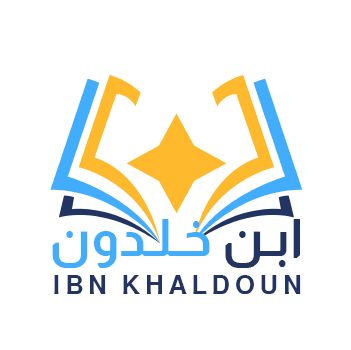2
6
2022
1682060055167_2359
https://drive.google.com/file/d/1eNwrjoNVJvyImBN_DhcSlmRc499t8SeF/view?usp=sharing
الكوتا النساية دستور جمهورية العراق الاحزاب السياسية المشاركة السياسية
The legal regulation of the women's quota according to the Constitution of the Republic of Iraq 2005: a comparative study
أ.م.د. روافد محمد علي الطيار: رئيس قسم الدراسات القانونية في مركز الدراسات الاستراتيجية، جامعة كربلاء، العراق
Abstract:
The study aims to show whether the women's quota has a real role in limiting the weakness of women's political participation in the Iraqi elections. In our research, we followed the method of comparative study between major constitutional models represented in the Iraqi constitution of 2005, the amended Egyptian constitution of 2014, and the French constitution of 1958, with a focus on the Iraqi experience in granting women an electoral presence. Basic to Iraqi law. The most important thing that has been reached is to make amendments to the election laws of Parliament and the governorates to include a text related to the women's quota, that a list of their own, similar to the quota of minorities, is presented by each political entity participating in the elections, in addition to its regular list of mixed women and men according to the order mentioned in the election law. And the amendment of Article 11 of the Parties Law No. (36) of 2015 specifying a quota of no less than one-third of women's representation in party leadership positions, to ensure women's political empowerment, build their leadership and political capabilities, and qualify them to enter political life at all stages.
Keywords: Women's quota, Constitution of the Republic of Iraq, political parties, political participation.
المقدمة:
يتفق معظم الباحثين في الدراسات السياسية على أن عملية مشاركة المرأة في الحياة السياسية أصبحت ضرورة ملحة لتحقيق أهداف النظام السياسي بحيث لا يقتصر حق الترشيح والانتخاب للمجالس النيابية والوظائف التنفيذية التي يتم شغلها بالانتخاب على الرجال فقط، وإنما يشمل حق الترشيح والانتخاب للرجال والنساء حتى يُعطى للمرأة حقا" متساويا" ومتعادلا" مع الرجل، وإن توسيع قاعدة التمثيل في الهيأة البرلمانية بحيث تشمل الشرائح الاجتماعية كافة بما فيها المرأة إنما يساعد على توسيع قاعدة الشرعية للمؤسسات السياسية داخل النظام السياسي ويزيد من قوة وعمق تمثيلها للمجتمع مما يجسد مفاهيم الانتماء الوطني والاعتزاز القومي وينمي قوى العطاء وفعالية الإنتاج لدى المواطنين وخاصة النساء، ويعزز مكانة المرأة في المجتمع وتطوير مهاراتها في تربية أجيال فاعلة وواعية للمجتمع، علاوة على تعزيز وتوظيف طاقات الأمة جميعها في سبيل تحقيق التنمية الشاملة في المجتمع.
مشكلة البحث:
ضعف مشاركة فئات معينة من المجتمع ومنها المرأة في العملية السياسية كانت ومازالت من المشاكل التي تعاني منها مختلف الدول، إضافة إلى ضعف المعالجة القانونية سواء على مستوى الوثيقة الدستورية أو الوثيقة التشريعية البرلمانية، وعليه نطرح الاسئلة التالية:
تتركز مشكلة البحث في سؤالين على النحو التالي:
-
السؤال الأول: هل تمكن المشرع الدستوري والتشريعي منح المرأة العراقية النسبة المتفق عليها دولياً - سيتم توضيحها في متن البحث - في السلطتين التشريعية والتنفيذية؟
-
السؤال الثاني: هل كان للكوتا النسائية الدور الحقيقي للحد من ضعف المشاركة السياسية للمرأة في الانتخابات العراقية السابقة؟
منهجية البحث:
أتبعنا في بحثنا منهج الدراسة المقارنة بين نماذج دستورية رئيسة تتمثل في الدستور العراقي لسنة 2005 والدستور المصري لسنة 2014 المعدل والدستور الفرنسي لسنة 1958 مع التركيز على التجربة العراقية في منح المرأة وجود انتخابي، وسبب أختيارنا النموذج المصري والفرنسي لقربها من القانون العراقي كونها تعد مصادر أساسية للقانون العراقي.
هيكل البحث:
لتوضيح هذا الموضوع آثرنا تقسيم موضوع البحث على ثلاثة مباحث، سنستهل الأول: لأعطاء فكرة ماهية الكوتا النسائية، وسنتناوله في ثلاثة مطالب الأول نخصصه لدراسة مفهوم نظام الكوتا النسائية في حين سنتطرق في المطلب الثاني منه لبيان مبررات نظام الكوتا النسائية في حين خصصنا المطلب الثالث لبيان أشكال أنظمة الكوتا.
أما المبحث الثاني فسنتناول فيه الموقف الفقهي والدولي من نظام الكوتا النسائية وسنبحثه في مطلبين: الأول سنكرسه لدراسة موقف الفقه من نظام الكوتا النسائية، والثاني موقف الدولي من نظام الكوتا النسائية. في حين نبحث في المبحث الثالث: التنظيم القانوني لنظام الكوتا النسائية وسنتناوله في مطلبين: الأول سنبين فيه التنظيم الدستوري لنظام الكوتا النسائية اما المطلب الثاني فسنتطرق فيه إلى التنظيم التشريعي لنظام الكوتا النسائية. وننهي موضوعنا هذا بخاتمة متناولين فيها ابرز ما توصلنا اليه من نتائج وتوصيات.
المبحث الأول: ماهية الكوتا النسائيةلا يعد نظام الكوتا (المقاعد المحجوزة) نظاماً حديثاً نسبياً، فقد عٌرف منذ القرن الماضي بمنح مقاعد معينة لفئات مستضعفة في بعض الدول، سواء أكانت للنساء أم للأقليات الإثنية أو غيرها، وللإلمام بماهية هذا النظام سيتم بحثه من حيث المفهوم والمبررات وأشكال الكوتا النسائية:
-
المطلب الأول: مفهوم نظام الكوتا النسائية
-
المطلب الثاني: مبررات نظام الكوتا النسائية.
-
المطلب الثالث: أشكال أنظمة الكوتا.
المطلب الأول: مفهوم نظام الكوتا النسائية
يقصد بنظام الكوتا النسائية تخصيص عدد من مقاعد المجالس التمثيلية الوطنية والإقليمية والمحلية للنساء، أي أن تكون للنساء حصة في عضوية السلطة التشريعية على سبيل الوجوب والإلزام بحيث لا تكتسب هذه المجالس النيابية الصفة الدستورية والمشروعية ما لم يكن بين أعضائها عدد من النساء(0)
ويرجع الأصل التاريخي لنظام الكوتا إلى مصطلح الإجراء الإيجابي AFFIRMATIVE ACTS حيث أطلق لأول مرة في الولايات المتحدة على سياسة تعويض الجماعات أما من قبل السلطات الحكومية أو من قبل أصحاب العمل في القطاع الخاص وقد كان في الأصل ناجما" عن حركة الحقوق المدنية ويتصل بالأقلية السوداء وقد أطلقه لأول مرة الرئيس (كنيدي سنة 1961) وتابعه جونسون في برنامجه الذي كان يمثل جزء من الحرب على الفقر في بداية عام 1965، فتم تطبيق نظام حصص نسبية (الكوتا) يلزم الجهات تخصيص نسبة معينة من الطلاب المقبولين فيها الذين ينتمون إلى أقليات أثنية، فطالبت به جماعات أخرى مثل الحركة النسائية، كما أنتشر في بلدان أخرى كانت تشعر فيها الأقليات بأنها محرومة من الحقوق(0).
تتألف عملية المشاركة الانتخابية من مرحلتين أساسيتين هما مرحلة الترشيح ومرحلة التصويت، إن لمنح المرأة حق الترشيح إيجابيات متعددة تتمحور أهمها في أن للمرأة مصالح يجب أن تدافع عنها بنفسها ويقع على عاتقها واجبات ورسالة يجب أداؤها للمجتمع وبما أننا نعيش في دول العالم الثالث ونتيجة الخضوع للأعراف القبلية فقد كان له أثره في تحجيم مشاركة المرأة في صنع القرار ولذلك كان لابد من استخدام وسائل بديلة تحقق للمرأة نوعا من المساواة الفعلية وتتمثل هذه الوسائل في تحديد مقاعد للمرأة في البرلمان "التمييز الإيجابي" (0).
المطلب الثاني: مبررات نظام الكوتا النسائية
هناك عدة مبررات مساندة لتطبيق نظام الكوتا النسائية في المجالس المنتخبة وهي:
-
أولا: العدالة، فعدد النساء في أي مجتمع يقترب من النصف إن لم يكن يزيد في بعض الحالات، ولذلك فإنه ليس من العدالة في شيء أن يحرم ما يقارب نصف المجتمع من التمثيل في المجالس النيابية على كافة مستوياتها.
-
ثانيا: تمثيل المصالح، الذي ينطلق من تصور النظام السياسي باعتباره ينقسم إلى جماعات ذات مصالح متباينة، وأن دور الهيئات النيابية هو إفساح المجال للتعبير عن هذه المصالح، وإيجاد السبل الخاصة للتوفيق بين هذه المصالح.
-
ثالثا: إن تخصيص مقاعد للنساء في المجالس النيابية يعطي نموذجا" للمشاركة السياسية جدير بالإقتداء يكمن بدوره في زيادة المشاركة السياسية للنساء(0).
-
رابعا: يعكس تمكين المرأة من الوصول إلى مواقع صنع القرار صورة إيجابية عن التجربة الديمقراطية في الدول الانتقالية ولا سيما دول العالم الثالث حيث تتهم مجتمعاتها بأنها محافظة ومتزمتة ولا تحظى فيها المرأة بدرجة متساوية مع الرجل(0).
-
خامسا: إحداث تغيير تدريجي في نظرة المجتمعات المحافظة لدور المرأة في الحياة العامة من خلال التمثيل البرلماني النسائي، حيث إن مشاركة المرأة في البرلمانات والمجالس المحلية سوف تتيح لها التعرض مباشرة للجمهور والرأي العام وهذا سيخلق حالة من الاعتياد والتقبل لتلك المشاركة وان كانت متواضعة.
-
سادسا: وإذا ما تحققت تلك المشاركة النسائية البرلمانية، فإنها ستزيد من مستوى التحفز لدى المرأة والاهتمام بالعمل العام والإقبال عليه والعمل على تهيئة نفسها وإعدادها جيدا لمزاولة هذا العمل الذي يتطلب من المرأة أن تعد نفسها إلى وظائفه وعدم الركون إلى دور الرجل، زوجا" كان أم أخا أم أب أبن، لينوب عنها في العمل السياسي(0).
يرى مؤيدي هذا الاتجاه أهمية الاخذ بنظام حجز المقاعد (الكوتا) للنساء، لأهمية ذلك من حيث تشجيع المرأة على التواجد في مواقع صنع القرار من جانب، وتقبل الرجل لها من جانب اخر، فهي تتمتع بصالح وحقوق وهي أجدر من غيرها للمطالبة بها والدفاع عنها.
وفي دراسة قيمة أعدها الاتحاد البرلماني الدولي وجد تطور بطيء لمشاركة المرأة حيث بلغت نسبة المشاركة في البرلمانات عام 1995 (11,3 %)، وقد تصاعدت إلى (16%) عام 2005م(0).
وبالرغم من ذلك ما تزال النساء يعانين من التفرقة والتمييز في غالبية المجتمعات للعديد من الأسباب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، ومن هنا كانت التوصية بتبني مفهوم التمييز الايجابي والذي مؤداه أن تعطى النساء نوعا من المساعدة المؤسسية – ضمن غيرها من المساعدات – للتعويض عن التمييز الفعلي الذي يعانين منه، على أن يكون ذلك بصورة مؤقتة حتى يتم تحقيق التوازن العادل بينهن وبين الرجال(0).
وقد طبق نظام الكوتا النسائية في العراق سنة 2005، علما إنه شهد عام 1980 أول مشاركة سياسية للمرأة في العراق حيث تمكنت من خلالها الترشيح والانتخاب للحصول على عدد من مقاعد البرلمان لكنها كانت مشاركة ضمن أطار ( فلسفة الحزب الواحد) حزب البعث المنحل، وقد دخلت البرلمان في العام نفسه إذ فازت (16) امرأة بعضوية المجلس الوطني في عام 1984 وفازت ( 33) امرأة بعضوية المجلس الوطني بذلك سجلت أعلى نسبة للمرأة العراقية قياساُ لنسبة النساء في الوطن العربي منذ وصول النساء للبرلمان، وبعد عام 2003 ازدادت مشاركة المرأة في المجالات السياسية لدى الكثير من الدول العربية خاصة بعد المشاركة النسوية العراقية بنسبة 25 % داخل البرلمان العراقي ونيلها ستة مقاعد وزارية في حين لم تتجاوز نسبة المشاركة المرأة الفرنسية داخل البرلمان الفرنسي سوى %12 والبريطانية داخل مجلس العموم 19 % بعد أن ابتدأت مشاركتها عام 1948 نسبة%1 بينما تحتل المشاركة في كل من مصر والأردن ودول الخليج لن تتعدى مشاركتها أكثر من 3% ولازالت تعاني في بعض البلدان الإقليمية شحة تواجد المرأة في مواقع صنع القرار(0).
وفي مصر سنة 1979 وهي أول بلد عربي يُستخدم فيه نظام الكوتا، وذلك في عهد الرئيس عبد الناصر وبموجب نص دستوري (بعد تعديل عام 1964)، ثم تبنى التشريع المصري نظام الكوتا النسائية
بالقانون رقم 21 لسنة 1979م والذي أوجب تمثيل المرأة في البرلمان بحصة لا تقل عن 30 مقعدا، بواقع مقعد لكل محافظة على الأقل، وقد شهد البرلمان المصري عام 1979م عددا كبيرا في تمثيل المرأة، فقد حصلت النساء على (35) مقعدا تم زيادتها إلى (36) مقعدا عام 1984م.
إلا أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية القانون رقم 21 لسنة 1979م مما ترتب عليه إلغاء نظام الكوتا النسائية في مصر، رغم أن مصر تأخذ بنظام الكوتا العمالية بأن تحدد حصة لا تقل عن 50% للعمال والفلاحين، وقد تراجع تمثيل المرأة في البرلمان المصري بشكل ملحوظ بعد إلغاء نظام الكوتا النسائية، حتى تم العودة لذلك النظام بمقتضي القانون رقم 149 لسنة 2009م بتخصيص دوائر انتخابية يتنافس عليها النساء فقط، وذلك بصفة مؤقتة لمدة فصلين تشريعيين وبحيث تنتخب من هذه الدوائر (64) امرأة.
وعلى الرغم من أن ثورة 25 يناير2011م قد شهدت مشاركة فاعلة للمرأة المصرية إلا أن التشريعات اللاحقة على الثورة قد ألغت نظام الكوتا النسائية، ونتج عن ذلك تمثيل متدني للنساء في آخر انتخابات برلمانية شهدتها مصر مؤخرًا حيث فازت (9) سيدات فقط، ويمثلن نسبة لا تزيد عن 7و1% من مقاعد البرلمان.
ومن الدول التي أخذت نظام تخصيص الحصص (الكوتا) للنساء الأردن وفق النظام المعدل لنظام تقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لسنة 2003 وذلك بتخصيص ستة مقاعد تخصص لأشغالها من قبل المرشحات الفائزات في المملكة وفقا" لأحكام الفقرة ج من المادة 45 من قانون انتخابات مجلس النواب رقم 43 لسنة 2001 (0).
وفي المغرب خصص للنساء في انتخابات 27 سبتمبر 2002 نسبة تصل إلى 10% من مقاعد البرلمان(0).
المطلب الثالث: أشكال أنظمة الكوتا
هناك العديد من أنظمة تخصيص نسبة للمرأة في التمثيل السياسي، وعلى وجه العموم هناك أربعة أنظمة رئيسة للكوتا وهي الكوتا الدستورية والكوتا القانونية للبرلمان والكوتا القانونية للمجالس المحلية والكوتا الحزبية:
-
الكوتا الدستورية
وهي نظام تخصص فيه المقاعد للمرأة في البرلمان بنص الدستور ويأتي العراق وفرنسا والأرجنتين ورواندا ضمن 14 دولة تأخذ بهذا النظام، وبه حققت رواندا أعلى نسبة تمثيل للمرأة في البرلمان في العالم (48.5%)(0).
-
الكوتا القانونية
هي نظام تخصص فيه مقاعد للمرأة في البرلمان بنص في قانون الانتخابات، والدول الأربعة عشر التي تأخذ بنظام الكوتا الدستورية تقع ضمن 32 دولة صدرت فيها قوانين تنص على تخصيص نسبة من المقاعد في البرلمان للمرأة ومنها العراق وفرنسا.
-
الكوتا القانونية في المجالس المحلية:
هذا النوع من الكوتا ينص عليه في الدستور أو بالقانون، وهو مطبق في فرنسا حيث خصص نسبة النصف (50%) للنساء في قوائم الأحزاب إذا كان عدد المقاعد ستة مقاعد أو أكثر، حيث تجري الانتخابات المحلية بنظام القوائم، وهذا ما أشار إليه قانون تعزيز المساواة في الوصول للمرأة والرجل إلى الولايات الانتخابية والوظائف الانتخابية الصادر عام 2000 في المادة 4 والتي تشير إلى " كل قوائم تشمل 50 ٪ للمرشحين لكل من الجنسين". والمادة 5 التي تشير إلى " قائمة كل يوم، فإن الفجوة بين عدد المرشحين من كل جنس قد لا تتجاوز واح داخل كل مجموعة كاملة من ستة مرشحين من أجل عرض من قائمة وينبغي أن تشمل على عدد متساو للمرشحين لكل من الجنسين".
-
نظام الحصة الحزبية:
وفق هذا النظام تلتزم الأحزاب بترشيح نسبة معينة في قوائمها من النساء وهو التزام اختياري دون تشريع في بعض الدول كإيطاليا والنرويج وإجباري في الدول التي تجري فيها الانتخابات بنظام القوائم كألمانيا والسويد، ومن الدول العربية التي أخذت بهذا النظام العراق بالنسبة للقوائم الانتخابية والمغرب والجزائر وتونس(0)، وكذلك فلسطين حيث نص قانون الانتخاب في عام 2005 على أنه: ( يجب أن تتضمن كل قائمة من القوائم الانتخابية المرشحة للانتخابات حداً أدنى لتمثيل المرأة لا يقل عن امرأة واحدة من بين كل من: 1. الأسماء الثلاثة الأولى في القائمة، 2. الأربعة أسماء التي تلي ذلك، 3. كل خمسة أسماء تلي ذلك)..! (0)
وفي فرنسا تجري انتخابات الجمعية الوطنية بالنظام الفردي، لذا لا يلزم القانون الأحزاب بتخصيص نسبة للنساء ولكنه يوقع عقوبة مالية على الحزب الذي لا تمثل النساء فيه نصف عدد مرشحيه في الانتخابات العامة التي تجري بالنظام الفردي(0).
المبحث الثاني: الموقف الفقهي والدولي من نظام الكوتا النسائية
يتم في هذا المبحث بيان الكوتا النسائية من مطلبين:
المطلب الأول: موقف الفقه الدستوري من نظام الكوتا النسائية
انقسم الفقه الدستوري بصدد نظام الكوتا النسائية إلى اتجاهين الأول يعارض هذا النظام والثاني يؤيده ولكل فريق حججه وأسانيده التي تدعم وجهة النظر التي تبناها:
الاتجاه الأول: وهو الاتجاه الأكثر تأييدا ويرى أنصاره أن نظام الكوتا النسائية غير مقبول وذلك لأنه يخل بمبدأ المساواة الذي أقرته الدساتير(0).
فإذا كان دستور 2005 في العراق قد آمن بمبدأ أن لا تقدم للمجتمع العراقي بدون المرأة العراقية واعتنق فكرة تكريم المرأة، حيث تظهر حالات إعلاء شأن المرأة في عدد كثير من النصوص منها ما ورد في ديباجة الدستور حيث نصت على " نحن شعب العراق... عقدنا العزم برجالنا ونسائنا... على احترام قواعد القانون وتحقيق العدل والمساواة... والاهتمام بالمرأة وحقوقها " إضافة إلى مبدأ المساواة المقرر في المادة 14 " العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية..."
إلا أن الدستور قد خالف مبدأ المساواة عندما منح في المادة 49 حصة للنساء (كوتا) بحيث لا يكون مجلس النواب دستوريا" ومؤهلا" للقيام بواجباته ما لم يتضمن نسبة 25% من عدد أعضائه من النساء على الأقل(0).
هذا ما أكده القضاء العراقي فقد أكدت المحكمة الاتحادية العليا في قرارها رقم 36/اتحادية/ 2013 في 26/8/2013 أن كوتا النساء الواردة في الدستور جاءت استثناءً من مبدأ المساواة بين العراقيين منوهة بعدم إمكانية التوسع فيه (0).
وكذلك في مصر يعتبر هذا النظام مخالفا" للمادة 11 من الدستور المصري لسنة 2014 والتي تنص على أن " تكفل الدولة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق السياسية والمدنية..."
ويرى الفقه المصري أن موقف المشرع كان معيبا" ولم يكن القصد منه سوى إضعاف البرلمان وجعله يتحمل وهنا" على وهن، يرى الفقه أنه لا اعتراض على المرأة إذا دخلت البرلمان بنسبة الثلثين من خلال انتخابات نزيهة وحرة وباختيار الشعب الذي رأى فيها قدرة تمثيله، والتعبير عن آرائه(0).
ومن جهة أخرى يرى معارضو الكوتا أن المشرع الدستوري إذا كان قد ضمن للمرأة نسبة تمثيل في المجالس النيابية فإنه لم يضمن الالتزام بمعايير الكفاية والخبرة والإخلاص للوطن والقدرة على خدمة البلاد عند اختيار أي مرشحة للبرلمان، وبالتالي فإن فرض هذه النسبة قد يؤدي إلى تراجع تدريجي في مستوى تقبل المجتمع لمشاركة المرأة في العمل السياسي(0).
أما الاتجاه الثاني(0) فيرى أن اعتماد هذا النظام لمرحلة مؤقتة أقصاها خمسة عشر عاما" في الدول والمجتمعات التي ما تزال تتصف بأنها في مرحلة التحول والانتقال إلى الحداثة كدول العالم الثالث له أهميته في الإسراع بتحسين أوضاع المرأة سياسيا" وإبراز وجودها في مواقع صنع القرار(0).
وإن نظام الكوتا النسائية يساهم في تعزيز وتفعيل دور المرأة في المجتمع بشكل عام وفي الحياة النيابية بشكل خاص من خلال إعداد كوادر نسائية متمكنة في مجال عمل البرلمان، لأن مجتمعات دول العالم الثالث مازالت تعاني من قصور في جانب الكوادر النسائية ولا سيما في المجالس النيابية(0). ونحن نرى إن كلا الرأيين صائب وإننا بإمكاننا الدمج ما بين الرأيين وذلك عن طريق الأخذ بنظام الكوتا بشكل أولي من أجل دمج المرأة بالعمل السياسي، مما يترتب عليه قبول المجتمع لوجود المرأة في العمل السياسي وكذلك تطوير مهاراتها العملية والسياسية في هذا الجانب، وذلك لفترة زمنية محددة ومن ثم يتم إلغاء نظام الكوتا، ويتم العمل على إختيار المرأة المناسبة والكفوءة وليس على أساس الكوتا.
وقد أيد المجتمع الدولي ذلك فقد دعت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإلى اعتماد مبدأ التمييز الإيجابي (الكوتا) لصالح المرأة وذلك على اعتبار أن التمييز الايجابي لصالح الفئات الأقل حظا" لا يعد تمييزا" مجحفا" بحق الفئات الأخرى بقدر ما يساعد على الوصول إلى تحقيق المساواة والعدالة في المجتمع.
ولقد دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة في قراره رقم 15 لسنة 1990 إلى مشاركة المرأة في هياكل السلطة ومواقع صنع القرار بنسبة 30%والعمل على تعبئة المجتمع رجالا" ونساء" وتوعيته للقيام بتغيير المواقف السلبية المتميزة ضد المرأة ودورها في صنع القرار وتبني آليات وإجراءات تمكنها من ذلك(0).
وقد أكد تقرير البعثة الدولية للانتخابات العراقية لمجلس النواب العراقي في 15 كانون الأول 2005 تأييده لهذا النظام قائلا" " أن هذا التشريع يعد من بين التشريعات الأكثر تقدما" في العالم حيث أدى إلى حصول النساء على 25%من مقاعد مجلس النواب " (0).
ومن الناحية العملية أدى تطبيق نظام الكوتا في الدول إلى رفع نسبة النساء في البرلمانات، ففي المغرب ارتفعت النسبة من 1% عام 1995 إلى 11% عام 2003 بحيث أصبحت هناك 35 سيدة في البرلمان، وفي الأردن تضاعفت النسبة إلى 2.5% للمدة ذاتها، وفي تونس ارتفعت النسبة من 6.8% إلى 11.5% (0).
المطلب الثاني: الموقف الدولي من نظام الكوتا النسائية
نتيجة لظهور الحركات النسوية والتقدمية على صعيد العالم والتي تهدف إلى زيادة التمثيل النسائي مما أدى إلى تدخل الأمم المتحدة للمشاركة في قضية المرأة، فعقدت عدة مؤتمرات تتعلق بحقوق المرأة الانتخابية ومن أهم هذه المؤتمرات:
-
الفرع الأول: مؤتمر مكسيكو 1975
-
الفرع الثاني: مؤتمر نيروبي 1985
-
الفرع الثالث: مؤتمر بكين 1995
الفرع الأول: مؤتمر مكسيكو 1975
أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 1972 عن العام الدولي للمرأة والذي تكرس في عام 1975 وهو تعبير عن إجماع الإرادات البشرية الواعية على ضرورة التعجيل بتوفير الضمانات المادية والحقوقية والمعنوية المتكاملة لتحرر المرأة(0).
وغاية المؤتمر تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في السلم والتنمية وفي الأسرة والمجتمع وفي فرص التعليم وفي الأجور وحق المرأة في أن تقرر بحرية الزواج من عدمه وفي احترام جميع الحقوق الإنسانية لها(0).
الفرع الثاني: مؤتمر نيروبي 1985
جاء في تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم (نيروبي 15-26 تموز 1985) أن المساواة هي في الوقت نفسه هدف ووسيلة يمنح بموجبها الأفراد مساواة في المعاملة في ظل القانون ومساواة في الفرص، وبالنسبة للمرأة بصفة خاصة، تعني المساواة إعمال الحقوق التي حرمت منها نتيجة للتمييز الثقافي أو السلوكي أو التمييز في المواقف. ولقد درس مؤتمر نيروبي العديد من المعوقات التي تعترض تحقيق هدف دولي رئيس هو: الاحترام التام للمساواة في حقوق المرأة والقضاء على التمييز بسبب الجنس سواء بحكم القانون أو بحكم الواقع.
وتوصل المؤتمر إلى أن المرأة تعاني بسبب جنسها، تمييزا من حيث حرمانها من فرص الوصول المتساوية إلى بنية السلطة التي تحكم المجتمع وتبت في مسائل التنمية ومبادرات السلم، وثمة فوارق إضافية، مثل العنصر واللون والانتماء إلى جماعة عرقية، قد يكون لها آثار اخطر في بعض البلدان، نظرا لإمكانية استخدام مثل هذه العوامل لتبرير التمييز المركب(0).
وتزامنا مع مؤتمر نيروبي، عقد في ذات العام مؤتمر المنظمات غير الحكومية في بكين شاركت فيه (30000) امرأة، ولقد سميت الفترة ما بين عامي (1976 – 1985) بعقد المرأة، حيث أصبحت قضية المرأة تحتل مكانا بارزا في جدول أعمال الأمم المتحدة وركزت على إيجاد نظام اقتصادي وسياسي يحقق مشاركة أكبر للمرأة في العملية السياسية والمشاركة في عملية التنمية العالمية.
ولكن مع هذه الطفرة في تزايد مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية والمدنية ما زالت النساء يمثلن نسبة ضئيلة في المراتب العليا والمناصب القيادية والتي تساعد في عملية سن القوانين والتشريعات في صالح المرأة ومساواتها في المجتمع، يبلغ عدد النساء في برلمانات الدول ما بين عام 1975 إلى عام 1995 بالنسبة من (4.7%) إلى حوالي (11%) ومع تطور وتقدم الحركات النسائية انخفض عدد الأقطار التي لم تتقلد المرأة فيها أي منصب قيادي من (93) دولة إلى (47) دولة (0).
الفرع الثالث: مؤتمر بكين 1995
عقدت الأمم المتحدة أكبر مؤتمر في عام 1995، فقد تناولت تقارير رسمية عن وضع المرأة والضغط على الحكومات بمعالجة المعوقات أمام مشاركة ووصول المرأة إلى المواقع السياسية.
ويؤكد منهاج عمل بكين لعام 1995 (المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة) أن للمرأة حقا متساويا في المشاركة في إدارة دفة الأمور العامة وفي الإسهام من خلال تلك المشاركة في إعادة تجديد الأوليات السياسية وإدراج بنود جديدة في جداول الأعمال السياسية وأتاحت منظورات جديدة بشأن القضايا السياسية العامة(0).
وقد حدد منهاج العمل في بكين هدفين استراتيجيين في هذا المجال هما: اتخاذ التدابير الكفيلة بوصول المرأة على قدم المساواة إلى هياكل السلطة وعمليات صنع القرار والمشاركة الكاملة فيها وزيادة قدرة المرأة على المشاركة في صنع القرار والقيادة.
ويوصي أيضا باتخاذ تدابير هذين الهدفين وهي: القيام بعمل التصحيح في مجال السياسة العامة واشتراك المرأة في المواقع الانتخابية والأحزاب السياسية وتعزيز حماية حقوق المرأة السياسية وتنظيم التدريب على القيادة والاعتداد بالنفس وضمان التمثيل المتوازن بين الجنسين في هيئات اختيار المرشحين.
وللإسراع بتنفيذ الإجراءات المتخذة المتعلقة بالمرأة في مواقع السلطة وصنع القرار، فقد شددت لجنة مركز المرأة في دورتها الواحد والأربعين عام 1997 على إن بلوغ هدف المشاركة على قدم المساواة بين الرجل والمرأة في صنع القرار سيحقق التوازن المطلوب لتعزيز الديمقراطية.
كما شددت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في دورتها السادسة عشرة سنة 1997 على أهمية تمثيل المرأة على قدم المساواة في صنع القرارات على الصعيدين الوطني والدولي وانه ينبغي على الدول أن تكفل امتثال دساتيرها وتشريعاتها لمبادئ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(0).
وقد دعا منهاج عمل بكين إلى تفعيل نظام الكوتا في مراكز صنع القرار والوظائف العامة ووصول النسبة إلى (30%) تمهيدا إلى وصول النسبة إلى (50%) بدلا من المعدلات الحالية وقد اعتمدت بعض الدول نظام الكوتا في هيئات صنع القرار ومن بينها الهيئات الحكومية والبرلمانات الوطنية والأحزاب السياسية(0).
إلا إن المؤتمر لم يسجل تقدما فيما يتعلق بالتعهدات الدولية التي التزمت بها الدول في ميدان حماية حقوق النساء، فأن أي تقدم لم يحرز لتطبيق جميع التدابير المقترحة، والواقع إن برنامج عمل وإعلان بكين لا يحملان أي طابع ملزم قانونا، وقد وصفتها الولايات المتحدة بأنها توصيات وجهت للدول(0)
ورغم أن هناك خطوات ملموسة قد اتخذت في العراق من اجل تحقيق الأهداف التي حددتها المجالات الحاسمة لمؤتمر بكين ولعل في مقدمتها وضع إستراتيجية وطنية للنهوض بالمرأة العراقية، وتشكلت في عام 1997 اللجنة الوطنية للنهوض بالمرأة العراقية مقرها وزارة العدل والشؤون الاجتماعية، ورئيسها الوزير، وتضم في عضويتها إلى جانب الاتحاد العام لنساء العراق ممثلين من عدد من الوزارات المعنية كالصحة والتعليم العالي والعدل وغيرها، وقد سعت اللجنة الوطنية إلى تحقيق عدد من الأهداف المهمة ومنها:
-
تقرير مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات وإشغال المناصب الإدارية.
-
مشاركة المرأة في إصدار التشريعات والقوانين الخاصة بالمرأة، فضلا عن بدء نشر ثقافة النوع وإيجاد شبكة من علاقات المتابعة والتنسيق بين شتى دوائر الدولة فيما يتعلق بقضايا تطبيق الإستراتيجية غير أن ذلك كله لا يخفي حقيقة أن المرأة العراقية واجهت في الوقت نفسه إشكالات صعبة، لم تتمكن القرارات والتشريعات، مهما بلغت أهميتها وقيمتها النظرية، من أن تخفف من أعباء تلك الإشكالات. وذلك بسبب أن الإستراتيجية وضعت في ظل ظروف معقدة شهدها العراق وعايشها طوال سنوات إصدار الإستراتيجية بالإضافة إلى أن الإستراتيجية كانت شديدة الإيجاز غير واضحة المفاهيم، فضلا عن حقيقة أن الاتحاد كان يشغل مركز نائب رئيس اللجنة الوطنية لكن دوره كان محدودا نظرا لهيمنة وزارة العمل، من جانب آخر فأن علاقة الاتحاد وكذلك اللجنة الوطنية مع المنظمات الدولية انحسرت إلى حد كبير رغم أن الاتحاد حصل بتاريخ 16/12/1996 على الصفة الاستشارية كمنظمة غير حكومية في الأمم المتحدة بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 23/1996 (0)
وفي عام 2020، أصدرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) والمعهد العراقي تقريراً احتل فيه العراق المرتبة 70 في العالم لتمثيل المرأة في البرلمان (0).
المبحث الثالث: التنظيم القانوني لنظام الكوتا النسائية في العراق
يتضمن هذا المبحث المعالجة القانونية على المستوى الوثائق الدستورية والوثائق القانونية، نظرا لأهمية النص علية في الوثائق القانونية كضمانة لهذا النظام وحماية لحق المرأة في ممارسة حقوقها السياسية:
المطلب الأول: التنظيم الدستوري لنظام الكوتا النسائية
نظم قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2004 نظام الكوتا النسائية بالنسبة للجمعية الوطنية في المادة 30 فقرة ج والتي تنص على أن "... يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من أعضاء الجمعية الوطنية..."، وهو بذلك يعد أول مرة يستخدم هذا النوع من التمييز الإيجابي لصالح المرأة في العراق.
وعليه فإن عدد أعضاء الجمعية الوطنية (275) عضو فالنسبة وفقاً لهذا النص هي الربع ولا يمكن الحصول على الربع هنا ألا بتقريب الناتج الحاصل أو قسمة عدد الأعضاء على (4) أربعة فيكون العدد (69)، وان كان النص الدستوري قد تضمن عبارة لا تقل فقد تكون النسبة أكثر من الربع وهذا ما يفهم من الصياغة اللفظية للنص الدستوري.
فدخلت المرأة العراقية الجمعية الوطنية والبرلمان العراقي عن طريق (الكوتا) فقد رشحت أكثر من 2000 امرأة من مجموع 6000 مرشح، أن اعتماد مفهوم ومنهج الكوتا (حصص) من اجل تمكين المرأة العراقية من الدخول إلى مختلف المؤسسات القيادية والسياسية والذي ورد في قانون إدارة الدولة الذي وضعه بول بريمر الحاكم العسكري في العراق المحتل في هذا القانون أعطى للمرأة العراقية الحق في المشاركة بنسبة لا تقل عن 25% في الجهاز التشريعي والتنفيذي فرشحت المرأة ولكن عبر المحاصصة والطائفية بدلا من استحقاقها الحقيقي وفقا لما تملكه من مؤهلات وقدرات قيادية.
بحيث اصبح وجود المرأة في البرلمان العراقي مجرد إشغال مقاعد وفق إملاءات سياسية وحزبية فلا يؤثر من حصولهن على هذه النسبة ولا يكون لهن صوت مؤثر(0).
وأشار الدستور العراقي لسنة 2005 في المادة 49 إلى أنه " يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من عدد أعضاء مجلس النواب "(0).
المطلب الثاني: التنظيم التشريعي لنظام الكوتا النسائية
أكد قانون الانتخابات العراقي رقم 16 لسنة 2005 – وهو اول قانون خاص بالانتخابات بعد تغيير النظام السياسي عام 2003- على نظام الحصص النسائية في مجلس النواب وذلك إعمالا" للنص الدستوري فجاءت المادة 11 منه مقرة لهذا النظام بقولها " يجب أن تكون امرأة واحدة على الأقل ضمن أول ثلاثة مرشحين في القائمة، كما يجب أن تكون ضمن أول ستة مرشحين في القائمة امرأتان على الأقل، وهكذا حتى نهاية القائمة ".
وفي عام 2020 تم إلغاء قانون الانتخابات واستبداله بقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020، والذي نص على "يشترط عند تقديم القائمة المفتوحة ان يراعى تسلسل النساء بنسبة امرأة بعد كل ثلاثة رجال"(0).
وأشار أيضا إلى(0):
-
أولاً: تكون نسبة تمثيل النساء بما لا يقل عن (٢٥%) من عدد أعضاء مجلس النواب.
-
ثانياً: تكون نسبة تمثيل النساء بما لا يقل عن (٢٥%) من عدد أعضاء مجلس النواب في كل محافظة.
-
ثالثاً: تحدد كوتا النساء لكل محافظة كما محدد في الجدول المرفق.
-
رابعًا: إذا أستنفذت الكوتا النسوية وفقاً لنتائج الانتخابات في المحافظة فلن تكون هناك عملية استبدال.
-
خامساً: يتم توزيع كوتا النساء في حالة عدم تحققها وفق البند (رابعاً) على النحو الاتي:
أ. تتم إضافة مقعد واحد (افتراضي) الى عدد النساء الفائزات لكل دائرة انتخابية
ب. يقسم العدد الحاصل نتيجة العملية في الفقرة (أ) على العدد الإجمالي للمقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية لتحديد النسبة المئوية للفائزات من النساء في حالة الزيادة.
ج. يضاف مقعد واحد لعدد مقاعد النساء للدائرة الانتخابية التي حصلت على أقل نسبة مئوية.
إذا لم يتم استكمال العدد المطلوب لمقاعد النساء المخصصة للمجلس وفقا لما ورد في الفقرات (أ، ب، ج) سيكون هنالك عملية جديدة تبدأ من الفقرة (أ) مع حساب الزيادة التي حصلت مسبقا في الفقرة (ج).
-
سادسًا: تتم إعادة هذه العملية حتى يصل العدد الإجمالي للنساء الى العدد المخصص للمجلس.
-
سابعًا: إذا حصل أثنان أو اكثر من الدوائر الانتخابية على النسب المئوية نفسها تتم إضافة مقعد الى الدائرة الانتخابية الحاصلة على أقل عدد من الأصوات.
-
ثامناً: إذا حصل تساوي في عدد الأصوات الصحيحة سيتم اللجوء الى القرعة لتحديد أي من الدوائر الانتخابية التي يجب إضافة مقعد لها.
-
تاسعاً: إذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فلا يشترط أن تحل محلها امرأة إلا إذا كان ذلك مؤثراً في نسبة تمثيل النساء".
إستناداً للمادة المذكورة أعلاه أكد القانون على نسبة 25% للنساء وجاء بطريقة حسابية جديدة لم يؤخذ بها في القانون السابق من أجل ضمان تمثيل النسبة، وهي في حالة عدم تحقق النسبة المطلوبة يتم إضافة مقعد نيابي إفتراضي يضاف الى باقي المقاعد المخصصة للنساء ومن ثم يتم قسمة العدد الكلي للأصوات على العدد الجديد للمقاعد ويتم إضافة مقعد واحد للدائرة الانتخابية التي تحصل على أقل نسبة مئوية وهكذا لغاية إكمال العدد المخصص للنساء لكل دائرة.
مع أن النسبة المثبتة في القانون المذكور لا ترقى إلى النسبة التي حددها برنامج المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة والقاضي بتحقيق نسبة لتمثيل النساء في أجهزة الدولة العليا لا تقل 30% إلا أن قانون الانتخابات أوجد طفرة نوعية في مجال تمثيل المرأة في المجالس النيابية للدولة قياسا" بنسبة تمثيلها في برلمانات الدول النامية وحتى المتطورة منها(0).
ونتيجة لتطبيق نظام الكوتا في العراق حصلت المرأة العراقية في الدورة النيابية الأولى 2006-2010 على 78 مقعد من أصل 275 مقعد معتمدا على الكوتا و21 مقعد بدون كوتا.
أما الدورة الثانية 2010-2014 حصلت على 81 مقعد من أصل 325 عن طريق الكوتا و15 مقعد بدون كوتا.
وفي الدورة الثالثة 2014-2018 استطاعت الفوز ب83 من أصل 329 بواسطة الكوتا و20 مقعد بدون كوتا. وحصلت في عام 2018 على 84 مقعد من أصل 329 بكوتا و22 مقعد بدون كوتا، وكلك تشغل نسبة 11% من السلطة التنفيذية بواقع إمرأتان من أصل 22 وزيراً (0).
وأخيرا فإن المرأة العراقية تمكنت من الفوز بـ 97 مقعدا في انتخابات 2021، بزيادة 14 مقعدا عن الكوتا المخصصة للنساء، من بينهن فائزتان من الأقليات(0).
وقد اعتمدت مصر مبدأ التخصيص الوجوبي لمقاعد النساء بمقتضى قانون رقم 21 لسنة 1979 الذي عدل قانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب فنص على تخصيص ثلاثين مقعد للمرأة في المجلس على الأقل. وفي ظل هذا التعديل وصل عدد العضوات إلى 35 عضوة في مجلس الشعب من أصل 454 عضو سنة 1979 بنسبة 9% تقريبا"(0).
إلا أن القضاء الدستوري المصري رفض هذا القانون وأعتبره مشوبا" بعيب عدم الدستورية لتمييزه بين المرأة والرجل(0)وذلك بدعوى انطوائه على مخالفة لمبادئ ثلاثة وهي:
-
الأول: مبدأ المساواة حيث يقرر ميزة لفئة من الشعب على حساب الأخرى.
-
الثاني: مبدأ حرية الترشيح والتصويت حيث خصص عددا من المقاعد لا ينافس عليها إلا النساء.
-
الثالث: مبدأ تمثيل عضو البرلمان للأمة جمعاء بكل طوائفها(0) ولذلك عدل عنه المشرع فأصدر القانون رقم 188 لسنة 1986 الذي قضى بإلغاء تخصيص مقاعد للمرأة، فانخفضت بنسبة تمثيل المرأة في البرلمان سنة 1987 إلى 4.2 % (0).
إلا أنه وفق تعديلات سنة 2007 للدستور المصري لسنة 1971 أشار المشرع المصري في المادة 62 منه إلى جواز أن يتضمن حد أدنى لمشاركة المرأة في المجلسين أي مجلس الشعب ومجلس الشورى (0) إلا أنه لم يحدد نسبة هذا الحد الأدنى علاوة على أن الأمر يدخل ضمن نطاق الجواز لا الوجوب، مما يدل على عدم فعالية هذا النص.
الخاتمة:
أولا: الاستنتاجات
1. مفردة الكوتا ( quota) تعنـي حصـّة أو نصيب … و النصيب هنا ليس مرتبطاً بقسمة الزواج و نصيبه.. بل هو مصطلح سياسي أستـُعمل لـزجّ المرأة (عـنوة) في الحياة السياسية.. لمعالـجة إشكالية ضعف مشاركة النساء في العملية السياسية ومواقع صنع القرار و تواجد المرأة في المجال العام.. وهو إقرار بـحقوقها في العالم أجمع. تختلف نسب المشاركة النسائية من دولة لأخرى حسب الطبيعة الاجتماعية والثقافية والقوانين المقرة في كل بل ويُعد تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار وسيلة لدعم النساء للمشاركة في الحياة العامة والسياسية لبلادهن على اختلاف خلفيات تلك النساء الطبقية والسياسية والاجتماعية والثقافية
2. أشار الدستور العراقي لسنة 2005 إلى الحق في المشاركة الانتخابية على أساس من المساواة بين المرأة والرجل وقام المشرع العادي بتنظيمه في قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005، ومن ثم في قانون رقم 9 لسنة 2020 بما يتفق مع مبدأ المساواة وروح الديمقراطية.
3. كان للأمم المتحدة فضل الريادة في عقد المؤتمرات الدولية في الفترة مابين (1975 – 1995) والتي اهتمت بمناقشة قضايا المرأة وطرح الحلول لتنشيط المبادرات النسوية ولإنهاء الأوضاع التي تعيق حركتهن، وقد بلغ ذلك حدا" اتخذت معه الأمم المتحدة من تلك الفترة عقدا" عالميا" للمرأة، وارتأت فيه ضرورة الوصول بتمثيل المرأة في البرلمانات الوطنية إلى نسبة لا تقل عن 30% كحد أدنى.
4.على الرغم من الطفرة المتزايدة في مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية والمدنية فأنهن ما زلن يمثلن نسبة ضئيلة في المراتب العليا والمناصب القيادية والتي تساعد في عملية سن التشريعات في صالح المرأة ومساواتها في المجتمع.
5. بالرغم من الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة من أجل مساواة المرأة بالرجل فأنه لا يزال هناك تمييز واسع النطاق ضدها، وإن هذا التمييز يشكل انتهاكا" لمبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان وعقبة أمام مشاركة النساء على قدم المساواة مع الرجال في الحياة السياسية في دولهن ويعيق نمو ورخاء المجتمع والأسرة.
6. إن تطبيق نظام الكوتا النسائية لتوزيع المقاعد النيابية أسفر عنه نتائج ايجابية في ممارسة الوظيفة التشريعية، إلا إن النساء بقين شبه غائبات عن الواقع السياسي إضافة إلى شغلهن المواقع الدنيا في الأحزاب السياسية، كما إن مجلس الرئاسة المكون من رئيس الدولة ونائبيه خلال فترة الحكومة الانتقالية لم يضم أي امرأة.
7. عند متابعة الكوتا النسائية في العراق ترى إنها طبقت شكليا وكما هو واضح في عدد من المقاعد النسوية في الجمعية الوطنية العراقية الانتقالية وفي 30 /كانون الثاني / 2005 حيث بلغ مجموع المقاعد النسوية ( 87) مقعد من أصل 275 مقعد أي ما يقارب الثلث أي العدد تجاوز النسبة المخصصة للنساء في قانون إدارة الدولة المؤقتة والبالغ 25 %. إلا أن المتتبع للتجربة الجمعية الوطنية التي استمرت قرابة العام الكامل إذ لم يسجل نشاط فاعل لهذا العدد الكبير من العضوات، أي إن إشراك المرأة كان لمجرد ملئ الفراغات.
8. من السلبيات التي رافقت تجربة المرأة البرلمانية هو انتمائها لأحزاب أعطتهم هذه المقاعد وحرضتهن على مقاعدهن الأمر الذي دفعهن إلى أن يأتمرن بأوامر وتوجيهات رؤساءالأحزاب والكتل السياسية التي وصلت إلى الجمعية الوطنية من خلالهم.
ثانيا: المقترحات
-
-
اتخاذ كافة التدابير الايجابية التي تحقق المساواة النوعية في مراكز السلطة وصنع القرار.
-
إعادة النظر في قانون الانتخابات لضمان تمثيل أوسع لأطياف المجتمع، ولا سيما النساء، على أسس العدالة، وذلك من خلال عدم احتساب النساء اللواتي فزن بمقعد في البرلمان بالأصوات اللازمة ضمن حساب الكوتا، واعتماد جميع الآليات الكفيلة بضمان تحقيق نسبة أعلى من ال 25 في المائة المنصوص عليها في المادة (49) الفقرة 4 من الدستور.
-
تضمين القوانين العراقية نصاً يُعرّف التمييز على أساس نوع الجنس ويحظره تماشياً مع المادة الثانية من اتفاقية القضاءعلى جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
-
بناء قدرات النساء للقيام بالحملات الانتخابية والظهور في وسائل الإعلام، حيث نجد بعض المرشحات في انتخابات 2021 لاتجرأ على الظهور في الاعلام، بحيث تتم الدعاية الانتخابية بحضور زوجها فقط.
-
إجراء تعديلات على قوانين الانتخابات البرلمان والمحافظات لإدراج نص يتعلق بالكوتا النسائية بأن تفرد قائمة خاصة بهن أسوة بكوتا الأقليات، يقدمها كل كيان سياسي داخل في الانتخابات، إضافة لقائمته الاعتيادية التي تكون مختلطة نساءً ورجالاً بحسب الترتيب الوارد ذكره في قانون الانتخابات.
-
تعديل المادة 11 من قانون الأحزاب رقم (36) لسنة 2015بتحديد نسبة (كوتا) لتمثيل النساء في المواقع القيادية للأحزاب لا تقل عن الثلث، لضمان التمكين السياسي للنساء وبناء قدراتهن القيادية والسياسية وتأهيلهن لخوض الحياة السياسية في كافة مراحلها.
قائمة المصادر والمراجع:
أولاً: الكتب العلمية
-
شيحا، إبراهيم عبد العزيز، بلا سنة طبع، النظم السياسية والقانون الدستوري تحليل النظام الدستوري المصري، منشأة المعارف، الإسكندرية.
-
ساري، جورجي شفيق، 2005، النظام الانتخابي على ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا – دراسة تأصيلية تحليلية، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة.
-
ألباز، داود، 2002، حق المشاركة في الحياة السياسية - دراسة تحليلية للمادة (62) من الدستور المصري مقارنة مع النظام في فرنسا، دار النهضة العربية، القاهرة.
-
خضير، عبد الكريم علوان، 2002، الوسيط في القانون الدولي العام، الكتاب الأول- المبادئ العامة.
-
حمزة، كريم محمد، 2004، تقييم وضع المرأة العراقية في ضوء منهاج عمل بيجين، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ( اليونيفيم) المكتب الإقليمي للدول العربية.
-
عكاشة، هشام عبد المنعم، 2004، الحقوق السياسية لمتعدد الجنسية، دار النهضة العربية، القاهرة.
-
مجموعة باحثين، 2005، نساء في البرلمانات – بعيدا عن الارقام، المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات.
-
المرأة والدستور العراقي، منشورات المركز الإعلامي، سلسلة دستورنا 2.
-
تورار، هيلين، 1998، تدويل الدساتير الوطنية، ترجمة باسيل يوسف، بيت الحكمة.
-
الحلو، ماجد راغب، 2003، القانون الدستوري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية.
-
غراهام، ولورانس وآخرون، بلا سنة طبع، السياسة والحكومة مقدمة للأنظمة السياسية في الولايات المتحدة وفي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا وأوربا الشرقية واليابان والمكسيك والعالم الثالث، ترجمة عبد الله بن فهد عبد الله اللحيدان، جامعة الملك سعود، الرياض.
ثانيا: البحوث:
-
خالد، حميد حنون، 2005، قراءة في قانون أدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، مجلة العلوم القانونية، جامعة بغداد، كلية القانون، العدد الأول، المجلد العشرون.
-
عبد الله، بدرية صالح، 2015، الدور السياسية للمرأة في العراق بعد عام 2003، مجلة العلوم القانونية والساسية، المجلد الرابع، العدد الثاني.
-
علك، منال فنجان، 2001، مبدأ عدم التمييز ضد المرأة في القانون الدولي والشريعة الإسلامية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية القانون، جامعة بغدا
ثالثاً: المقالات
-
ثابت، أحمد، الحركة النسائية العربية – التحديات النخبوية، الرابط الإلكتروني: www.ecwronline.org، تاريخ الزيارة 10/11/2021.
-
وحيد، أيمن محمد، أثر غياب الأمن السياسي على مشاركة المرأة، الرابط الإلكتروني: www.ecwronline.org، تاريخ الزيارة 1/11/2021.
-
المسلماني، بسام حسن، الكوتا النسائية، مركز باحثات لدراسات المرأة، https: //bahethat.com/
-
صالح، بيان، المشاركة السياسية للمرأة والوصول إلى موقع صنع القرار، الموقع الإلكتروني، المركز التقدمي لدراسات وأبحاث مساواة المرأة، 2006، الرابط الإلكتروني: www.rezgar.com
-
تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في العراق، المعهد العراقي، منظمة الامم المتحدة –الاسكوا، 2020.
-
أبو أصبع، بلقيس، تخصيص مقاعد للمرأة في المجالس المنتخبة: التجارب الدولية والعربية في تطبيق نظام الحصص (الكوتا) الموقع الإلكتروني، اللجنة الوطنية للمرأة، الرابط الإلكتروني: www.yemeni – women.org.ye
-
عادل لطفي، نحو نظام انتخابي أكثر حساسية وأكثر كفاءة تجاه المرأة المصرية، 2006، الموقع الإلكتروني، المركز المصري لحقوق المرأة، الرابط الإلكتروني: www.ecwronline.org/تاريخ الزيارة 6/9/2021.
-
عبد الستار، فوزية، حقوق المرأة في التشريعات المصرية، الموقع الإلكتروني، الورقة الوطنية، الرابط: www.amanjordan.org، تاريخ الزيارة 8/11/2021.
-
مصالحة، محمد، إيجابيات وجود المرأة في البرلمان، الموقع الإلكتروني، مركز الدراسات، الرابط الإلكتروني: www.amanjordan.org
-
البناص، محيي الدين رجب، الكوتا، الموقع الإلكتروني، المجلس القومي للمرأة، الرابط الإلكتروني: www.ncwegypt.com، تاريخ الزيارة 4/9/2021.
-
صباح سيادي، تجربة المرأة الأردنية السياسية ونظام الكوتا، 2006، الموقع الإلكتروني، مركز الدراسات، الرابط الإلكتروني: www.amanjordan.org، تاريخ الزيارة 5/10/2021.
-
الجابر، ضياء عبد الله، نظام الكوتا النسائية في مجلس النواب العراقي، 2006، الموقع الإلكتروني، مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية، الرابط الإلكتروني: www.fcdrs.com، تاريخ الزيارة 20/9/2021.
-
طارق حرب، المرأة العراقية في الدستور – الواقع والطموح، 2007، الموقع الإلكتروني: معهد الإمام الشيرازي الدولي للدراسات – واشنطن، الرابط الإلكتروني: www.siironline.org تاريخ الزيارة 30/11/2021.
-
طارق حرب، نظام الكوتا والدستور الدائم، الموقع الإلكتروني، الإسلام والديمقراطية، الرابط الإلكتروني: www.dimoislam.com، تاريخ الزيارة 30/11/2021.
-
طريق المرأة العراقية الى البرلمان، بواسطة آيات مظفر نوري، الموقع الإلكتروني: فكرة، الرابط الإلكتروني: https: //www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/tryq-almrat-alraqyt-aly-albrlman)
-
غلوم، عائشة، التمثيل السياسي للمرأة بنظام الكوتا المغرب نموذجا"، 2006، الموقع الإلكتروني، مركز الدراسات، الرابط الإلكتروني: www.amanjordan.org، تاريخ الزيارة 3/11/2021.
-
حاجم، فلاح إسماعيل، مبدأ المساواة ومهمة تفعيل دور المرأة في الحياة السياسية، الموقع الإلكتروني، المركز التقدمي لدراسات وأبحاث مساواة المرأة، 2006، الرابط الإلكتروني: www.rezgar.com، تاريخ الزيارة 16/11/2021.
-
مسعود عكو، حرية المرأة والقوانين الدولية، الرابط الإلكتروني: www.balagh.com
-
المشاركة السياسية للمرأة، الموقع الإلكتروني، ملتقى المرأة العربية، الرابط الإلكتروني: www.awfonline.org/page/jr
-
نهيل نزال، المرأة في فكر الإمام الشيرازي، الموقع الإلكتروني، مركز الإمام الشيرازي للدراسات والبحوث، الرابط الإلكتروني: www.shrsc.com، تاريخ الزيارة 2/11/2021.
-
القيم، هيثم، العراق نــظام الـكــوتا النسائية … ونتائج الأنتخابات، الموقع الإلكتروني: مساواة، الرابط الإلكتروني: http: //musawasyr.org، تاريخ الزيارة 4/9/2021.
-
الوضع السياسي للمرأة في أطار مفهوم الكوتا، 2003، الموقع الإلكتروني، اللجنة الوطنية للمرأة، الرابط الإلكتروني: WWW.YEMENI-WOMEN.ORG.YE، تاريخ الزيارة 9/9/2021.
-
أبو العينين، وهند فايز، قانون الكوتا النسائية، 2008، الموقع الإلكتروني، موقع امان، الرابط الإلكتروني: www.awapp.org
رابعاً: الكتب الاجنبية
1. Sartori,Giovanni, 1997, Comparative Constitutional Engineering, new York university press, U.S.A., p: 15, 181
خامساً: الدساتير والقوانين
-
الدستور الفرنسي لسنة 1958 النافذ.
-
الدستور المصري لعام2014 المعدل.
-
الدستور العراقي لعام 2005 النافذ.
-
قانون الانتخابات العراقي رقم 16 لسنة 2005.
-
قانون الأحزاب العراقي رقم (36) لسنة 2015.
-
قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (٩) لسنة 2020.
0- طارق حرب، نظام الكوتا والدستور الدائم، الموقع الإلكتروني، الإسلام والديمقراطية، الرابط الإلكتروني: www.dimoislam.com، والتمييز الإيجابي، الموقع الإلكتروني: ويكيبيديا، الرابط الإلكتروني: https: //ar.wikipedia.org/wiki، تاريخ الزيارة 30/11/2021.
0- ضياء عبد الله الجابر، نظام الكوتا النسائية في مجلس النواب العراقي، 2006، الموقع الإلكتروني، مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية، الرابط الإلكتروني: www.fcdrs.com، تاريخ الزيارة 20/9/2021. ولورانس غراهام وآخرون، السياسة والحكومة مقدمة للأنظمة السياسية في الولايات المتحدة وفي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا وأوربا الشرقية واليابان والمكسيك والعالم الثالث، ترجمة عبد الله بن فهد عبد الله اللحيدان، جامعة الملك سعود، الرياض، بلا سنة طبع، ص50.
0- هشام عبد المنعم عكاشة، الحقوق السياسية لمتعدد الجنسية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004، ص111.
0- بلقيس أبو أصبع، تخصيص مقاعد للمرأة في المجالس المنتخبة: التجارب الدولية والعربية في تطبيق نظام الحصص (الكوتا) الموقع الإلكتروني، اللجنة الوطنية للمرأة، الرابط الإلكتروني: www.yemeni – women.org.ye، تاريخ الزيارة: 3/11/ 2021.
أحمد ثابت، الحركة النسائية العربية – التحديات النخبوية، الرابط الإلكتروني: www.ecwronline.org، تاريخ الزيارة: 10/11/ 2021.
0- المشاركة السياسية للمرأة، الموقع الإلكتروني، ملتقى المرأة العربية، الرابط الإلكتروني: www.awfonline.org/page/jr، تاريخ الزيارة تشرين الاول 2021.
0- محمد مصالحة، ايجابيات وجود المرأة في البرلمان، الموقع الإلكتروني، مركز الدراسات، الرابط الإلكتروني: www.amanjordan.org، تاريخ الزيارة تشرين الاول 2021.
0- مجموعة باحثين، نساء في البرلمانات – بعيدا عن الارقام، المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، 2005، ص21.
0- بلقيس أبو أصبع، مصدر سابق.
0- بدرية صالح عبد الله، الدور السياسية للمرأة في العراق بعد عام 2003، مجلة العلوم القانونية والساسية، المجلد الرابع، العدد الثاني، 2015، ص236.
0- بسام حسن المسلماني، الكوتا النسائية، مركز باحثات لدراسات المرأة، https: //bahethat.com/، تاريخ الزيارة: تشرين الاول 2021. وصباح سيادي، تجربة المرأة الأردنية السياسية ونظام الكوتا، 2006، الموقع الإلكتروني، مركز الدراسات، الرابط الإلكتروني: www.amanjordan.org، تاريخ الزيارة: 5/10/ 2021.
0- أشارت إليه عائشة غلوم، التمثيل السياسي للمرأة بنظام الكوتا المغرب نموذجا"، 2006، الموقع الإلكتروني، مركز الدراسات، الرابط الإلكتروني: www.amanjordan.org، تاريخ الزيارة: 3/11/ 2021.
0- محيي الدين رجب البناص، الكوتا، الموقع الإلكتروني، المجلس القومي للمرأة، الرابط الإلكتروني: www.ncwegypt.com، تاريخ الزيارة، تشرين الاول 2021.
0- CONSEIL CONSTITUTIONNEL: DECISIONS RENDUES,web site; www. Conseil-constitutionnel.fr/ decision/2000
0- هيثم القيم، العراق نــظام الـكــوتا النسائية … ونتائج الأنتخابات، الموقع الإلكتروني: مساواة، الرابط الإلكتروني: http: //musawasyr.org/ تاريخ الزيارة: 4/9/ 2021.
0- Giovanni Sartori, Comparative Constitutional Engineering, newYork university press, U.S.A., 1997, p: 15, 181.
0- حميد حنون خالد، قراءة في قانون أدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، مجلة العلوم القانونية، جامعة بغداد، كلية القانون، العدد الأول، المجلد العشرون، 2005، ص20.
0- طارق حرب، المرأة العراقية في الدستور – الواقع والطموح، 2007، الموقع الإلكتروني: معهد الإمام الشيرازي الدولي للدراسات – واشنطن، الرابط الإلكتروني: www.siironline.org.
0- الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا، الرابط الإلكتروني: www.iraqidevelopers.com/iraqfsc/ar، تاريخ الزيارة: 5/12/2021.
0- إبراهيم عبد العزيز شيحا، النظم السياسية والقانون الدستوري تحليل النظام الدستوري المصري، منشأة المعارف، الإسكندرية، بلا سنة طبع، ص560.وداود ألباز، حق المشاركة في الحياة السياسية - دراسة تحليلية للمادة (62) من الدستور المصري مقارنة مع النظام في فرنسا، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002، ص427، 118.وماجد راغب الحلو، القانون الدستوري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2003، ص179.
0- المرأة والدستور العراقي، منشورات المركز الإعلامي، سلسلة دستورنا 2، ص16.
0- محيي الدين رجب البناص، الكوتا، الموقع الإلكتروني، المجلس القومي للمرأة، الرابط الإلكتروني: www.ncwegypt.com، وهند فايز أبو العينين، قانون الكوتا النسائية، 2008، الموقع الإلكتروني، موقع امان، الرابط الإلكتروني: www.awapp.org
0- الوضع السياسي للمرأة في أطار مفهوم الكوتا، 2003، الموقع الإلكتروني، اللجنة الوطنية للمرأة، الرابط الإلكتروني: WWW.YEMENI-WOMEN.ORG.YE، تاريخ الزيارة 9/9/2021.
0 - ضياء عبد الله الجابر، مصدر سابق، الرابط الإلكتروني: www.fcdrs.com، تاريخ الزيارة: تشرين الاول 2021.
0- محمد مغرم، مصدر سابق، الرابط الإلكتروني: www.yemeni – women.org.ye، تاريخ الزيارة: تشرين الاول 2021.
0- ضياء عبد الله الجابر، مصدر سابق، الرابط الإلكتروني: www.fcdrs.com
0- أيمن محمد وحيد، أثر غياب الأمن السياسي على مشاركة المرأة، الرابط الإلكتروني: www.ecwronline.org، تاريخ الزيارة 1/12/2021.
0- نهيل نزال، المرأة في فكر الإمام الشيرازي، الموقع الإلكتروني، مركز الإمام الشيرازي للدراسات والبحوث، الرابط الإلكتروني: www.shrsc.com، تاريخ الزيارة 2/11/2021.
0- مسعود عكو، حرية المرأة والقوانين الدولية، الرابط الإلكتروني: www.balagh.com، تاريخ الزيارة: ايلول 2021.
0- عبد الكريم علوان خضير، الوسيط في القانون الدولي العام، الكتاب الأول- المبادئ العامة، 2002، ص20.
0- بيان صالح، المشاركة السياسية للمرأة والوصول إلى موقع صنع القرار، الموقع الإلكتروني، المركز التقدمي لدراسات وأبحاث مساواة المرأة، 2006، الرابط الإلكتروني: www.rezgar.com.
0 - احمد ثابت، مصدر سابق.
0- أحرزت بلدان كثيرة تقدما في تنفيذ ما أوصت به نصوص الاتفاقيات وبرامج أعمال المؤتمرات الدولية ومنها مؤتمر المرأة الرابع المعني بالمرأة، أشار إليه منال فنجان علك، مبدأ عدم التمييز ضد المرأة في القانون الدولي والشريعة الإسلامية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية القانون، جامعة بغداد، 2001، ص32-33.
0- أيمن محمد وحيد، مصدر سابق.
0- هيلين تورار، تدويل الدساتير الوطنية، ترجمة باسيل يوسف، بيت الحكمة، 1998، ص465.
0- كريم محمد حمزة، تقييم وضع المرأة العراقية في ضوء منهاج عمل بيجين، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ( اليونيفيم) المكتب الإقليمي للدول العربية، 2004، ص11,91.
0- طريق المرأة العراقية الى البرلمان، بواسطة آيات مظفر نوري، الموقع الإلكتروني: فكرة، الرابط: www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/tryq-almrat-alraqyt-aly-albrlman)
0- بدرية صالح عبد الله، مصدر سابق، ص244.
0- المادة 49/رابعا من الدستور العراقي النافذ لعام 2005.
0- المادة -14 من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020.
0- المادة -16 من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020.
0- فلاح إسماعيل حاجم، مبدأ المساواة ومهمة تفعيل دور المرأة في الحياة السياسية، الموقع الإلكتروني، المركز التقدمي لدراسات وأبحاث مساواة المرأة، 2006، الرابط الإلكتروني: www.rezgar.com، تاريخ الزيارة 15/11/2021.
0- تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في العراق، المعهد العراقي، منظمة الأمم المتحدة –الاسكوا، 2020.
0- العراق.. فوز 97 امرأة بالانتخابات، الحرة، الرابط الإلكتروني: https: //www.alhurra.com/iraq/2021/10/12، تاريخ الزيارة 5/12/2021.
0- فوزية عبد الستار، حقوق المرأة في التشريعات المصرية، الموقع الإلكتروني، الورقة الوطنية، الرابط: www.amanjordan.org، تاريخ الزيارة 8/11/2021.
0- حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية الصادر بتاريخ 16 مايو 1987 في القضية رقم 131 لسنة 6 قضائية دستورية، أشار إليه جورجي شفيق ساري، النظام الانتخابي على ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا – دراسة تأصيلية تحليلية، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005، ص143.
0- عادل لطفي، نحو نظام انتخابي أكثر حساسية وأكثر كفاءة تجاه المرأة المصرية، 2006، الموقع الإلكتروني، المركز المصري لحقوق المرأة، الرابط الإلكتروني: www.ecwronline.org، تاريخ الزيارة 6/9/2021.
0 - فوزية عبد الستار، مصدر سابق، الرابط الإلكتروني www.amanjordan.org.
0- والتي تنص "... وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى وفقا" لأي نظام انتخابي يحدده. ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردي ونظام القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها، كما يجوز أن يتضمن حدا" أدنى لمشاركة المرأة في المجلسين".
Rawafid Altayyar || The legal regulation of the women's quota according to the Constitution of the Republic of Iraq 2005 - a comparative study ||Ibn Khaldoun Journal for Studies and Researches || Volume 2 || Issue 6|| Pages 683 - 711.
0
| Article Title | Authors | Vol Info | Year |
| Article Title | Authors | Vol Info | Year |