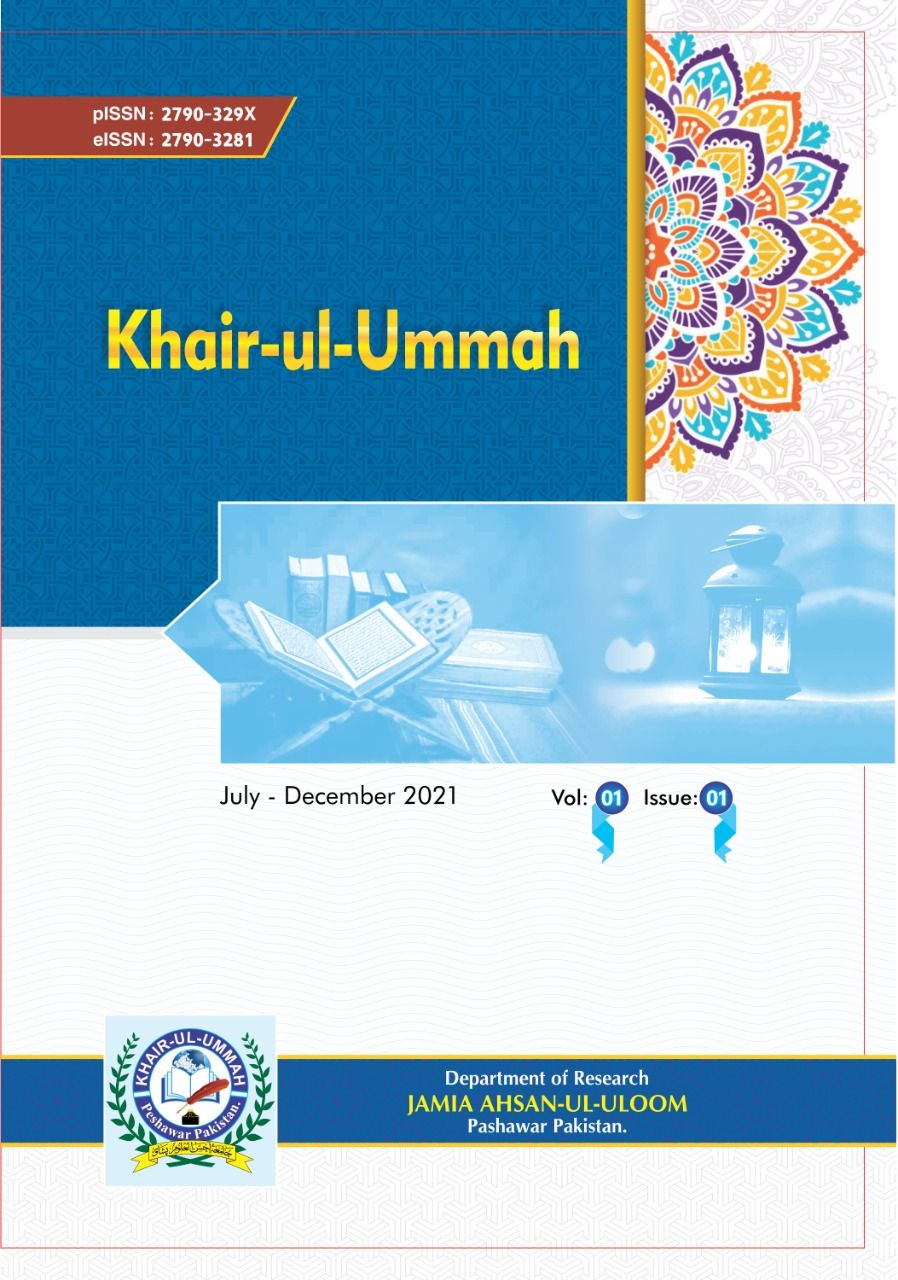1
1
2021
1682060062721_2077
81-93
https://khairulumma.com/index.php/about/article/download/9/8
أنزل الله سبحانه وتعالى كتابه على رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم وجعله آية رسالته، ورتّبه بأحسن ترتيب ودقة وأوجز عبارة، وقد وعد الله سبحانه وتعالى بحفظه حتى كلّف له عباداً ورجالاً وعلماءً الذين قاموا بخدمة هذا الكتاب وأفنوا أعمارهم ببيان معانيه حسب تدبرهم وفهمهم ووجهة أنظارهم ووسعة أفكارهم وتطور زمانهم واختلاف أحداثهم حتى ظهر اختلاف أقوالهم في تفاسيرهم؛ فقمنا في هذا المقال ببيان حقيقة هذا الاختلاف وأنواعهم حتى وضّح لنا بأن اختلافهم اختلاف التنوع أو اختلاف التضاد؟
مفهوم الاختلاف:
الاختلاف هو ضد الاتفاق؛ يقال: اختلاف الأمران إذا لم يتفقا. والاختلاف هو لفظٌ مشتركٌ بين معانٍ متعدةٍ فقيل: هذا كلام مختلف حينما لم يماثل أوله في الفصاحة مع آخره، وكذا قيل حينما بعض أسلوبه مخصوص في الجزالة وبعضه يخالفه فيه(1).
أما تعريف الخلاف كمصطلح فنيٍّ فهو: "منازعة تجري بين المتعارضين لتحقيق حق أو لإبطال باطل"، وقد عرّف بأنه: "أن يأخذ كل واحد طريقاً غير طريق الآخر في حاله أو قوله"(2).
فنرى أن لفظ "الاختلاف" يأتي بمعنى التغاير والتباين سواء أدى ذلك إلى التناف والتعارض أو لم يؤد ومعناه الاصطلاحي قريب بالمعنى اللغوي. أما الاختلاف في التفسير هو "عدم اتفاق المفسرين على دلالة الآية أو اللفظ القرآني بحيث تعين مراد الله تعالى منها"، حتى يتوصل المفسرون إلى معانٍ مغايرٍ ومختلفٍ – ولو في الظاهر – لما توصل إليه غيره.
وقد جاء في القرآن الكريم لفظ الاختلاف والخلاف كليهما أحياناً بمعنى "المغايرة والمخالفة" أو بمعنى "خلف وبعد"، مع أن بعض العلماء فرّق بينهما ورأوا بأن "الخلاف" أعم من "الاختلاف" ولكن في الحقيقة هاتين كلمتين قد تستخدمان في محل بعضهما، حتى لا يوجد الفرق بينهما في عبارات الأصوليين والفقهاء، وهم يستعملونهما في مصنفاتهم بمعنى واحد.
حقيقة الاختلاف:
وقوع الاختلاف في الفروع سنة من سنن الله الكونية وهي ضرورة ورحمة وسعة:
من المحال جمع الناس على رأي واحد وإلى وجهة نظر واحدة. فهي طبيعة جبلت عليها النفوس وفتح لها المجال من قبل الشرع كذلك "فليس لأحد أن ينكر على الآخرين ما قد يفهمونه من النص من فهم مخالف لفهمه، ما دام اللفظ يحتمله، والدليل يتسع له، ونصوص الشرع الأخرى لا تناقضه أو تعارضه، ومعظم الأحكام المتعلقة بالفروع والمتناولة للنواحي العملية هي من النوع الذي يثبت بالطرق الظنية رحمة من الله تعالى بعباده، ليتسع للناس مجال الاجتهاد فيها."(3) ومن ذلك أيضاً اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم واختلافهم. قال عمر بن عبد العزيز: ما أحب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا؛ لأنه لو كانوا قولاً واحداً كان الناس في ضيق، وأنهم أئمة يقتدى بهم.(4) فاختلاف الناس في الآراء طبيعة أدت إليها عوامل مختلفة كما سيأتي تفصيلها:
أولاً: طبيعة الدين
فطبيعة الدين اقتضت الاختلاف في الفروع؛ حيث أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون في أحكامه المنصوص عليها والمسكوت عنها، ثم إرادته سبحانه في المنصوص عليها بأن يكون فيها المحكمات والمتشابهات، والقطعيات والظنيات، والصريح والمؤول، ونحو ذلك. فاحتيج إلى الاجتهاد، وإلى إعمال العقول والألباب في فهم المتشابهات والظنيات وغيرهما لاستخراج الأحكام والنكت، وللابتلاء والاختبار، قال تعالى: ﴿هُوَ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ مِنۡهُ ءَايَٰت مُّحۡكَمَٰتٌ هُنَّ أُمُّ ٱلۡكِتَٰبِ وَأُخَرُ مُتَشَٰبِهَٰت...﴾(5) ففُسّرت الآيات المتشابهات بأنها: "محتملات لا يتضح مقصودها لإجمال، أو مخالفة ظاهر إلا بالفحص والنظر ؛ ليظهر فيها فضل العلماء، ويزداد حرصهم على أن يجتهدوا في تدبرها ، وتحصيل العلوم المتوقف عليها استنباط المراد بها، فينالوا بها وبإتعاب القرائح في استخراج معانيها، والتوفيق بينها وبين المحكمات معالي الدرجات"(6).
ومن ذلك أيضاً تعدد وجوه القراءات في القرآن الكريم، ولو شاء الله لجمع الأمة على قراءة واحدة، ولكن اقتضت رحمة الله تعالى وسعته على الأمة وحكمته الواسعة بجَعْلها سبعة أحرف -وهي المتفق عليها- تسهيلاً وتخفيفاً. ويؤيده ما ورد في ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث اختلف مع هشام بن حكيم رضي الله عنه في قراءة سورة الفرقان، وذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقر بقراءتهما، وقال لهما: "كَذَلِكَ أُنْزِلَتْ"(7).
ثانياً: طبيعة اللغة
فالنصوص الشرعية نصوص قولية لفظية، يجري عليها ما يجري على النصوص اللغوية عند فهمها وتفسيرها؛ إذ هي واقعة وفق ما تقتضيه اللغة في الألفاظ والتراكيب، وما تحمله من معان ومفاهيم باختلاف أوجهها، ومن ذلك كون اللفظ مشتركاً، أو احتماله الحقيقة والمجاز، أو العموم والخصوص، أو الإطلاق والتقييد، ونحو ذلك. فكم من آراء واختلافات تفسيرية وقعت في فهم آية قرآنية لدى العلماء جلّها يتعلق باللغة وأحوالها. ومن أمثلة ذلك قولهم في حكم الباء في قوله تعالى: ﴿وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِ﴾(8) هل هي تبعيضية، أم زائدة أم للإلصاق؟ وما الأحكام المترتبة عليها؟(9) وتكثر الأمثلة في هذا المقام، وقد سجلت الأقلام ما تقتضيه طبيعة اللغة من اختلاف في فهم معاني الآيات، وما يترتب عليها من اختلاف في الأحكام والمسائل.
ونرى مثلاً من المفسرين من اهتم بهذا الجانب اهتماماً كبيراً -أي التفسير اللغوي للآيات- ومن أبرزهم: الزمخشري صاحب الكشاف (المتوفى: 538هـ)، وابن عطية صاحب المحرر الوجيز (المتوفى: 541هـ)، والبيضاوي صاحب أنوار التنزيل وأسرار التأويل (المتوفى: 685هـ)، وأبو السعود صاحب إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب العزيز (المتوفى: 982هـ)، والإمام الآلوسي صاحب تفسير روح المعاني (المتوفى: 1270هـ)، وابن عاشور صاحب التحرير والتنوير (المتوفى: 1393هـ). وغيرهم.
ثالثاً: طبيعة البشر
حيث "قضت مشيئة الله تعالى خلق الناس بعقول ومدارك متباينة، إلى جانب اختلاف الألسنة والألوان والتصورات والأفكار، وكل تلك الأمور تفضي إلى تعدد الآراء والأحكام، وتختلف باختلاف قائليها. وإذا كان اختلاف الألسنة والألوان والأفكار آية من آيات الله تعالى، فإن اختلاف المدارك والعقول وما تثمره تلك المدارك والعقول آية من آيات الله تعالى كذلك، ودليل من أدلة قدرته البالغة، ولا يتحقق إعمار الكون وازدهار الوجود وقيام الحياة لو أن البشر خلقوا سواسية في كل شيء، وكل ميسر لما خلق له ﴿وَلَوۡ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّة وَٰحِدَة وَلَايَزَالُونَ مُخۡتَلِفِينَ﴾ ﴿إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَۚ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمۡ﴾(10) "(11)
فالبشر يختلفون في أطباعهم وصفاتهم -حتى أن الأخوين قد يختلفان في أطباعهما رغم ترعرهما على يد أم واحدة وعيشهما تحت سقف واحد وعلى طريقة واحدة- فمنهم من يتسم بالتشديد والعسر، وآخر يميل إلى اليسر والتيسير، ومنهم من يرى الظاهر، ومنهم من يغوص في بواطن الأمور وأعماقها وهكذا. وتلك اتجاهات نفسية يترتب عليها اختلاف في الآراء، وفي وجهات النظر، ويتبعها كذلك اختلاف النظر إلى النصوص وفهمها، وبالتالي الحكم عليها.
ومن أمثلة ذلك ما ورد في قصة أسرى بدر حين استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابيين أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما في أمرهم، فأشار أبو بكر رضي الله عنه بأخذ الفداء وإطلاق سراحهم، وأشار عمر رضي الله عنه بضرب أعناقهم (12). وكما نعلم من حياة هذين الصحابيين فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه عُرف باللين والرحمة، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه عُرف بالشدة والقوة، وينعكس هذا في حياتهما (13).
رابعاً: طبيعة الكون والحياة
إن طبيعة الكون والحياة كذلك يختلفان اختلافاً ينفي التناقض والتضارب ، ويثبت التنوع والتلون المطلوب لسير الأمور وتعايش البشر ، وهي دليل قدرة الله تعالى ، وإحكامه في تدبير الأمور ، وهذه الطبيعة قد سجلها الله تعالى في محكم كتابه، قال تعالى: ﴿أَلَمۡ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآء فَأَخۡرَجۡنَا بِهِۦثَمَرَٰت مُّخۡتَلِفًا أَلۡوَٰنُهَاۚ وَمِنَ ٱلۡجِبَالِ جُدَدُۢ بِيض وَحُمۡر مُّخۡتَلِفٌ أَلۡوَٰنُهَا وَغَرَابِيبُ سُود﴾ ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآبِّ وَٱلۡأَنۡعَٰمِ مُخۡتَلِفٌ أَلۡوَٰنُهُ...﴾(14)
ثم إن اختلاف الليل والنهار وتعاقبهما، واختلاف الأرض من صحراء ووديان وسهول وجبال، واختلاف الطقس والجو من برودة وحرارة واعتدال، كل هذا دليل على اختلاف طبيعة الكون، وتبعاً لها اختلاف طبيعة حياة البشر فيها اختلافاً يؤدي إلى التلاؤم والانسجام، وينفي التضاد ﴿مَّا تَرَىٰ فِي خَلۡقِ ٱلرَّحۡمَٰنِ مِن تَفَٰوُت﴾(15) وذلك إثبات لعظيم قدرة الله تعالى، وهي آية من آياته الكبرى، قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلۡقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَٱخۡتِلَٰفِ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ لَأٓيَٰت لِّأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ﴾(16)
وكذلك اختلاف الحياة حسب اختلاف المكان والزمان إلى شدة ورخاء، وفرح وحزن، وعذوبة وملوحة ونحوها. كل هذا يؤدي إلى اختلاف النظر إلى الحياة وما يحيط بها، وبالتالي اختلاف الحكم على الأشياء. وهو مطلوب طالما أدى إلى الرحمة والتيسير، وإذا ما أدى إلى الشقاق والنزاع فنحن في غنى عنه، والدين من باب أولى.
أنواع الاختلاف في التفسير:
إن وقوع الاختلاف في التفسير حقيقة لا مفر من الإقرار بها، ولا ينكرها إلا مكابر أو عديم الاطلاع على كتب التفسير وعلومه؛ فالناظر في كتب التفسير وعلومه يتيقن من وقوع هذا الاختلاف بنوعيه على مر العصور والأزمان، بل وكونه مورداً من موارد الشبهات التي تلبس بها المسيئون إلى الإسلام وعلومه وأصحاب الفتن. وقد وقع هذا الاختلاف في نوعي التفسير؛ أي التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي. وهنا نبين هذين النوعين ووقوع الاختلاف فيهما بشيء من التفصيل.
أولاً: الاختلاف في التفسير بالمأثور
والمراد بالتفسير بالمأثور: "هو ما جاء في القرآن أو السنة أو كلام الصحابة أو التابعين (على خلاف) بياناً لمراد الله تعالى من كتابه"(17) فالقسم الأول -أي القرآن الكريم- لا شك في قبوله؛ لأن الله تعالى أعلم بمراد كلامه من غيره، والقرآن الكريم أصدق الحديث بلا شك. أما القسم الثاني وهي السنة المطهرة فالمأخوذ منها هو الصحيح والحسن؛ لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والسنة هي المبينة والشارحة للقرآن الكريم. وأما أقوال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فهي المعتمدة بعد هذين القسمين؛ لأن الصحابة هم الذين عاينوا وشاهدوا أحوال التنزيل، وقد حُظوا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبر هذه الأمة وأصدقها وأعلمها بكتاب الله. ولذا قول الصحابي الذي شهد الوحي له حكم الرفع فقال الحاكم: "ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند"، وهناك من جعل لذلك ضابطاً فقال ابن حجر: "والحق أن ضابط ما يفسره الصحابي إن كان مما لا مجال للاجتهاد فيه ولا منقولا عن لسان العرب فحكمه الرفع وإلا فلا كالإخبار عن الأمور الماضية..." (18).
ثانياً: الاختلاف في التفسير بالرأي
والمراد بالرأي هو الاجتهاد، فإن كان هذا الاجتهاد موفقاً أي مستنداً إلى ما يجب الاستناد إليه وبعيداً عن الجهالة والضلالة، فالتفسير به محمود وإلا فمذموم. وقد حدد العلماء الأفذاذ لهذا النوع من التفسير ضوابط وقواعد وعلوماً يحتاج إليها، وهي ضرورية لمن يريد الخوض في التفسير بالرأي، كما بيّنتها كتب علوم القرآن وأصول التفسير أحسن تبيين، وليس محلها ههنا، ويمكن الرجوع إلى تلك الكتب للاستفادة والاستزادة (19).
وأما الاختلاف في التفسير بالرأي فهو ما عُلِم كثرته في كتب التفسير؛ لأن كل مجتهد له اجتهاده في فهم المعاني وتهذيبها حسبما يقتضيه طبعه وتبحره في علم من العلوم، وحسب ميوله واعتقاداته بغض النظر عن صحة تلك الاعتقادات من خطئها. فمن المفسرين من يعطي الجانب اللغوي والبلاغي اهتماماً كبيراً في تفسيره كالإمام الزمخشري، والإمام أبي حيان الأندلسي، والإمام الآلوسي، والشيخ أبي السعود، وغيرهم، ومنهم من يهتم بآيات الأحكام ويجتهد فيها كالإمام الجصاص، والإمام عماد الدين الكيا الهراسي، والإمام الطحاوي، والإمام ابن العربي، والإمام القرطبي وغيرهم، ومنهم من يهتم بالجانب الكلامي كالإمام الجبائي، والرماني، والإمام الرازي، ونحوهم، وهكذا. وينشأ الاختلاف فيما بينهم في الحكم على الآية الواحدة وما تؤديه من معانٍ، فتارة يمكن الجمع بين هذه التفسيرات المختلفة، وأخرى يلزم الترجيح بين أقوالهم المختلفة.
وقد كثر في الآونة الأخيرة آراء العلماء تبعاً لكثرة التفاسير الموجدة يوماً بعد يوم، ولا شك أن هذا دليل على تحمّل الآيات القرآنية لمعانٍ متعددة. ولا يعني ذلك أن الكل صحيح فيما يحمّل تلك الآيات القرآنية من معانٍ، ولكن مع هذا فإن الكثير من العلماء ممن التزم نهج السلف الصالح وُفِق في بيان معاني الألفاظ القرآنية.
هذا وتكثر الأمثلة في الاختلاف في التفسير بالرأي ولكن نقتصر بذكر مثال واحد كما في قول الله تعالى: ﴿وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَٰضِبا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقۡدِرَ عَلَيۡهِ ...﴾(20) اختلف أهل التأويل في قوله تعالى: ﴿فَظَنَّ أَن لَّن نَّقۡدِرَ عَلَيۡهِ﴾ على أوجه؛ الأول: ظنّ أن لن نعاقبه بالتضييق عليه في بطن الحوت، من قولهم قدرتُ على فلان: إذا ضيقت عليه، كما قال الله جلّ ثناؤه: ﴿وَمَن قُدِرَ عَلَيۡهِ رِزۡقُهُ فَلۡيُنفِقۡ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ﴾(21) وبه ذكر الطبري في تفسير هذه الآية جميع تأويلات العلماء لها بأسانيدها، ثم رجّح هذا القول، وذكر سبب ترجيحه له فقال: "وإنما قلنا ذلك أولى بتأويل الكلمة، لأنه لا يجوز أن ينسب إلى الكفر وقد اختاره لنبوته، ووصفه بأن ظنّ أن ربه يعجز عما أراد به ولا يقدر عليه، ووصف له بأنه جهل قدرة الله، وذلك وصف له بالكفر، وغير جائز لأحد وصفه بذلك..." (22). والثاني: ظنّ أن لن يأخذه العذاب الذي أصابه. ولن نقضي عليه العقوبة. وإليه ذهب الشوكاني في تفسيره(23). والثالث: فظن أنه يعجز ربه فلا يقدر عليه. وهو قول فاسد مردود. والرابع: بمعنى الاستفهام، وإنما تأويله: أفظنّ أن لن نقدر عليه؟ وبه قال ابن زيد.
وقد تتبعنا أقوال المفسرين في تفسير هذه الآية، واتضح لنا أن القولين الأولين عليهما أكثر المفسرين والعلماء.
أنواع الاختلاف في التفسير باعتبار المعنى واللفظ:
إذا نظرنا في أنواع الاختلافات الكلية للتفسير التي ذكرها معظم المفسرين والمؤلفين -سواء كانت من حيث الموضوع، أو باعتبار درجة الاختلاف، أو من حيث القبول والرد، أو باعتبار الدافع للاختلاف أو التأثير في المعنى- فإنها ترجع إلى أصلين: إما التنوع أو التضاد، كما سيأتي تفصيلهما بالآتي:
اختلاف التنوع:
إن اختلاف التنوع من مقتضيات الرحمة التي أرادها الله تعالى لعباده، وهو دليل السعة واليسر على الأمة؛ ولذا نجده عند السلف الصالح في كثير من فروع الدين الحنيف.
تعريف اختلاف التنوع:
لم نقف على تعريف خاص للعلماء السابقين لاختلاف التنوع، وما ورد عن أكثرهم يُعد ذكراً لبعض صوره وأنواعه. وقد عرفه الباحثون بتعريفات تكاد أن تكون متقاربة المعنى متحدة المفهوم، ومن أهم ما توصلنا إليه:
-
"أن تحمل الآية على جميع ما قيل فيها إذا كانت معان صحيحة غير متعارضة"(24).
-
"ما يصح حمل الآية على جميع ما قيل فيها ما دامت معاني صحيحة غير متعارضة"(25).
وإذا دققنا النظر في التعريفين السابقين نجد أنهما متقاربان في المعنى المراد والمفهوم، وإنما الاختلاف في الألفاظ المعبرة عنه. كما نجدهما قاصران في بيان المعنى المراد لاختلاف التنوع لسببين(26)؛ الأول: عدم النظر إلى مدى احتمال النص القرآني للمعنى، مع اعتبار صحة القول. وهذا غير دقيق لأن القول قد يكون صحيحاً، ولكن لا تحتمله تلك الآية المفسرة. ثم إن القول الخطأ مرفوض من أول الأمر. والثاني: اعتبار الجمع بين الأقوال الواردة مع عدم مراعاة حالة الاختلاف في تلك الأقوال، مع أن حالة الاختلاف هي الأهم، ولها الاعتبار أولاً.
وأصح التعريفات لهذا الاختلاف هو: "تعدد الأقوال التفسيرية الواردة في معنى النص المفسَّر شريطة احتماله لها بلا تكلف"(27).
فمن التعريف السابق يتضح أن اختلاف التنوع يقوم على ثلاث دعائم متصلة بعضها مع بعض؛ الأول: تعدد الأقوال التفسيرية. والثاني: احتمال النص القرآني لتلك الأقوال. والثالث: البعد عن التكلف عند احتمال المعنى.
أنواع اختلاف التنوع:
ينقسم اختلاف التنوع إلى أربعة أنواع:
النوع الأول:
اتحاد المسمى واختلاف العبارة الدالة عليه، ويسمى تنوع أسماء وصفات.
فقد تختلف أقوال المفسرين في المسمى الواحد لاختلاف أوصافه ونعوته وتعددها، فمن ذلك المراد من "الصراط المستقيم" أنه "القرآن والإسلام والهدى والرسول وصاحباه وغيرها". فهذه الأقوال متفقة؛ لأن دين الإسلام هو الهدى وهو اتباع القرآن، والرسول صلى الله عليه وسلم، وأصحابه أي هم الذين نقلوا له وبيّنوا معانيه. فجميع المفسرين أشاروا إلى ذات واحدة في بيان الصراط، لكن وصّفه كل منهم بصفة مغايرة للآخر. ومثل هذا أيضاً في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أي محمد أحمد الماحي الحاشر العاقب وغيرها (28). وفي أسماء القيامة أي يوم الحشر، يوم الجزاء، يوم الحساب، الآخرة، يوم الدين، ونحوها. فتشترك في الدلالة على الذات وتختلف في الدلالة على الصفات.
النوع الثاني:
تعدد الأقوال بذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل، ويسمى تنوعاً على سبيل المثال.
كما يقول ابن تيمية: "فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطلق، والعقل السليم يتفطن للنوع، كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف، فقيل له: هذا هو الخبز" ومن هذا النوع قولهم: هذه الآية نزلت في فلان، أو في قصة فلان، أو في موقعة كذا وكذا، أو في وقت كذا وكذا، فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان. فالآية ذات السبب إن كانت أمراً أو نهياً أو نحوهما فإنها متناولة لذلك الأمر والنهي لنفس السبب ولغيره مما كان بمنزلته، ومثل ذلك إن كانت خبراً بمدح أو ذم. والأصل في الآيات التي هي ذوات الأسباب "العبرة بعموم لفظها لا بخصوص سببها"، وهذا ما أجمع عليه العلماء. كما لو نزلت الآية في حكم خاص لا يكون الحكم مختصاً به فقط، بل يتعدى إلى كل ما يقع في حكمه مما يطابقه(29).
ومن تعدد أقوال المفسرين علي سبيل التمثيل ما ورد في قول الله تعالى: ﴿ثُمَّ أَوۡرَثۡنَا ٱلۡكِتَٰبَ ٱلَّذِينَ ٱصۡطَفَيۡنَا مِنۡ عِبَادِنَاۖ فَمِنۡهُمۡ ظَالِم لِّنَفۡسِهِ...﴾(30) فاختلفت الأقوال في هذه الآية في بيان الظالم لنفسه، والمقتصد، والسابق بالخيرات فقيل: الظالم لنفسه هو صاحب الكبائر، والمقتصد المؤمن العاصي، والسابق التقيّ على الإطلاق. وقيل: الظالم لنفسه أصحاب المشأمة، والمقتصد أصحاب الميمنة، والسابق بالخيرات السابقون من الناس كلهم. وقيل: الظالم الذي ترجح سيئاته على حسناته، والمقتصد الذي استوت حسناته وسيئاته، والسابق من رجحت حسناته على سيئاته. وقيل: الظالم لنفسه أصحاب الكبائر من أهل التوحيد، والمقتصد الذي لم يصب كبيرة، والسابق الذي سبق إلى الأعمال الصالحة. وقيل: الظالم لنفسه الذاكر لله بلسانه فقط، والمقتصد الذاكر بقلبه، والسابق الذي لا ينساه. وقيل: الظالم الذي يعبد الله خوفاً من النار، والمقتصد الذي يعبده طمعاً في الجنة، والسابق الذي يعبده لا لسبب (31).
وهكذا تكاثرت الأقوال في مثل هذا وغيره، وكل من المفسرين ذكر نوعاً من أنواع الطاعات على سبيل المثال والشرح لما سبق بيانه من الألفاظ، وفي نهاية المطاف يُلاحظ أن المعاني واحدة وتدل على أمر واحد. ولا يفهم من اختلاف العبارات اختلاف المرادات كما قيل: "عباراتنا شتى وحسنك واحد".
فذكر الإمام الزركشي: "وكثيرا ما يذكر المفسرون شيئاً في الآية على جهة التمثيل لما دخل في الآية فيظن بعض الناس أنه قصر الآية على ذلك" (32).
النوع الثالث:
احتمال اللفظ أحد الأمرين كالاشتراك اللغوي (33) أو التواطؤ(34) فيراد به أحد الشيئين أو أحد الأمرين بشرط أن لا يكون بينهما تضاد. فالاشتراك اللغوي كلفظ ﴿قَسۡوَرَةِ﴾ يراد به الرماة، ويراد به الأسد (35). وكذا في قول الله تعالى: ﴿أَلَمۡ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسۡجُدُۤ لَهُۥۤ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِي ٱلۡأَرۡضِ وَٱلشَّمۡسُ وَٱلۡقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ وَٱلۡجِبَالُ﴾(36) فإنه "يجوز أن يكون النجم ههنا يعني به ما نبت على وجه الأرض وما طلع من نجوم السماء، يقال لكل ما طلع: قَدْ نَجَمَ"(37)، قال ابن عاشور: "وجعل لفظ النجم واسطة الانتقال لصلاحيته ؛ لأنه يراد منه نجوم السماء وما يسمى نجماً من نبات الأرض"(38). فوقع الخلاف في دلالة لفظ النجم بالاشتراك اللغوي، والآية تقبلهما معاً كما دل عليه قول ابن عاشور.
فإذا اتفق اللفظ في صحة إطلاق اللغة له وصحة حمل سياق الآية له، كان من باب اختلاف التنوع.
أما التواطؤ في القرآن الكريم فهو الضمائر المحتمل عودها إلى شيئين فأكثر، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡإِنسَٰنُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدۡحا فَمُلَٰقِيهِ﴾(39) فيحتمل عودة الضمير في "فملاقيه" إلى الرب أو إلى الكدح (40). وبالنظر في المعنى بعد عودة الضمير إلى كلا الأمرين نرى أنه يستقيم معهما دون تعارض أو تناقض؛ فبعودته إلى الكدح يكون المعنى: ثم إنك ستلقى ما عملتَ من خير أو شر. وبعودته إلى الرب يكون: فملاق ربك، فيجازيك بعملك ويكافئك على سعيك (41).
ومن أمثلة المتواطئ أيضاً اختلاف المفسرين في المراد بالفجر والليالي العشر والشفع والوتر في سورة الفجر، فقيل: المراد بالفجر فجر ذي الحجة، وقيل: فجر أول يوم من المحرم، لأنه فجر السنة، وقيل: المراد فجر العيون من الصخور وغيرها، وقيل: فجر يوم الجمعة (42). واختُلف في الليالي العشر فقيل: هي العشرة الأولى من رمضان، وقيل: هي العشرة الأخيرة من رمضان، وقيل: هي العشرة الأولى من المحرم، وفيه يوم عاشوراء، وقيل: هي عشرة من ذي الحجة، وقيل: غيرها. واختلف في الشَّفْعِ وَالْوَتْرِ فقيل: الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة(43). وقيل: الشفع يوم عرفة ويوم الأضحى، والوتر ليلة النحر، وروي كذلك: هي الصلوات منها الشفع ومنها الوتر (44) وقيل: الشفع اليومان من أيام التشريق، والوتر اليوم الثالث. وقيل: غير ذلك(45).
فأطلق سبحانه الفجر والليالي العشر والشفع والوتر؛ أي دون تحديد، فلو قيل في الفجر: أنه فجر الصبح، أو فجر يوم الجمعة أو فجر أي يوم آخر فلا منافاة؛ إذ إن القسم واقع في الفجر، وقد يُعنى به أي فجر بالتواطؤ؛ أي باشتراك لفظ الفجر على أفراده، واستواء المفهوم فيهم. وهكذا في الليالي العشر والشفع والوتر.
النوع الرابع:
تنوع تعبير عن المعاني بألفاظ متقاربة(46) لا مترادفة(47).
غالباً ما تتفق مرادات المفسرين في إيرادهم المعنى للآية أو اللفظة القرآنية، ويختلف التعبير، فكل يفسر بألفاظه، وبهذا تتقارب الألفاظ ولا تترادف؛ لأنه "قَلَّ إن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن"(48) وذلك "إذ الكلمة القرآنية منتقاة بدقة متناهية وموضوعة في سبك رائع قوي يظهر معه استواء كل كلمة في محلها اللائق بها. بما لا يجعل أي كلمة أخرى من الألفاظ المقاربة لها في المعنى تقوم مقامها، وتؤدي كامل معناها بصُوَرِه وظلاله، وروعته وجماله"(49).
فكل لفظ له دلالاته ومعانيه التي لا يماثلها فيه اللفظ الآخر(50)، وينشأ الخلاف من أصل دلالة اللفظ ومعانيه التي يؤديها والتي تختلف مع اللفظ الآخر المعبَر به في نفس المقام (51)، وتلك صورة لاختلاف التنوع.
ومن أمثلته ما ورد في قول الله تعالى: ﴿يَوۡمَ تَمُورُ ٱلسَّمَآءُ مَوۡرا ﴾(52) في معنى المور حيث قيل: تمور: تدور وتكفأ، وقيل: تدور دوراً، وقيل: تتحرك، وقيل: تموج، وقيل: تستدير، وقيل: تتشقق(53). وقيل: تذهب من أماكنها وتزول(54). وفي اللغة: مَارَ يَمُورُ مَوْراً: تَرَدَّدَ في عَرْضٍ، والمَوْرُ: المَوْجُ، والاضْطرابُ، والجَرَيانُ على وَجْهِ الأرضِ، والتَّحَرُّكُ(55).
فمما سبق من التفسير في لفظ المور يتضح أن كل مفسر أتى بما يراه من اللفظ المناسب للتفسير، وإذا تمعنا النظر في المعاني نجد أنها متقاربة، كلها تؤدي معنى الحركة والانتقال من مكان آخر بأي وجه كان.
النوع الخامس:
ثم إن البعض أضاف نوعاً خامساً ألا وهو: الاختلاف في القراءات.
فإن الناظر في كتب التفسير يرى الكم الهائل من اختلاف المفسرين بسبب اختلاف القراءات الصحيحة، بل إن كثيراً من الأحكام مختلف فيها بين الأئمة بسبب اعتبار قراءة دون قراءة، ونحو ذلك. والمقصود بالقراءات هنا ما كان الاختلاف المؤدي منها إلى اختلاف التنوع والتي تبقى في تلك الدائرة، أما ما لا يمكن حمله على معنى واحد فهو المردود المتعارض.
ومن أمثلة الاختلاف في القراءات ما يلي في قول الله تعالى: ﴿حَتَّىٰٓ إِذَا ٱسۡتَيَۡٔسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوٓاْ أَنَّهُمۡ قَدۡ كُذِبُواْ جَآءَهُمۡ نَصۡرُنَا...﴾(56) قرئ كذبوا بالتشديد كُذِّبوا والتخفيف كذَبوا؛ فالتشديد يعني: وتيقن الرسل أن قومهم قد كذّبوهم، والتخفيف يعني: وتوهم المرسل إليهم أن الرسل قد كذَبوهم -أي كذبوا عليهم- فيما أخبروهم به(57). فلا تعارض بين المعنيين.
ومن أمثلة هذا الاختلاف كذلك مما يؤدي إلى اختلاف الأحكام والتوسع فيها ما جاء في قراءة "وأرجلكم" -بالنصب والجر- في قول الله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ...وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ...﴾(58) ففي قراءة النصب بيان لحكم غسل الرجل حيث يكون العطف على معمول فعل الغسل، وفي قراءة الجر بيان لحكم المسح على الخفين عند وجود ما يقتضيه؛ حيث يكون العطف على معمول فعل المسح(59).
وما دامت القراءتان متواترتين فلا يمكن أن يكون هناك تعارض بينهما؛ لأن كليهما وحي من الله تعالى، وكلام الله عز وجل منزه عن التناقض والتعارض والاضطراب.
اختلاف التضاد:
تعريف اختلاف التضاد:
وهو ما يسمى باختلاف التناقض أيضاً، وهو: "ما يدعو فيه أحد الشيئين إلى خلاف الآخر"(60) وقيل هو: "تعدد الأقوال الواردة في تفسير آية القرآن الكريم، لكن بحيث لا يمكن لذاتها تلاقيها في محل واحد من جهة واحدة؛ لتعارض بعضها مع بعضها الآخر دون إمكانية التوفيق بينها"(61). وقيل: هو القولان المتنافيان؛ بحيث لا يمكن القول بهما معاً، فإذا قيل بأحدهما لزم به عدم القول بالآخر(62).
وبالنظر فيما سبق من التعريفات نجد أن اختلاف التضاد هو تعدد الأقوال ومعارضتها لبعضها البعض ودعوة كل قول إلى خلاف الآخر بحيث يصعب الجمع بينها، بل يستحيل أحياناً.
أنواع اختلاف التضاد:
ينقسم اختلاف التضاد إلى نوعين:
النوع الأول:
التضاد بسبب اشتراك اللفظ بين معنيين متضادين. وهو ما يسمى بالأضداد.
وذلك كما جاء في كلمة "القرء" حيث تدل على الطهر وعلى الحيض، ويترتب عليه اختلاف الحكم في كلتا الحالتين (63). وهذا النوع من الاختلاف سائغ وواقع بين السلف.
ولا يعني وقوع اختلاف التضاد بين المفسرين في كل ما جاء في القرآن الكريم من الألفاظ المتضادة؛ إذ قد يعيّن السياق أحد المعنيين ويردّ الآخر، وهذا ما نراه في قول الله تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَٰقُواْ رَبِّهِمۡ...﴾(64) فالظن قد يأتي بمعنى "الشك"، وقد يأتي بمعنى "اليقين"، ولا يمكن حمل معنى الظن على الشك في هذه الآية؛ لأنه سبحانه يمدح قوماً في لقائه، فلا يمكن أن يمدحهم بالشك، ولذا جاء المعنى: الذين يتيقنون لقاء ربهم(65). ومثله أيضاً في وصف الله تعالى أصحاب اليمين في قوله: ﴿إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَٰقٍ حِسَابِيَه﴾(66) ومثله كذلك في خطاب فرعون موسى عليه السلام: ﴿إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَٰمُوسَىٰ مَسۡحُورا﴾(67)، والظن بمعنى الشك كما في قول الله تعالى: ﴿إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنّا وَمَا نَحۡنُ بِمُسۡتَيۡقِنِينَ﴾(68) (69).
فالتضاد يكون اعتباره فيما وقع فيه التضاد بين المفسرين، ووقوع الخلاف في اللفظة نفسها، أما ما صرّح فيه السياق بالمعنى المراد فلا يكون معه اختلاف تضاد؛ وذلك لأن العارض يزول بثبوت المعنى الواحد، فلا يبقى أدنى شك في وقوع تعدد المعنى، ومن ثم الاختلاف.
النوع الثاني:
وقد يكون التضاد لسبب آخر كاختلاف أقوال المفسرين في معنى آية من القرآن الكريم بحيث يستحيل الجمع بين تلك الأقوال بأي وجه. ومن هذا النوع ما يسمى "الاختلاف المذموم".
ومن ذلك ما جاء في قول الله تعالى: ﴿وُجُوه يَوۡمَئِذ نَّاضِرَةٌ﴾ ﴿إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَة﴾(70) فذهب جماعة من الخلق من الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية إلى استحالة رؤية الله تعالى يوم القيامة، وأولوا الآيات بما يناسب آراءهم ومعتقداتهم، من ذلك ما ذكره الزمخشري في تفسيره للآية: "ومعلوم أنهم ينظرون إلى أشياء لا يحيط بها الحصر ولا تدخل تحت العدد في محشر يجتمع فيه الخلائق كلهم، فإن المؤمنين نظارة ذلك اليوم؛ لأنهم الآمنون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فاختصاصه بنظرهم إليه لو كان منظوراً إليه محال، فوجب حمله على معنى يصح معه الاختصاص، والذي يصح معه أن يكون من قول الناس: أنا إلى فلان ناظر ما يصنع بي، تريد معنى التوقع والرجاء"(71).
نتائج البحث:
من خلال هذا المقال قد وصلنا إلى أهم النتائج التالية:
-
القرآن الكريم كتاب معجز فإنه يتحمل من المعاني في أوجز عبارة وأقصرها ما يسبب اختلاف المفسرين فيه في الآية الواحدة إلى أقوال كثيرة، وذلك لسبب احتمال الآيات القرآنية لمعان متعددة في الآية الواحدة.
-
لفظ "الاختلاف" لفظ مشترك من حيث إنه يدل على "هذا الكلام مختلف" إذا خالف أوله آخره في الفصاحة، أو خالفه في أسلوبه في الجزالة والحسن.
-
المراد من الاختلاف في التفسير هو "عدم اتفاق المفسرين على دلالة الآية أو اللفظ القرآني بحيث تعين مراد الله تعالى منها".
-
وقوع الاختلاف في الفروع سنة من سنن الله الكونية وهي ضرورة ورحمة وسعة وهي طبيعة جبلت عليها النفوس؛ ولها عوامل مختلفة من طبيعة الدين، وطبيعة اللغة، وطبيعة البشر، وطبيعة الكون والحياة.
-
الاختلاف في التفسير حقيقة واقعة لا مجال لغض الطرف عنها، وقد يترتب عليه من المفاسد والشبهات ما يوجب تحرير القول فيه وضبط أسبابه من أجل تفنيد هذه الشبهات ووقاية المسلمين منها.
-
إن من الاختلاف في التفسير ما هو اختلاف بحسب الظاهر وليس بحقيقي، بل هو من باب اختلاف التنوع الذي لا تعارض فيه، وهذا لا ضرر من وقوعه، بل ربما كان وقوعه مطلوباً من جهة كمال عرض المعاني وتفصيلها وتقريبها للمستمع.
-
قد تتداخل أسباب الاختلاف بعضها فيما بعض بمعنى أن يعتمد كل مفسر على سبب معين يختلف عن صاحبه مما يؤدي إلى اختلاف في الأقوال، وذلك كأن يعتمد أحدهم على حديث والآخر على سياق الآية ومضمونها وآخر على سبب النزول وهكذا مما يؤدي إلى اختلاف.
-
هناك تتداخل بين المصطلحات التالية من حيث اختلاف المفسرين: العام والخاص، والمطلق والمقيد، والمجمل والمبين، فإننا نجد اختلاف للمفسرين في بعض الآيات القرآنية باعتبار أنها من العموم والخصوص، بينما هي عند الآخرين من قبيل الإطلاق والتقييد، وعند غيرهم من المجمل والمبين.
الهوامش والمصادر:
أستاذ محاضر، قسم الدراسات الإسلامية، الجامعة الوطنية للغات الحديثة (NUML)، إسلام آباد.
أستاذ محاضر، قسم اللغة العربية، الجامعة العلامة إقبال المفتوحة، إسلام آباد
1) انظر: لسان العرب، لأبي الفضل جمال الدين ابن منظور الإفريقي، مادة: خلف، 9/90و 91، ط3: 1414هـ، دار صادر: بيروت-لبنان. وانظر: الكليات، لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي، بتحقيق: عدنان درويش وغيره، ص: 60، ط: 1419هـ، مؤسسة الرسالة: بيروت-لبنان.
2) انظر: التعريفات، للشريف علي بن محمد الجرجاني، ص: 101، ط2: 1335هـ، دار الكتب العلمية: بيروت، لبنان.
3) أدب الاختلاف، لطه حابر فياض العلواني، ص: 160، ط1: 1987م، المعهد العالمي للفكر الإسلامي: فيرجينيا الولايات المتحدة الأمريكية.
4) جامع بيان العلم وفضله، ليوسف بن عبد البر النمري، 2/ 80، ط: 1398هـ، دار الكتب العلمية: بيروت- لبنان.
5) سورة آل عمران: 7.
6) أنوار التنزيل وأسرار التأويل، لناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي، تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، 2/6، ط1: 1418هـ، دار إحياء التراث العربي: بيروت- لبنان.
7) الحديث: أخرجه البخاري في "صحيحه"، في كتاب فضائل القرآن، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف، حديث رقم: 4992، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مطولاً.
8) سورة المائدة: 6.
9) انظر: فتح القدير، لمحمد بن علي الشوكاني، 2/21، ط1: 1414هـ، دار ابن كثير، دمشق-سوريا.
10) سورة هود: 118 و 119.
11) أدب الاختلاف في الإسلام، لطه جابر فياض العلواني، ص: 24، بتصرف يسير.
12) وردت هذه القصة مفصلة في صحيح مسلم. والحديث: أخرجه مسلم في "صحيحه"، في كتاب الجهاد والسير، باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم، حديث رقم: 4687، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
13) فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس قصة أسرى بدر أنه قال: "إِنَّ اللهَ لَيُلِينُ قُلُوبَ رِجَالٍ فِيهِ، حَتَّى تَكُونَ أَلْيَنَ مِنَ اللَّبَنِ، وَإِنَّ اللهَ لَيَشُدُّ قُلُوبَ رِجَالٍ فِيهِ، حَتَّى تَكُونَ أَشَدَّ مِنَ الْحِجَارَةِ ، وَإِنَّ مَثَلَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ كَمَثَلِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: ﴿فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُۥمِنِّيۖ وَمَنۡ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ﴾[إبراهيم: 36]، وَمَثَلَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ كَمَثَلِ عِيسَى قَالَ: ﴿إِن تُعَذِّبۡهُمۡ فَإِنَّهُمۡ عِبَادُكَۖ وَإِن تَغۡفِرۡ لَهُمۡ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ﴾[المائدة: 118]، وَإِنَّ مَثَلَكَ يَا عُمَرُ كَمَثَلِ نُوحٍ قَالَ: ﴿رَّبِّ لَاتَذَرۡ عَلَى ٱلۡأَرۡضِ مِنَ ٱلۡكَٰفِرِينَ دَيَّارًا﴾[نوح: 26...الخ". والحديث: أخرجه بلفظه أحمد في "مسنده"، في مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حديث رقم: 3632. بتعليق المحقق: إسناده ضعيف لانقطاعه، أبو عبيدة - وهو ابن عبد الله بن مسعود -، لم يسمع من أبيه، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.
14) سورة فاطر: 27 و 28.
15) سورة الملك: 3.
16) سورة آل عمران: 190.
17) مناهل العرفان، لعبد العظيم الزرقاني، 2/12، ط: (بدون)، مؤسسة الرسالة.
18) انظر: المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، 2/ 283، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، ط1: 1411هـ، دار الكتب العلمية: بيروت، لبنان. وانظر: النكت على كتاب ابن الصلاح، لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: ربيع بن هادي عمير المدخلي، 1/ 86، ط1: 1404هـ - 1984م، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية: المدينة المنورة- المملكة العربية السعودية.
19) انظر مثلاً البرهان في علوم القرآن للزركشي، 2/156 وما بعدها. والإتقان في علوم القرآن، لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، 4/ 20 وما بعدها، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط2: 1394ه، الهيئة المصرية العامة للكتاب. ومناهل العرفان لعبد العظيم الزرقاني، 2/ 49 وما بعدها. وانظر كذلك: فصول في أصول التفسير، لمساعد بن سليمان الطيار، ص: 49، تقديم: محمد بن صالح الفوزان، ط3: 1420هـ، دار ابن الجوزي: الدمام-المملكة العربية السعودية. وغيرها من الكتب.
20) سورة الأنبياء: 87.
21) سورة الطلاق: 7
22) انظر: تفسير جامع البيان في تأويل القرآن، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، 18/ 514- 516، تحقيق: أحمد محمد شاكر، ط1: 1420هـ، مؤسسة الرسالة: بيروت، لبنان.
23) انظر: فتح القدير، للشوكاني، 3/497.
24) فصول في أصول التفسير، لمساعد بن سليمان الطيار، ص: 57.
25) أسباب اختلاف المفسرين، لمحمد بن عبد الرحمن بن صالح الشايع، ص: 16، ط رقم: 1416هـ، مكتبة العبيكان.
26) ذكرهما أحمد سعد الخطيب في كتابه "مفاتيح التفسير (معجم شامل لما يهم المفسر من أصول التفسير وقواعده ومصطلحاته ومهماته)". انظر: مفاتيح التفسير، لأحمد سعد الخطيب، 1/71، ط1: 1431هـ، دار التدمرية: الرياض- المملكة العربية السعودية.
27) المصدر السابق، 1/71.
28) ففي صحيح البخاري عن مطعم بن عدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لِي خَمْسَةُ أَسْمَاءٍ: أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَحْمَدُ، وَأَنَا المَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِي الكُفْرَ، وَأَنَا الحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي، وَأَنَا العَاقِبُ". الحديث: أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب المناقب، باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث رقم: 3532، عنه بلفظه. 4/ 185. وأخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الفضائل، باب في أسمائه صلى الله عليه وسلم، حديث رقم: 6251، عنه بنحوه. 7/ 89.
29) مقدمة في أصول التفسير، لتقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، ص: 15 وبتصرف، ط: 1490هـ، دار مكتبة الحياة: بيروت-لبنان.
30) سورة فاطر: 32.
31) انظر: فتح القدير، للشوكاني، 4/ 401.
32) البرهان في علوم القرآن، للزركشي، 2/ 159و 160.
33) المشترك اللفظي هو: اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين فأكثر دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة. انظر: تاج العروس من جواهر القاموس، لأبي الفيض محمد بن محمد الحسيني الملقب بمرتضى الزبيدي، 1/25، تحقيق: مجموعة من المحققين، ط: (بدون)، دار الهداية. وقيل هو: كل لفظ يشترك فيه معان أو أسام لا على سبيل الانتظام، بل على احتمال أن يكون كل واحد هو المراد به على الانفراد، وإذا تعين الواحد مراداً به انتفى الآخر، مثل اسم العين فإنه للناظر، ولعين الماء، وللشمس، وللميزان، وللنقد من المال، وللشيء المعين لا على أن جميع ذلك مراد بمطلق اللفظ، ولكن على احتمال كون كل واحد مراداً بانفراده عند الاطلاق. انظر: أصول السرخسي، لأبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، 1/ 126، ط1: 1414هـ، دار الكتاب العلمية: بيروت-لبنان.
34) المتواطئ هو: الكلي الذي يكون حصول معناه وصدقه على أفراده الذهنية والخارجية على السوية، كالإنسان، والشمس؛ فإن الإنسان له أفراد في الخارج، وصدقه عليها بالسوية. والشمس لها أفراد في الذهن، وصدقها عليها أيضًا بالسوية. انظر: التعريفات، للجرجاني، ص: 199.
35) انظر: جامع البيان، للطبري، 24/ 40.
36) سورة الحج: 18.
37) معاني القرآن وإعرابه، لأبي إسحاق، إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج، تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي، 5/96، ط1: 1408هـ، عالم الكتب: بيروت- لبنان.
38) التحرير والتنوير، لمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي، 27/ 235، ط1: 1420هـ، مؤسسة التاريخ العربي: بيروت-لبنان.
39) سورة الانشقاق: 4.
40) انظر: معاني القرآن وإعرابه، لأبي إسحاق الزجاج، 5/ 304. والكدح: يقال: كَدَحَ في العَمَلِ، سَعى وعَمِلَ لِنَفْسِهِ خيراً أو شَرّاً. وانظر: القاموس المحيط، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، مادة: كدح، ص: 237، ط8: 1426هـ، مؤسسة الرسالة: بيروت-لبنان.
41) انظر: تفسير القرآن العظيم، لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، 8/ 356، ط2: 1420هـ، دار طيبة للنشر والتوزيع.
42) انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي، 5/ 476، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، ط1: 1422هـ، دار الكتب العلمية: بيروت-لبنان.
43) لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "عَشْرُ الْأُضْحِيَّةِ وَالْوِتْرُ يَوْمُ عَرَفَةَ وَالشَّفْعُ يَوْمُ النَّحْرِ" الحديث: أخرجه الحاكم في مستدركه، في كتاب الأضاحي، حديث رقم: 7517، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه بلفظه. قال الحاكم: على شرط مسلم ولم يخرجاه. انظر: المستدرك على الصحيحين، للحاكم النيسابوري، 4/ 245.
44) لما ورد عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الشفع والوتر، فقال: "هِيَ الصَّلَاةُ مِنْهَا شَفْعٌ وَمِنْهَا وَتْرٌ". الحديث: أخرجه الحاكم في مستدركه، في كتاب التفسير، باب تفسير سورة والفجر، حديث رقم: 3928، عن عمران بن حصين رضي الله عنه بلفظه. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. انظر: المستدرك، للحاكم النيسابوري، 2/ 568.
45) انظر: تفسير الطبري، 24/ 396- 398. وانظر: المحرر الوجيز، لابن عطية، 5/ 477.
46) التقارب: هو ضد التباعد، ويعمي الدنو. انظر: لسان العرب، لابن منظور، مادة: قرب، 1/663.
47) الترادف: هو عبارة عن الاتحاد في المفهوم، وقيل: هو توالي الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد. ويطلق على معنيين أحدهما الاتحاد في الصدق، والثاني الاتحاد في المفهوم، ومن نظر إلى الأول فرق بينهما، ومن نظر إلى الثاني لم يفرق بينهما. انظر: التعريفات، للجرجاني، ص: 56.
48) مقدمة في أًصول التفسير، لابن تيمية، ص:17.
49) الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن الكريم، لمحمد بن عبد الرحمن بن صالح الشايع، ص:173، ط1: 1414هـ، مكتبة العبيكان: الرياض- المملكة العربية السعودية.
50) وقد أنكر الراغب الأصفهاني وابن عطية وابن تيمية الترادف في اللغة على العموم وفي القرآن الكريم بالخصوص.
51) إذ إن كلُّ حرْفين أوقَعَتْهُما العربُ على معنى واحد في كلّ واحد منهما معنًى ليس في صاحبه. انظر: المزهر في علوم اللغة وأنواعها، لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، بتحقيق: فؤاد علي منصور، 1/ 314، ط1: 1418هـ، دار الكتب العلمية: بيروت - لبنان.
52) سورة الطور: 9.
53) تفسير الطبري، 22/ 461- 463.
54) تفسير ابن كثير، 5/ 164.
55) القاموس المحيط، للفيروز آبادي، مادة: مور، ص: 477.بتصرف
56) سورة يوسف: 110.
57) انظر: تفسير الرازي، 18/180.
58) سورة المائدة: 6.
59) انظر: تفسير الرازي، 11/129.
60) الاتقان في علوم القرآن، للسيوطي، 3/100.
61) مفاتيح التفسير، لأحمد سعد الخطيب، 1/ 67.
62) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم، لابن تيمية، 1/151. وانظر: فصول في أصول التفسير، لمساعد الطيار، 57.
63) ذكر الإمام الرازي في تفسيره: " القروء جمع قرء وقرء، ولا خلاف أن اسم القرء يقع على الحيض والطهر. قال أبو عبيدة: الأقراء من الأضداد في كلام العرب، والمشهور أنه حقيقة فيهما، كالشفق اسم للحمرة والبياض جميعاً. وقال آخرون: إنه حقيقة في الحيض مجاز في الطهر. ومنهم من عكس الأمر..." انظر: مفاتيح الغيب، للإمام الرازي، 6/ 75.
64) سورة البقرة: 46.
65) انظر: كتاب الأضداد، لأبي بكر محمد بن القاسم بن الأنباري النحوي، ص: 2، ط: 1881م، مطبع بريل: ليدن.
66) سورة الحاقة: 20.
67) سورة الإسراء: 101.
68) سورة الجاثية: 32.
69) انظر: ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد، لأبي العباس محمد بن يزيد بن المبرد النحوي، بتحقيق: أحمد محمد سليمان أبو رعد، ص: 53و 54، ط1: 1409هـ، مطبعة الموسوعة الفقهية: الكويت.
70) سورة القيامة: 22 و23.
71) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري، 4/ 662، ط: 1407هـ، دار الكتاب العربي: بيروت- لبنان.
85
-
| Article Title | Authors | Vol Info | Year |
| Article Title | Authors | Vol Info | Year |